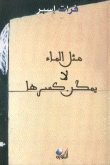في كلّ مرة يُصدرُ عملا أدبيًا، في مجال القصة أو الرواية، يُعيدنا الأديب الفلسطينيّ يسري الغول إلى حرارة القصّ والاشتغال على أسئلة الوجود الفلسطينيّ من خلال الانتقال إلى باطن الذات في حركة عكسيّة مضادّة ومراوغة للسّرد الفلسطينيّ التقليديّ. في كلّ عملٍ جديد، يرتقي يسري الغول في فكرة الكولاج السّرديّ ومعه بناء وعيٍ مركّب وحساس في قلب المكان المهزوم. طاقاتٌ متراكبة ومتراتبة ومتفجّرة في كلّ نصّ يقدّمه للقراء، تتنوّع بين السّحري والواقعيّ والديستوبيّ واليوتوبيّ والهيتروتوبيّ والتراجيكوميديّ والأبوكاليبسيّ والبيكاريسكيّ والبنتاريسكيّ. كلّها طاقاتٌ تسعى بخفّة تارة وبثقلٍ تارة أخرى، نحو الكشف والتعرية والفضح والإعمار والتخريب ليهزّ معمار العالم الفلسطينيّ اليوميّ ويشيع القلق في مسلّمات صار من البديهيّ انتهاكها لنعيدَ صياغة تعريف علاقتنا بالمكان.
غزّة، المكان المستحيل، تتحوّل إلى عالمٍ منسوج من خيوط كابوسيّة يخرج منها أبطال مهمّشون، ومحبطون وموتى يستنطقهم الروائي يسري الغول، ويعيد رسم علاقتهم بالأمكنة الصغيرة وتعميق الازمة أكثر داخل المكان الكبير المستحيل، وبهذا يكون قد بنى عوالم كثيرة مبتكرة بأساليب فنيّة تبحثُ عن هويّتها داخل فنّ القصّة الفلسطينيّة الجديدة التي يترك فيها الغول بصمة واضحة آن أوان دراستها بعمق.
هنا حوار معه:
-يسري الغول من مواليد العام 1980. وتواجدك في المكان الفلسطيني القاسي والأكثر إيلاما، غزة، كان له أكبر الأثر في تشكيل وعيك الأدبي، مراحل تبدو واضحة في تدرج عناوين أعمالك الأدبية وتنوع مواضيعها وأساليبها في حالة من القلق الواعي داخل المكان المحاصر والمحاصر، والسعي نحو فضح المسلمات وصولا إلى انتصار الذات على هذا المكان. فأي مراحل عشتها في قلب المكان إلى أن وصلت إلى “جون كينيدي يهذي أحيانا”؟
في مدينة تضيق على ساكنيها، وفي بيت لا يتجاوز 45 متر مربع ولدت، جئت إلى الدنيا بينما كانت أمي تغسل ملابس الأب الذي انطلق بها إلى عيادة وكالة الغوث على أطراف مخيم الشاطئ بغزة، ولأنني جبلت من طين المخيم، المكان الذي لا يمكن اعتباره أسطورة بالنسبة لي أو حتى جنة كما يظن البعض، إنما قطعة من جحيم لا لون فيها غير الأسود، كبرت وترعرعت وصرت شابا يافعا أتمرغ في وحل تناقضاته، فما بين مراحل الحياة الأولى والاندماج مع رفاق المسجد الذي فتح لنا الأبواب لنقرأ القرآن ونتقن العربية، وصولا إلى رفاق الفكر اليساري المختلف أثناء المرحلة الثانوية والجامعية لنقرأ ماركس وإنجلز ولينين وهيجل ونيتشة، ثم العلماني الليبرالي الذي جاء مع بداية سفري إلى أوروبا ثم الولايات المتحدة الأمريكية ومنها إلى مؤتمرات وبرامج حول تحالف الحضارات في أذربيجان وماليزيا وغيرهما، أدركت أن المخيم لم يكن سوى سجن يضيق بأهله، وأن غزة قمقم لا يعرف الواحد معنى الحرية إلا إذا طار بعيدا عنه.
مجموعة أفكار وتناقضات ومواقف، بصحبة أصدقاء مختلفين فكريا وسياسيا، وفي عوالم متباعدة مختلفة تشكلت رؤية يسري الغول الجديدة، التي أظن أنها بدأت مع مجموعة الموتى يبعثون في غزة بخلاف المجوعتين القصصيتين السابقتين: على موتها أغني، وقبل الموت بعد الجنون، الصادرتين عن مركز أوغاريت للنشر والترجمة في رام الله في 2007 و2010.
ولأنني مؤمن بأن التغيير هو الثابت الوحيد في حياة البشرية، كان لا بد من انتهاج مجموعة مدارس وأفكار سعيا نحو صناعة المدرسة الخاصة بي، لذا ستجدين أن يسري الغول يحاول في كل عمل أن يذهب بعيدا عن سابقاته، لغة وأسلوبا وكذلك في طرح الجديد من الأفكار، وصولا إلى جون كينيدي الذي قررت فيه إعادة تغيير المشاهد التي حفظتها البشرية أثناء اغتيال شخصيات مثل كينيدي ونيرودا وإلينيدي وجيفارا ورابين وأبو عمار وأحمد ياسين وغيرهم، ذلك لأن الحقيقة وصلت -بالتأكيد – منقوصة أو غير واضحة، حسبما يريد للسيناريست أو صانع الحدث لها أن تصل؛ فأنا مؤمن أن التاريخ محض كذبة كبيرة، يكتبها جلاوزة الحكام والأقوياء، فكان لدي رغبة بإعادة صناعة التاريخ بشكل فنتازي مختلف في مقهى داخل الجنة، بجوار نهر الكوثر وشجرة التفاح التي التهمها آدم برفقة حواء.
-يسري الغول لاجئ من مخيم الشاطئ. وللجوء في المخيلة الجمعية الفلسطينية الراهنة معنى أكثر عمقا من أي وقت مضى في عشرية الثورات العربية. معنى يتخذ سردية خاصة بالفلسطيني لكنه يتماهى مع سردية اللجوء العربي. ما بين اللجوء الفردي، واللجوء الجمعي، هل ينجح الأدب العربي، والفلسطيني بشكل خاص، في خلق وتشكيل أساليب تعبير جديدة تواجه هذا الواقع الجديد؟
لم يعد يقتصر اللجوء على الفلسطيني، ولم يعد مكان اللجوء أو حتى النزوح مقتصرًا على البلدان العربية أو الإنسان العربي، فهناك الإفريقي الذي يهرب من جحيم الفقر والموت إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أو إلى دولة الاحتلال الاسرائيلي، كما بات يهرب السوري إلى أماكن أكثر رأفة، وكذلك العراقي والليبي والفلسطيني وغيرهم، لذا فإن ثيمة اللجوء والهروب من الوطن لم تعد خاصة بالفلسطيني المتخم بويلات الحروب، بل بكل شرقي أو إفريقي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأمكنة أخرى غارقة في الوحشة.
ويمكن للمتابع للأدب العربي الحديث أن يكتشف كيف تأثرت الأمة بجحيم الأنظمة الشمولية ووعاظ السلاطين والجلاوزة الذين قمعوا الرأي والفكر المختلف، حتى جاءت الثورات التي لم تكن منظمة ولم يكن المجتمع العربي بعمومه مؤهلا لممارسة الديموقراطية كما يجب، لذا فإنها فشلت فشلا ذريعا فنجحت الثورات المضادة وعادت الأنظمة السابقة أكثر قمعا وإقصاء، دفع المواطن ثمن تلك الطموحات التي تبنتها المعارضة لأجل مصالحها الخاصة بينما كان المواطن العادي يسعى من خلالها تحسين شروط العبودية في الوطن العربي الكبير.
الهجرة باتت سبيلا للخلاص، حتى لو قضى الشخص وأبناؤه في البحر، بدلا من انتظار الموت عبر قذيفة من الاحتلال الاسرائيلي أو رصاصة طائشة بالنسبة للفلسطيني، أو من طائرة روسية تقع على رأسه وعائلته بالنسبة للمواطن السوري، أو طائرة أمريكية بالنسبة للعراقي أو الحرب الأهلية السودانية أو اللبنانية ووو.
لدينا اليوم كتّاب المهجر من العرب مثل سنان أنطون ومحسن الرملي وحسن بلاسم ومازن معروف وأسماء أخرى كبيرة، كما أن لدينا مثل خالد حسيني الأفغاني، وأسماء بمداد البحر عملت على تغيير نمط وأسلوب وعوالم الرواية والقصة العربية والعالمية نتيجة الاندماج مع مجتمعات ذات فكر وأسلوب مختلف، فالهجرة عملت بالفعل على خلق وتشكيل أساليب تعبير جديدة تواجه هذا الواقع المرير، ركزت على الحدث والحبكة أكثر من تركيزها على اللغة التي كانت عقدة العربي المتخم بعلم البلاغة والبيان.
وكنت قد أصدرت قبل عامين رواية مشانق العتمة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، وتدور أحداث الرواية عن شخوص من أماكن مختلفة تهاجر على متن قارب مطاطي ثم تموت في عرض بحر إيجة، ليس بفعل الطبيعة كما ذهب كثيرون لختام أعمالهم الروائية من قبل، وإنما بسبب وجود شخصية مثل هتلر القاتل، المحقق السوري الهارب من صراع الأجهزة الاستخباراتية هناك، فقد أصبح ديلر لتهجير الهاربين من الموت إلى اليونان من خلال تركيا، حيث يطلق النار على ذلك القارب المطاطي لأنه لم يقدر على إقامة علاقة جسدية كاملة مع هاجر الفلسطينية التي تشبه زوجته الغائبة.
-تكتب الأدب في ظل الاحتلال والدمار، وهذا واضح تقريبا في معظم نصوصك، الآخر حاضر بقوة في شكله المألوف، المغيب، المتوحش والمجازي. لكن عينك على الذات والحفر في أنفاقها. في تأسيس او إعادة تأسيس العلاقة بين الذات والأخر تحدث انشطارات داخل الذات الذاتية والذات الآخرية. بين تفوق وتَدنّ لكلتا الذاتين، أي سلطة حقيقية يلعب الأدب في غزة تحديدا في إعادة النظر في هتين الذاتين، وما هي حدود ومعيقات هذه النظرة؟
شكرا على هذا السؤال الذي يفتح آفاقا واسعة لإيصال صوت الفلسطيني إلى العالم من خلال الحديث عن مدى تأثر أي كائن بالظروف التي يعيش. وهذا ما كنت أكتبه في قصصي من خلال المونولوج، الحوار الذاتي الذي يأتي نتيجة ظروف نفسية قاهرة، فمحاولتي دفع الأبطال للحديث عن أنفسهم واستخدام ضمير المتكلم لرغبة منه في الحفر عميقا في الذات الفلسطينية داخل النص.
ويمكن لك من خلال رواية غزة 87 قراءة ذات الآخر وأحلامه وطموحاته مقابل رؤية ابن المخيم العامل في الداخل المحتل لأجل لقمة العيش، الفارق بين عالمين، مخملي إسرائيلي وآخر متخم في البروليتارية الفلسطينية؛ لتسليط الضوء على القضية بشكلها الواضح وليس كما أراد لها البعض أن تكون؛ إذ إن مشكلة الفلسطيني مع اليهودي الذي جاء إلى فلسطين ليست مشكلة دينية، بل مشكلة احتلال جاء مغتصبا للأرض، ولم يقبل حتى بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي جاءت بعد الهجرة والإعلان عن تأسيس دولة الاحتلال الإسرائيلي. فهل يعتقد أحد أن المحتل لو كان مسلما سيسلم من نضال الشعب المسلم الآخر؟ وهذا ما يجري الآن بين روسيا وأوكرانيا.. مشكلة احتلالات موجودة في أماكن كثيرة من هذه البسيطة.
وبالعودة مجددا لسؤالك المتخم في الفلسفة، فإن الفلسطيني كما الإسرائيلي، ما بين يمين ويسار ووسط، كل تلك الهويات تعيش تناقضات أحيانا، فهناك من يريد كامل تراب فلسطين، وآخر يقول نكتفي بقرار 194 أو القرارات اللاحقة، وآخر يقول نريد أي شيء مقابل العيش بسلام، خصوصا بعد كل الدمار الحاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذه الفرق كما الإسرائيلية التي تعيش تطرفا كبيرا اليوم.
لذا فإن الذات الفلسطينية لم تتحطم رغم حالة التيه والتخبط، بعضها في أوج قوته، وآخر يعيش على التنفس الاصطناعي، لكنه لن يذوي أو يموت. وأظن أن الاحتلال لديه جيل لا يهتم كثيرا بالدولة بقدر ما يهتم بتحقيق رغباته وطموحاته، ثم الجلوس مع حبيبته تحت ظل شجرة في يافا، يرسم قلبا ويكتب أول حرف من اسمها واسمه كذكرى أبدية.
في غزة 87 الذات الفلسطينية المنشطرة نصفين في شخصية عادل الذي يعيش الخوف والتيه اثناء إقامة علاقة جسدية مع سارة الأشكنازية ويسأل نفسه كمونولوج داخل النص: هل خان وطنه أم انتصر له؟ هل وضع رأسه في التراب أم رأس الوطن؟ وكذلك ديفيد الإسرائيلي الذي يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأنه يعيش حالة تمرد داخلي ورفض للمجتمع الإسرائيلي بكل مكوناته من الداخل.
-البطل في السرد الفلسطيني التقليدي هو بطل نموذجي مكرر ويتحرك ضمن صراعات وأطر واضحة ومحددة مسبقا. بطل عضوي منخرط في قضيته الكبرى. أما أبطالك فهم انسلاليون إلى حد التحول، في كل فقرة تقريبا تجدهم كائنات جديدة وكأنهم في حالة رفض للثابت، ورغبة متواصلة في التكيف مع واقع متغير. ما الذي تحفر فيه ويختلف عن مجايليك ومن سبقوك في المشهد الأدبي الفلسطيني من خلال هذه النماذج الانسلالية المتحولة؟
الثابت الوحيد في هذه الحياة هو مبدأ التغيير، فالإنسان قد يغير دينه أو مذهبه كما نسمع من اعتناق مسيحي للإسلام أو بوذي للمسيحية أو سني إلى الشيعية أو أي اتجاه آخر. وهذا شيء يفوق الخيال، فما بالك بقضايا أخرى أكثر ليونة، كأن يحب الطفل شيئا ثم يعزف عنه حين يكبر، ويحب المراهق شيئا ثم يكرهه حين يكبر، والراشد البالغ حين ينضوي تحت لواء فكر أو حزب أو جماعة، فلا مسلمات باختصار في هذه الحياة إلا ما تسعى إليه النفس، ومهما حاولت الأديان أو المذاهب، أو الجماعات والدول، أو الأحزاب والفرق من تدجين الإنسان نحو رؤية بعينها، إلا إنه في لحظة سيتمرد على ذلك الشيء ولو في الخفاء. وهذا ما دفعني لرفض فكرة الفلسطيني البطل، المثالي الخارق الذي لا ند له، فهو بشري الطباع، يخطئ ويصيب ويرتكب الأخطاء، يحب ويكره، يصلي ويكفر، يصوم ويفطر، يضحك ويبكي، خليط من المتناقضات الطبيعية في إنسان مجبول على ذلك.
لذلك يمكن للفلسطيني الفدائي أن يرتكب حماقة وينتصر لذاته في مصلحة شخصية، أو يقتل رفيقا لأجل زوجة أو ينتقم من جار لأنه يرغب بالاستيلاء على بيته، ويمكن له فعل الكثير. لكن هذا لا يعني أن الفلسطيني ملوث بالخطايا وحده، بل كل بشري جاء إلى الدنيا أصابه شيء من أدرانها، بدءا من قابيل وصولا إلى آخر رجل على هذه البسيطة، اللهم إلا من عصمهم الله.
ولكن رغم كل هذا العبث، هل يجب على الفلسطيني أن يتوقف عن النضال؟ وهل يجب على العالم أن يدعم الاحتلال الإسرائيلي الذي يوغل قتلا في الفلسطينيين لأن الفلسطيني غير مؤهل لممارسة الحرية والديموقراطية؟ بالتأكيد لا، لذا كان لا بد من أن أقول إن الفلسطيني العادي جدا يسعى لنيل الحرية شأن أي إنسان في هذا العالم وسينتصر إن امتلك الوعي الحقيقي بأهمية النضال السياسي والدبلوماسي والفكري والثقافي والعلمي أيضا.
ونماذجي لن تكون من نسل الأنبياء، فهم شيطلائكيون، لكنهم في النهاية لديهم رؤاهم ومواقفهم وقضاياهم التي تشغلهم ويبحثون من خلال حروفي وأعمالي الأدبية عن إيصال صوتهم المقموع إلى العالم، سعيا نحو الحرية والاستقلال، ومطالبة الاحرار بالتحرك لإيقاف الدم الذي يسهل على الإسرائيلي إهراقه لأن الفلسطيني رخيص الثمن عند الحكومات والمنظمات العالمية، ولأن العربي منشغل بقضاياه عن قضية فلسطين المركزية.
-بين ديالكتيك حب الآخر وكراهيته، تكتب غزة 87، وقصصا أخرى تتناول الآخر في شكل المحتل. هذا العمل يعرض أمامنا ديالكتيك الجسد الفلسطيني المضحّى به خارج إطار المقاومة المألوف. الجسد الذكوري منزوع الإرادة الزاحف صوب محتله. العنف هذه المرة هو عنف ناعم رقيق والضحية تقدم نفسها قربانا كي تنجو. كيف واجه المجتمع الفلسطيني المحلي هذه الفكرة؟
للأسف، لم يتقبل المجتمع تلك الرواية، لأنها كانت تتحدث عن جانب إنساني بحت، كيف يمكن للإنسان الفلسطيني أن يعيش علاقة جسدية كاملة مع فتاة من تل أبيب، فكلا الشخصيتين في النهاية بشر، من لحم ودم، وكذلك الشخصيات الأخرى، لها من المشاعر ما يمكن أن يعمد إلى إلغاء فكرة دين أو مذهب الآخر أو حتى سبب وجوده، والإبقاء على حالة الرغبة والإعجاب الذي قد يصل في النهاية إلى علاقة جسدية بطريقة أو بأخرى، وكنت من خلال ذلك أسعى لإيصال رسالة للمتلقي الإسرائيلي قبل الفلسطيني، والعالمي قبل العربي: ألا يمكن للفلسطيني أن يندمج مع مواطني دولة الاحتلال؟ وسؤال أكثر أهمية: هل سيقبل الآخر، وأقصد بذلك الاحتلال بهذه العلاقة؟ هل يمكن للزمن أن يغفر خطيئة الدم؟ ألم يحدث وأن تم ممارسة العديد من العلاقات الجسدية بين العمال الفلسطينيين وفتيات إسرائيليات داخل تل أبيب أو يبنا كما كنا نسمع في طفولتنا؟ هل يوجد من جنود دولة الاحتلال من جاء من ظهر رجل عربي فلسطيني؟ والسؤال الأكثر أهمية: هل يمكن اختلاط الأنساب حتى يصبح المجتمع قادرا على قبول الاندماج كحل لدولة ثنائية القومية بدلا من حل الدولتين الذي ترفضه دولة الاحتلال حتى اللحظة.
لقد ذهبت لقراءة العديد من الأعمال الأدبية والسياسية والبرامج لأتعرف على طبيعة المجتمع الإسرائيلي قبل أن أجيب عن أسئلتي التي جاءت من خلال علاقة جنسية كاملة بين سارة الإسرائيلية الأشكنازية وعادل ابن مخيم الشاطئ. قرأت آخر الحصون المنهارة لمشهور البطران ووجع أيوب لمحمد نصار وأعمال أخرى لا أذكرها، ووصلت إلى رسالة مفادها أن لا أحد يستطيع الفكاك من بيئته وأيديولوجيته، رغم أن الاحتلال كان أكثر وطأة وتشددا في هذه القضية، فعمد إلى طمس الفلسطيني وعدم منحه أي مساحة من الحرية أو القرار.
بعض الأدباء والقراء والمهتمين طالبوا بسحب الرواية من السوق، لأنني رسمت العلاقة الجسدية بوضوح وليس كما جرت العادة عند أدباء قطاع غزة من الإشارة لذلك بكلمات مقتضبة بسبب العيب والحرام، فعلت ذلك لأنني مؤمن أن المشهد يجب أن يصل كاملا للقارئ، بكل المشاعر الجياشة المجنونة التي قد تكون جنسية أحيانا، لأنني لا أكتب مقالا أو دراسة نقدية.
الأمر الآخر، نظرًا لعدم وجود نقد حقيقي في فلسطين وعدم دعم للمثقف أو حتى اهتمام بما يكتب، غابت الرواية عن المشهد، إذ ليس من الممكن أن يقوم طالب بعمل دراسة أكاديمية عنها أو باحث بعمل دراسة نقدية أو نصية عن تلك الرواية التي أعتز بها كثيرا.
-فلسطين، في المستوى الأدبي، اليوم، لا تقدم نفسها بالكتابة إلا عبر هذا البناء المتحول الذي يتم إعماره بنقله من مستوى الهوية الواحدة إلى مستوى الهويات المتعددة. غزة، الضفة الغربية، الداخل الفلسطيني، والشتات. أربعة أقطاب تتحول فيها بنية الهوية الفلسطينية من مستوى الهوية الواحدة-الخالصة إلى الهوية المتعددة التي سكنتها هويات برانية وبنت عليها. ما هو الخطر الذي تعيشه هذه الهويات الفلسطينية الفلسطينية وما هي الإنجازات الحقيقية التي سجلها هذا الاختلاف بينها؟
لا أعرف إن كان من الصواب الحديث عن هويات فلسطينية مختلفة، ذلك لأن الإنسان صاحب هويات مختلفة تبعا للتغيرات العمرية والأحداث والمواقف التي تنشأ بفعل الظروف المحلية أو السياسية العالمية أو غيرها.
فإن كان الإنسان يتغير بفعل حوادث كثيرة، ماذا يمكن القول عن مجموعة بشر داخل محيط واحد؟ وماذا عن آخرين في أماكن وبيئات وظروف مختلفة؟ أليس من الممكن أن يذهب كل فريق للحديث عن ظروفه وأحلامه وآماله.
ورغم ذلك، لا يمكن إغفال الانقسام على الواقع الفلسطيني، سواء على الأرض وكذلك على الورق، لأن الفلسطيني يعاني حالة اغتراب عن وطنه الكامل بفعل وجود الاحتلال في مفاصل حساسة، إذ بات لكل منطقة همومها الكبيرة التي تشغلها عن غيرها، فالفلسطيني في مخيمات الشتات وتحديدا لبنان تختلف ظروفه عن ابن مخيم الشاطئ في غزة، وكذلك عن ابن الضفة الغربية أو عن الفلسطيني المغترب في أي قارة غير عربية.
بالنسبة لي كفلسطيني، أعتقد أنه لا يوجد مزايا في تعدد الهويات المناطقية نتيجة الحيد عن القضية الأساس، وهي وجود احتلال كولونيالي يسيطر على كل مقومات الدولة الفلسطينية، بينما بات الفلسطيني يناقش قضايا هامشية وليست ذات أساس، كالانقسام وما نشأ عنه. لذا فإننا بحاجة لعدم نسيان الهوية المركزية للإنسان الفلسطيني الذي يدفع ثمن التهاوي والسقوط الأخلاقي للعالم الظالم أمام أطول احتلال في العصر الحديث.
-في عصر الذكاء الاصطناعي الذي يوازيه صعود وأفول حكومات وديكتاتوريات في الشرق الأوسط عموما، حروب وحصار على الإنسان الفلسطيني والعربي، وانفجار الهويات الصغيرة في أرض الشتات، تكون واقع جديد: شذري. ماذا الذي يهدد الرواية الفلسطينية في رأيك اليوم، في عصر التحولات؟
أكثر ما يهدد الرواية الفلسطينية هو ما سبق ذكره، انشغال الفلسطيني بقضايا حياته اليومية على حساب قضيته الأساس، وهي الدفاع عن حقوقه السليبة، وطرق جدران الخزان من أن الإنسان يدفع ثمن وجود احتلال يمارس التطهير العرقي بشكل غير مسبوق.
والأكثر قهرا، أن الرواية الفلسطينية في ظل وجود حكومات عربية تسعى، بل تستميت للتطبيع مع الاحتلال، تحاول منع انتشار تلك الأعمال الأدبية، وترفض تأهلها للفوز بأي جائزة كنوع من كي الوعي للكاتب الفلسطيني من أن يشغل نفسه بأي شيء بعيدا عن المطالبة بحقوقه. فنحن اليوم لم نعد نقرأ الأدب الجيد فقط، بل نقرأ الأدب المُسوّق جيدا، وهو ما تقوم به الأنظمة والسلطة الرابعة لأجل إلغاء فكرة مركزية القضية الفلسطينية.. لكنني رغم ذلك أقول لك إن أي حدث بين الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلي سيعيد العربي إلى قوميته وعروبته وسيعود للاشتباك بالحروف والكلمات والصوت العالي.
في ثالوث الكاتب والناقد والقارئ في الأدب الفلسطينيّ، يمكن أن نلاحظ عنفًا ما مبطّنا يسكن هذه العلاقة. عنف الرؤية النمطية السابقة للناقد والقارئ حول ما يجب للفلسطيني أن يقدمه وهي رؤية مجحفة لجرأة الكاتب الفلسطيني في فضح الذات وتفكيكها اجتماعيًا ونفسيًا وسلطويًا، وصراعاتها الباطنية مع ذاتها قبل صراعها مع أي آخر خارج ذاتها. وقد يواجه عمل أدبيّ أو كاتب يجرؤ على القيام بهذا الفعل بعملية إقصاء متعددة الجوانب. ما العمل؟
أتمنى لو كان لدينا ناقد حقيقي، فما هو موجود حالة من المجاملات لا يمكن وضعها ضمن فئة النقد، اللهم إلا عددا شحيحا من النقاد. أما بخصوص القارئ، فهو يهتم بالتسويق الجيد، وليس العمل الجيد، مأخوذا بعقدة الغربي والمترجَم، فهو يريد العيش في بيئات جديدة بين طيات الكتب، خصوصا وأنه محروم من السفر والتنقل بحرية بسبب عدم وجود المطارات والموانئ.
بالنسبة للأدباء في الأراضي الفلسطينية، فإنهم يعيشون انقسامات حادة نتيجة اصطفافات قد تنشأ بسبب تعارض المصالح وليس بسبب الهم الجمعي الفلسطيني، حتى داخل الحزب الواحد أو الجماعة الواحدة فإنهم لا يفكرون بالبناء على نقاط الالتقاء، بل يتنازعون في السر والعلن. ربما يصلح في حالتنا الفلسطينية فكرة الشللية الثقافية، إذ إن لكل كاتب جماعته وأصدقاءه الذين يأخذون دور الناقد بالكتابة عن أي عمل جديد كنوع من المجاملة فقط. وأظن أننا بحاجة ماسة لناظم حقيقي لأي عمل أدبي، وذلك يأتي بإعادة الاعتبار لوزارة الثقافة الفلسطينية واتحاد الكتاب من خلال تمويل جاد وكبير يساهم بإعادة بناء دار الكتب الوطنية، وتبني دور النشر التي باتت تبحث عن المال لأجل توفير لقمة العيش للعمال الموجودين لديها، إذ لم يعد يهمها كثيرًا جودة العمل من عدمه.
أختم بأنه من الضروري تبني الرأي والرأي الآخر لدى فئة المثقفين أولا، لتعزيز ذلك لدى جمهور العامة، وتقبل المختلف وتبنيه والدفاع عنه كما قالها فولتير: إنني على استعداد أن أدفع عمري ثمنا ليبوح من يخالفني الرأي برأيه. فهل المثقف الفلسطيني قادر على ذلك؟
المصدر صحيفة صوت العروبة
1 أغسطس، 2023
 Aljarmaq center Aljarmaq center
Aljarmaq center Aljarmaq center