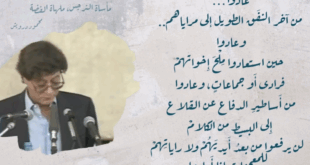ترجمة: محمود الصباغ
القسم الأول: فيلم “نشيد الحجر” للمخرج ميشيل خليفي
ملخص
طوّر طرفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هويات وطروحات وطنية متعارضة، تماماً، تستند على مفهوم الضحية. تطورت هذه الروايات، بدورها، إلى سرديات محاكاة نتيجة لطبيعة تطورها. وتتناول هذه الدراسة سرديات المحاكاة الفلسطينية التي تعزز مفاهيم القيم المجتمعية، لا سيما قيمة الضحية، ذات العامل الحاسم في التعامل مع الصراع الطويل الأمد. ووقفت وسائل الإعلام الغربية، في سياق الصراع، إما لجهة قبول سرديات المحاكاة الفلسطينية ومفهومهم لأنفسهم كضحايا للصراع، أو لجهة رفض هذه الطروحات. وقد أنتج الإعلام، من جرّاء ذلك، لمشاهديه الغربيين، حقائق واقعية مفرطة للصراع، بطريقة تؤثر على قبول الغرب أو رفضه لسردية المحاكاة الفلسطينية. وسوف تستفيد هذه الدراسة من فيلم “نشيد الحجر” لميشيل خليفي، وفيلم “الجنة الآن” لهاني أبو أسعد، ووكل من فيلمي “سجل اختفاء” و “يد إلهية” لإيليا سليمان، لفحص الدرجة التي تؤكد بها الأفلام الفلسطينية أو تتعارض مع المعتقدات المجتمعية التي تسهم في إطالة أمد الصراع والعلاقة بين عرض تلك المعتقدات والواقعية المفرطة والرأي العام في المجتمعات الغربية، بالإضافة إلى البحث في العلاقة بين عرض العنف في الأفلام ووجود العنف في فلسطين.
مقدمة
ساهم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا يزال، في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، رغم جهود المجتمع الدولي. بينما هناك عدداً من العوامل التي جعلت من الصعب حل هذا النزاع بالذات، يبدو أن تطوير هويات وسرديات وطنية متعارضة تماماً من كلا الطرفين، كان أحد العوامل المهيمنة في استدامة الصراع وصعوبة التوصل إلى حلول له. ويتفق الباحثون على أن العديد من الأفلام الوثائقية الفلسطينية المبكرة استُخدمت لخلق رواية مضادة للرواية الصهيونية (Alexander “Palestinians in Film” 321; Gertz and Khleifi “Roadblock” 317). ولكن الأفلام الروائية الحديثة تبتعد عن المعاملة المتجانسة لهوية الوسائل السياسية الفلسطينية وتقديم أطر مرجعية جديدة للوجود الفلسطيني والهوية الثقافية (Gertz and Khleifi “Roadblock” 322). في حين لعب الفيلم الفلسطيني الأبكر، على الأرجح، دوراً في تطوير السردية الوطنية، فقد تطورت المرويات الوطنية الفلسطينية والهوية الوطنية كنتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل السياسية والنفسية، كان، لكل منها، تأثير فردي، من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، الانفصال عن الآخرين. وفي حين أن هناك بعض الأحداث التاريخية التي حدثت بلا شك، فإن درجة التأكيد عليها أو رفضها، وتفسيرها وإحياء ذكراها، تختلف، بصورة صارخة، على جانبي الخط الأخضر. وثمة، هناك أيضاً، بلا ريب، مجموعة متنوعة من تفسيرات الأحداث التاريخية في إسرائيل وفلسطين على يد العديد من المجموعات الدينية والإثنية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة. وسوف أقتصر، من أجل أغراض البحث هنا، على الروايتين الواسعتين والمعممتين اللتين تكرسهما القوى الحاكمة على جانبي الخط الأخضر، وأيهما، من هذه الروايات، تعمل كسرديات وطنية لكلا الجانبين. فتختلفـ بل وتتناقض، على سبيل المثال، التوصيفات الإسرائيلية والفلسطينية لأحداث العام 1948، حتى بعبارات الوصف العامة والواسعة. فوفقاً للرواية الإسرائيلية، أعلنت إسرائيل نفسها دولة في العام 1948، وغادر معظم الفلسطينيين المنطقة بمحض إرادتهم، ولم يستخدم المستوطنون الإسرائيليون، وهم الآن مواطنون، العنف ضد الفلسطينيين إلا للدفاع عن النفس. غير أن الفلسطينين يجادلون بأن أرضهم سرقت، وأخرجوا من منازلهم بالقوة على يد المليشيات الإسرائيلية، عندما أصبحت إسرائيل دولة، وهربوا خوفاً على حياتهم. ربما يكون هذا التفاوت أكثر وضوحاً في الطريقة التي يحيي بها الطرفان أحداث العام 1948: فتحتفل إسرائيل بيوم استقلالها، بينما يعبّر الفلسطينيون عن حزنهم في المناسبة ذاتها كذكرى لـ”نكبتهم”. وتؤكد السرديات الفلسطينية والإسرائيلية للصراع، كما يرى روحانا وبار-تال، “على جوانب مختلفة من الصراع، وتقدم تفسيرات متباينة للأحداث نفسها، وتنتج رواية متماسكة تدعم ادعاءاتها وتدعمها بالكامل المجتمع” (Rouhana, and Bar-Tal .763) .وأحد المفاهيم الأساسية لكلتا الروايتين يتمثل في تاريخ التأذي والتماهي مع الضحية الذي يعتري كلا الطرفين. وتستند السردية الفلسطينية إلى معنى التأذي الفلسطيني وتشويه إسرائيل، بينما تستند الرواية الإسرائيلية إلى عكس هذه السرديات تماماً. ويمتلك كلا الطرفين، أيضاً، تاريخاً من الاضطهاد العنيف. ويزعم روحانا وبار- تال أن تاريخ التأذي والشعور بالضحية يؤدي إلى عدم الثقة بالمجتمع الدولي وشعور بانعدام الأمن على جانبي النزاع (Rouhana, and Bar-Tal .765)، ويؤثر هذا التاريخ على ميول كل طرف من طرفي النزاع نحو تحديد نفسه كضحية للطرف الآخر: فتعتقد تعتقد إسرائيل أنها ضحية للعدوان العربي، بينما يعتقد الفلسطينيون أنهم ضحية للصهاينة الإسرائيليين (Rouhana, and Bar-Tal .766). ونظراً لأن لعب دور الضحية يلقى تعاطفاً من وسائل الإعلام، نجد نزاعاً شديداً على لعب هذا الدور في سياق الصراع (Brand 176). فتعريف الضحية، وفقاً لـ “براند”، له فوائد أخرى أيضاً. وفي حين أن هناك عدداً من الأماكن التي يكون فيها تحليل براند لفيلم “الجنة الآن” اختزالياً، والذي سأناقشه لاحقاً، حيث يطرح نقاطاً مفيدة حول الاقتران الديالكتيكي بين الاعتداء والتأذي. ويزعم براند أن تعريف الضحية يسمح للفرد بتبرير عدوانه مع التمتع بالتفوق الأخلاقي على الضحية من خلال الإصرار على أن أفعاله هي نتاج ظروف خارجة عن إرادته (Brand 175-176). هذه الظاهرة بالتحديد هي التي ينادي بها ويتفق عليها روحانا وبار- تال، على أنها الميزة التي تديم عنف الصراع (Brand 178) وتساهم في استعصائه (Rouhana and Bar-Tal 764). يعتبر التماهي مع دور الضحية أحد عناصر السردية الوطنية الفلسطينية الأساسية، والمتمثلة في النضال من أجل الاعتراف الدولي بهم كضحايا بالضحية، وهو ما تحاول هذه الدراسة الحديث عنه.
تجدر الإشارة، بشكل خاص، إلى أحداث العام 1948 باعتبارها لعبت دوراً تأسيسياً في تكوين الهويات الوطنية لكلا البلدين، كما يذكر روحانا وبار- تال، وهي مثال على سرديات المحاكاة الإسرائيلية والفلسطينية. وأشير، هنا، إلى هذه الروايات على أنها “محاكاة Simulacral ” لمجرد أن كلتا الروايتين أصبحتا منفصلتين، الآن، عن واقع الأحداث التاريخية لعامي 1948- 1949 بحيث لم يعد من الممكن الوصول إلى الأحداث الحقيقية، حقاً، تحت طبقات التفسير المتراكمة. وقام كل طرف، بدلاً من تمثيل سلسلة “حقيقية” من الأحداث، بجمع مزيج من التقاليد الشعبية وروايات شهود العيان والأفلام والدعاية لتطوير الروايات الوطنية التي، على الرغم من أنها تستند في البداية إلى سلسلة حقيقية من الأحداث، فقد توقفت عن كونها تحمل أي علاقة بالأحداث الفعلية التي حصلت. ويجادل “بريشيث” (Bresheeth) بأن “مجمل الوجود في فلسطين / إسرائيل هو وجود مزدوج. لذلك هناك دولتان افتراضيتان في الفضاء عينه، هناك عالمان متوازيان يتجاهلان ويحتقران بعضهما البعض، ومع ذلك، نراهما مرتبطين، تمام الارتباط، ببعضهما البعض” (Bresheeth 80-81). ويعلن ميشيل خليفي نفسه: “لا أؤمن بالماضي، لقد اختفى” (Khleifi and Alexander 33). أدى الصراع المستمر حول الحدود والسرد، والذي يزعم العديد من الباحثين أنه مرتبط جوهرياً بقضايا الهوية أيضاً (Bresheeth 72; Gertz and Khleifi “Roadblock” 320)، إلى إنشاء رواية وطنية هي مجرد محاكاة ما يمكن أن يحدث بدلاً من سرد أو تمثيل ما حدث فعلاً. لقد انتقل سرد أحداث 1948-1949، وكذلك أحداث أخرى، خلال دورة [جان] بوديار من كونه انعكاساً للواقع، إلى كونه تحريفاً للواقع، وإلى إخفاء غياب الواقع، ليصبح، أي السرد، محض محاكاة خالصة للواقع. ولا يعني هذا أن بعض الأحداث التي تشكل الرواية الوطنية الفلسطينية لم تحدث قط، أو استحالة الوصول إلى التجارب الفردية للأحداث.
ومع ذلك، فقد تم جمع السرد المركب للأحداث الرئيسية، وتفسيره، والتلاعب به بطريقة تنتج قصة محاكاة بطبيعتها. وأصبحت ترمز هذه الروايات المحاكية إلى الوسائل الاجتماعية والسياسية لتأسيس وتجسيد الإيديولوجيات الوطنية وإعادة توحيدها. وسوف تعزز الإيديولوجية التي تنتجها هذه الروايات المحاكية النضال من أجل الحصول على رغبات محددة ثقافياً، مثل الوطن القومي، بدلاً من الرغبات الطبيعية كالسلامة والأمن والسلام. وتخضع السرديات المحاكية، بسبب دورها في تطوير الهويات الوطنية، لحراسة شديدة وتدافع عنها الجماعية المعنية. يدرس روحانا وبار- تال بعض العوامل النفسية التي تساهم فيما يطلقان عليه “النزاعات الإثنية المستعصية” ويحددان أربعة معتقدات، ذات صلة بالنزاع، تساهم في استعصاء المواقف. ساهمت الروايات الإسرائيلية والفلسطينية المحاكية في ظهور إيديولوجيات لكلا الطرفين تعمل على استدامة الاضطراب بسبب تأكيد هذه الروايات على معتقدات روحانا وبار-تال المجتمعية الأربعة، حيث يتم الحفاظ، في الصراع الإثني القومي المستعصي ظاهرياً، مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على معتقدات مجتمعية معينة وحمايتها كنوع من آليات المواجهة حتى يتمكن السكان من التعامل مع العنف والصعوبات الناجمة عن الصراع الطويل الأمد (Rouhana, and Bar-Tal .765)، والمعتقدات المجتمعية الأربعة التي يذكرها روحانا وبار-تال على أنها الأهم هي: الإيمان بأن أهداف الجماعة عادلة، وأن الخصم غير شرعي، ولا يمكن للجماعة أن ترتكب أي خطأ فيما يتعلق بالصراع، والجماعة هي الضحية(Rouhana, and Bar-Tal .765). زيمكن تبسيط هذه المعتقدات المجتمعية الأربعة إلى قسمين تقريباً: أولهما، معتقد الضحية المحقّة، وثانيهما، متقد العدو غير الشرعي. وينبغي، بالتالي، على الفلسطينيين، من أجل مواصلة نضالهم ضد إسرائيل، صون وتبني هذه المعتقدات المتضمنة، جميعها، في سردية المحاكة الفلسطيني. و كما ذكرنا سابقاً، تشكّل هذه المعتقدات، ولا سيما التماهي مع دور الضحية على وجه التحديد، أحد أسباب صعوبة حل النزاع. على الرغم من اعتقادي أن هذه ليست سوى ظاهرة تحدث على جانبي الصراع، إلا أنني سوف أتناول بالدراسة، هنا، أربعة أفلام فلسطينية، وسوف أعالج فقط سردية المحاكاة الفلسطينية والمعتقدات المجتمعية.
وتتمتع سردية المحاكاة بتأثير، لا يستهان به، على تصور المجتمع الغربي للأحداث، حيث تتكون الهيئات الدولية الحاكمة والرأي العام الغربي من عدد قليل من الأشخاص الذين لديهم تجربة حيّة عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ونتيجة لذلك، يعتمد معظمهم، في تكون آرائهم، على التقارير والتغطية الإعلامية. رغم ما تخلقه هذه التغطية الإعلامية للصراع، ما يسميه بوديار، واقعاً مفرطاً لمُشاهد الإعلام الغربي يكون فيه “واقع” الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما يفهمه الغرب، مختلفاً ولا يحمل بالضرورة أي علاقة بالأحداث الفعلية التي تجري في إسرائيل وفلسطين. وينشأ هذه الواقعية المفرطة من خلال تشبع وسائل الإعلام الغربية بالصور واللغات الصوتية للنزاع، ويقوم كل منها، عند مستوى ما، بتفسير الحدث أو الموقف. وما يدفع المُشاهد الغربي إلى تطوير تصور غير واقعي للصراع يقوم برمته على التفسير، إنما يعود إلى اعتماد هذا المُشاهد وحده على هذه التأويلات غير المكتملة، أو غير الدقيقة، في كثير من الأحيان، أو المنحازة بشدة للأحداث. إن مفهوم الغربي، غير المطلع، للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني غير موجود، ومع ذلك فالغربي الموحد يعتقد أن مفهومه للصراع يعبر عن حقيقة الصراع. وتتحوّل التفسيرات التي تخلق هذا الواقع المفرط وتتغير لصالح أو ضد سردية المحاكاة الفلسطينية القائمة على أحداث ومناخات سياسية مختلفة. ومع ذلك، لا يزال الغرب يفترض أن هذا الواقع المفرط المتغير هو الواقع الفعلي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بغض النظر عن علاقته أو عدمه بالأحداث الفعلية التي تجري في المنطقة. وينبغي التأكيد، من جديد، أن هذا لا يعني عدم الوجود الفعلي للصراع أو الأحداث الجارية بالفعل، ولكن المفهوم الغربي للصراع يتم إنتاجه في غرف الأخبار ومن خلال التأويلات، وليس من خلال الأحداث الفعلية التي تحصل. تتجاوز هذه الظاهرة مفهوم إدوارد سعيد عن قيام المستشرقين الغربيين بخلق الشرق لأنه، في عمل سعيد، يصبح التأويل الاستشراقي أكثر أهمية من الواقع ذاته الذي يتم تأويله، لكنه لا يحل محله تماماً. وبهذا، يعبّر التمثيل الإعلامي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني عن حقيقة الصراع بالنسبة لمتابعي وسائل الإعلام الغربية، الذين ليس لديهم أي خبرة أو معرفة أخرى بالنزاع. وتبرز هنا مشكلة أخرى في الاستشهاد بعمل سعيد لوحده حيث أن الواقعية المفرطة التي يتم إنتاجها ليست نتيجة محضة للتأثيرات الغربية.
تلعب إسرائيل، وهي دولة شرقية من الناحية التقنية، دوراً في التلاعب بوسائل الإعلام الأمريكية لإنتاج صورتها المرغوبة في الدولة (Mershimer and Walt 45)، ويؤدي هذا التلاعب، جزئياً، إلى ميل الواقعية المفرطة، في العادة، نحو موقف مؤيد لإسرائيل. وتكون هذه السردية الإعلامية ذات الواقعية المفرطة، بسبب اعتمادها الوحيد أساساً على التأويلات، أكثر مرونة وتغيراً من السرديات المحاكاة الإسرائيلية أو الفلسطينية. كما أن هناك ضغطاً إيديولوجياً ونفسياً أقل للحفاظ على سردية واحدة لا تتبدل للأحداث في الغرب، لأن مثل هذه السردية ليست سمة مميزة للغرب، مثلما هي سمة مميزة بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين. ونتيجة لذلك، يكون الرأي الغربي قادر على التحول، اعتماداً على المحتوى الإعلامي والصور القادمة من المنطقة الإسرائيلية / الفلسطينية. ويؤثر هذا، بدوره، على فهم الغرب للصراع، مما يجعل الرأي العام أكثر تعاطفاً أو أقل مع هذا الطرف أو ذاك. وهذا الرأي الشعبي للمجتمع الغربي له علاقة بالطريقة التي يتم بها تصوير أنواع مختلفة من العنف في الأفلام الروائية الفلسطينية.
ويبدو أن وجود عنف بصري في الأفلام الفلسطينية مرتبط بدرجة قبول الرأي العام الغربي للسردية الفلسطينية المحاكية لدور الضحية. ويلعب الإعلام دوراً رئيسياً في قبول هذه السردية أو رفضها، من حيث اختياره للصور واللغات الصوتية التي يقدمها لجمهوره. تفسر هذه الصور أحداث الصراع بطريقة تتفق أو تتناقض مع الرواية الفلسطينية المحاكية ومفهومها التأسيسي القائل بأن الفلسطينيين هم ضحايا للعنف الإسرائيلي. في المقابل، يتجه المجتمع الغربي الذي ينظر إلى هذه الصور، في الواقع، نحو قبول أو رفض السردية المحاكية الفلسطينية بناءً على هذه التأويلات الإعلامية. ويبدو أن الأفلام الفلسطينية التي أتطرق لها ،هنا، تظهر عنفاً بصرياً إلى حدٍ ما، يعتمد، جزئياً على الأقل، على كيفية رؤية الغرب لسردية المحاكاة الفلسطينية في زمن إنتاج الفيلم، على الرغم من اختلاف أنواع العنف التي يتم تناولها في الأفلام. ويبرهن فيلمي “نشيد الحجر” للمخرج ميشيل خليفي (1990) و “الجنة الآن” للمخرج هاني أبو أسعد (2005) على العلاقة النموذجية والمتوقعة بين تصوير العنف في الأفلام الفلسطينية والرأي العام الغربي في الأفلام الدرامية الطويلة. ويحتوي فيلم “نشيد الحجر”، الذي تم تصويره عندما كانت رواية المحاكاة الفلسطينية تلقى تأييداً لها في الغرب، على قدر كبير من عنف المقاومة، ولأنه أنتج، أيضاً، خلال الانتفاضة، فهو يؤكد بشدة المعتقدات المجتمعية الأربعة لروحانا وبار- تال، وبالتالي، لسردية المحاكاة الفلسطينية. يستطيع خليفي القيام بذلك، باستخدام العنف البصري لكل من المقاومين والجيش الإسرائيلي، لإظهار تأثير الاحتلال الإسرائيلي على المجتمع الفلسطيني بأسره على المستويين المجتمعي والشخصي. إن عرض هذا العنف يؤكد في نهاية المطاف أن الفلسطينيين هم محض ضحايا وأن إسرائيل هي الشر المحض. من ناحية أخرى، تم تصوير “الجنة الآن” عندما لم تكن الرواية الفلسطينية المحاكية مفضلة في الغرب، لذلك فهو يحتوي على القليل من العنف البصري ويحرم المشاهدين فعلياً من العنف المتوقع في نهاية الفيلم. من المهم أيضاً الإشارة إلى أنه بينما يتعامل خليفي مع العنف ضد الشعب الفلسطيني والعنف المستخدم في سياق عسكري لمقاومة الظلم، فإن فيلم أبو أسعد يعالج العنف الموجه ضد المدنيين والمرتكب من أجل الاستمرار في المقاومة وليس من أجل إنهاء الاحتلال. تم تصوير فيلم “الجنة الآن” خلال فترة الانقسام الفلسطيني ومع اقتراب الانتفاضة الثانية من نهايتها، وهو يؤكد على اثنين فقط من معتقدات روحانا وبار- تال المجتمعية، في حين يتعارض بشكل مباشر مع اثنين من المعتقدات الأربعة، مما يثير، في الواقع، تساؤلات حول بعض جوانب سردية المحاكاة الفلسطينية.
ومع ذلك، فإن العلاقة بين تصوير العنف في أفلام إيليا سليمان، “سجل اختفاء” (1996) و “يد إلهية” (2002)، والرأي العام الغربي، تتعارض على ما يبدو مع أفلام خليفي وأبو أسعد. ويعود هذا نتيجة لاختلاف النوع؛ فأفلام سليمان هي أفلام كوميدية، وعلى هذا النحو، لا ينظر الغرب إلى العنف فيها بذات طريقة رؤيته للعنف في الأعمال الدرامية الجادة. إن العنف في “يد إلهية” مبالغ فيه ومضحك ولا يُقصد منه أن يؤخذ على محمل الجد.
تم تصوير فيلم “سجل اختفاء” في ظل أجواء الفشل الذي كانت تعاني منه اتفاقيات أوسلو، ولأن الفلسطينيين بدأوا يخسرون التأييد الذي حظوا به في الغرب، بسبب استمرار استخدام المتطرفين الدينيين الأساليب الإرهابية لمهاجمة إسرائيل (Smith 246; Baxter and Akbarzadeh 145-6). يصادف أيضاً أن الفيلم لا يحتوي، تقريباً، على مشاهد عنف، ولا تدعم أحداثه المعتقدات المجتمعية وسردية المحاكاة الفلسطينية المحاكي إلا بشكل طفيف. لم يكن ثمة انتفاضة في ذلك الوقت، لذلك اختزلت الحاجة إلى تعزيز الرؤية الأيديولوجيّة. إلا أنه تم تصويره “يد إلهية” خلال العامين الأولين من الانتفاضة الثانية، وهو الوقت الذي كان فيه الفلسطينيون لا يحظون بدعم كبير في الغرب بسبب استمرار استخدام التفجيرات الانتحارية (Smith 248)، مما قد يدفع المرء إلى الشك في الغاية من الفيلم لاحتوائه على القليل من العنف، مثل “الجنة الآن”، رغم أن “يد إلهية” يحتوي على عنف بصري أكثر بكثير من “سجل اختفاء”، وإن كان ليس بذات القدر الموجود في فيلم “نشيد الحجر”. والعنف في فيلم “يد إلهية” يرتبط، كما هو الحال في “نشيد الحجر”، بوجود حركة مقاومة منظمة نسبياً على الأرض، أي، الانتفاضة الثانية. و نظراً لأن الفيلم كوميدي وتتداخل فيه المشاهد، يعمل العنف على تكريس أهداف أيديولوجية مختلفة، كما تعمل المشاهد، في الواقع، على السخرية من الاعتقاد الإسرائيلي بأن الفلسطينيين يشكلون تهديداً وجودياً لإسرائيل والذي بدوره يعزز سردية المحاكاة الفلسطينية، ولعل هذا يعود بسبب الطبيعة المبالغ فيها والخيالية للعنف في الفيلم. ومع ذلك، وبعيداً عن كون “سجل اختفاء” يؤكد، بصورة شبه مطلقة على المعتقدات المجتمعية الأربعة لروحانا وبار- تال، فإن “يد إلهية” يؤكد ثلاثة معتقدات منها فقط.
ومن الأهمية بمكان، لنا، أن ندرك العلاقة بين التصورات الغربية للصراع وعرض المعتقدات المجتمعية الفلسطينية في هذه الأفلام بسبب الطبيعة العابرة للحدود لكل من الأفلام والمخرجين أنفسهم، إذ يعيش اثنان منهما، خليفي وأبو أسعد في الشتات الأوروبي حالياً، هولندة تحديداً، بينما يقيم سليمان في رام الله، علماً أنه أمضى أكثر من عشر سنوات في الولايات المتحدة. لا يتوفر في فلسطين صناعة سينمائية، ولعل هذا يعود بالدرجة الأولى إلى العنف والاقتصاد الخانق للاحتلال. ويوضح غيرتز وخليفي أنه إذا رغب فلسطيني في إنتاج فيلم، فيجب عليه أو عليها الاستعانة بطواقم أجنبية، والعثور على تمويل أجنبي، وغالباً ما يكون تلقى تدريباً ما في بلد أجنبي (“Chronicle” 189). وهذا ما يخلق ديناميكية صعبة أحياناً، لكنها مثيرة للاهتمام بذات الوقت، لصانعي الأفلام الفلسطينيين. وتشرح ليفيا ألكسندر الأمر كما يلي: هناك، من ناحية، تعريف وتقويم للمعايير الغربية لإنتاج الأفلام وتمويلها وتوزيعها، فضلاً عن تجربة العيش في المنفى في الغرب، ومن ناحية أخرى، يقع الفلسطينيون في موضوع هامشي في الغرب باعتبارهم أفراداً من شعب محروم من حقه في الأرض والدولة، أو اعتبارهم مجرد “إرهابيين”. ومن خلال تقديم موقع المقاومة والتفاوض من هذا الموقف، فإن إنتاج أفلامهم يهتم بشكل وثيق بقضايا الهوية والوجود الفلسطيني (Alexander “Palestinians in Film” 320). تؤثر تجارب صانعي الأفلام في الغرب بلا شك على أسلوب ومحتوى العمل، كما يفعل الفلسطينيون. وعندما سُئل خليفي عن قراره العيش في بلجيكا، أجاب: “حقيقة أنني أعيش دولياً لا تجعلني أنسى أنني من شارع صغير في الناصرة. ولكن، على الرغم من ذلك، لنكن واقعيين، نعم أنا أعيش في أوروبا، لذا فأنا جزء من أوروبا أيضاً” (Khleifi and Alexander 33). ولذلك، يبدو من المفيد، لجهة فهم بعض القضايا المعقدة في إنتاج هذه الأفلام الأربعة، تفحص هذه الأفلام فيما يتعلق بالرأي العام الغربي، والذي قد يكون له تأثير، واعٍ أو غير واعٍ، على هؤلاء المخرجين الدوليين ، نظراً لما تتركه هذه التأثيرات المزدوجة على المخرجين، ،
فيلم “نشيد الحجر”- إخراج ميشيل خليفي
يروي ميشيل خليفي في “نشيد الحجر” قصة عشيقين انفصلا بسبب العنف والظروف الصعبة التي أفرزها الاحتلال الإسرائيلي. ويتخلل هذا السرد، الذي تم تصويره بأسلوب تقليدي عادي، لقطات وثائقية لمواقف وقصص مختلفة لأشخاص عاشوا في فلسطين خلال الانتفاضة الأولى. غالباً ما تتناول أفلام خليفي حالة صراع بين عالمين (Telmissany 77) لأنه يعتقد أن “روح السينما” تتجلى في إظهار الصراع بين العناصر. وحالة الصدام بالنسبة إلى فيلم ” نشيد الحجر”، هي الصدام بين عنف الانتفاضة والقصة الروائية (Khleifi and Alexander 32)، لكن الفيلم أيضاً ينقل هذا الصدام بين العناصر باستخدام صراع الأشكال، اعتياداً ووثائقياً. يجادل غيرتز وخليفي، في كتابهما، بأن أفلام ميشيل خليفي، على عكس الأفلام الفلسطينية اللاحقة، تحتوي على إحساس أكثر تماسكاً بالمشهد المكاني، وبينما يجادلان في صواب قولهما هذا عند لحديث عن فيلمي “عرس الجليل”[1987] و “حكاية الجواهر الثلاث” [1995]، يزعمان أنه يمكن قول الأمر عينه على فيلم “نشيد الحجر”. يستعرض خليفي في “عرس الجليل”، صوراً للمشهد المكاني ومشهد المدينة ويستخدم التصوير بالكاميرا لتجاوز الحدود ولإعادة إنشاء الأرض التي تم تجزئتها (Gertz and Khleifi Palestinian Cinema 82-3)، لكن خليفي يستخدم ذات التقنيات في فيلم “نشيد الحجر”.. من خلال عمل كاميرا مماثل وتجاور للصور، واستخدامه لـ “الذاكرة الجماعية للفلسطينيين”، التي تحتوي على تجارب متنوعة، ولكنها “متماسكة بشكل وثيق” وتساهم في تكوين هوية شاملة(Gertz and Khleifi Palestinian Cinema 76)، تمكن خليفي من فحص الطبقات المتعددة للمجتمع الفلسطيني في الفيلم، حيث يستخدم الأساليب المختلفة لصناعة الفيلم الوثائقية منها والشكلية التقليدية للتركيز على عواقب العنف الإسرائيلي على مستويات متعددة في المجتمع الفلسطيني: الفردية والعائلية والمجتمعية. وبينما يعمل هذا التباين على التمييز بين التجارب الشخصية وغير الشخصية للاحتلال، فإن جميع التجارب المذكورة أو المعروضة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعنف الاحتلال والمقاومة وتعمل على إثبات انتشار الاحتلال. إن تصوير خليفي للعنف يؤكد باستمرار المفهوم الفلسطيني الأساسي عن الشعب الفلسطيني بوصفهم ضحايا العنف الإسرائيلي. وبالمقارنة مع الأفلام الحديثة، مثل “الجنة الآن”، يصور “نشيد الحجر”، بشكل مباشر، قدراً أكبراً من العنف والغضب الفعال. وفي حين أن هذا العنف من نوع مختلف عن ذلك في “الجنة الآن” أو “يد إلهية”، إلا أنه لا يزال عنفاً بصرياً. بسبب التمثيل الإعلامي للانتفاضة الأولى والكمية الضئيلة نسبياً من العنف الذي استخدمه الفلسطينيون خلالها، تم قبول السردية المحاكية للتأذي ونشرها من قبل وسائل الإعلام الدولية والتي بدورها أدت إلى قبول عام لسردية المحاكاة الفلسطينية. في الرأي العام الغربي, ويعمل العنف في فيلم خليفي على التأكيد بقوة على المعتقدات المجتمعية التي تدعم هذه السردية
أ) الواقعية المفرطة والرأي الغربي والمعتقدات المجتمعية
تتعلق العوامل السياسية التي أحاطت بالانتفاضة الأولى بوجود العنف وانتشاره في فيلم خليفي. لقد خلقت الصور الإعلامية الصادرة من الضفة الغربية وغزة، خلال الانتفاضة الأولى، تحولاً في الواقعية المفرطة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني لصالح سردية المحاكاة الفلسطينية، مما أدى إلى تحول في الرأي العام الغربي بشأن طبيعة الصراع أيضاً. وتتزامن البيئة السياسية المواتية التي أحدثها هذا التحول مع استخدام خليفي، في فيلمه، لمقدار كبير من العنف البصري الذي عمل على تعزيز وتطوير المعتقدات المجتمعية الإيديولوجية الفلسطينية الأربعة الأساسية: تقديم الفلسطينيين كضحايا، وتبرير حركة المقاومة وسلوك المشاركين فيها، ونزع الشرعية عن إسرائيل قدر الإمكان. بدأت الانتفاضة الأولى على شكل انتفاضة شعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي في كانون الأول\ ديسمبر1987، وتضمنت، بخلاف الانتفاضة الثانية ( انتفاضة الأقصى)، عنفاً ضئيلاً نسبياً من جانب المقاومين الفلسطينيين الذين استخدموا، في المقام الأول، الوسائل السلمية للاحتجاج والمقاطعة، وعندما كانوا يهاجمون الجنود الإسرائيليين، كانوا- غالبيتهم على الأقل- يستعملون الحجارة والعصي، كان الردّ الإسرائيلي عليها بأساليب قمعية قاسية، الغاز المسيل للدموع والاعتداء الجسدي واستخدام الرصاص المطاطي والحي وحظر التجول، وهي أعمال ساهمت في تشويه سمعة إسرائيل الدولية. وطبقاً لـ “باكستر وأكبر زاده” فإن “صور الأطفال الفلسطينيين المسلحين بالحجارة في مواجهة العربات المدرعة الإسرائيلية تم بثها في جميع أنحاء العالم […] علاوة على صور جنود إسرائيليين وهم يضربون المدنيين الفلسطينيين العزل، غير أنها لم تلقى تكثيفاً مناسباً سوى بعض الدعوات الداعية لحل الصراع”(Baxter and Akbarzadeh 140). أشبعت هذه الصور الإعلامية وسائل الإعلام الدولية وقلبت تيار الرأي العام ضد إسرائيل، التي لطالما صورت نفسها على أنها ضحية جيرانها العرب العدائيين. ولأول مرة، منذ بداية الاحتلال، وافق الغرب على جزء أساسي من سردية المحاكاة الفلسطينية: أي أن الفلسطينيين كانوا، في الواقع، ضحايا الاحتلال الإسرائيلي. يعمل فيلم خليفي أيضاً على تأكيد ودعم هذه السردية من خلال التأكيد بقوة على معتقدات روحانا وبار- تال المجتمعية والإيديولوجية.
ويبدو أن خليفي قادر على دعم المزاعم التي تقول بأن أهداف الفلسطينيين هي المزاعم التي يستعرضها، بالأساس، في لقطات فيلمه الوثائقي والتي تربط بين تصرفات الأفراد أو معاناتهم لارتباطهم بالقضية الفلسطينية، بسبب قدرة هذه اللقطات على إظهار التشابك بين الحياة الفردية والعائلية والمجتمعية. في المشاهد التي تتحدث عن محمد، يذكر صديق له حق الفلسطينيين في تقرير المصير وفي أن يكون لهم دولة. وينهي الأب، الذي أصيب ابنه بالرصاص أثناء نقل براميل لقوات الجيش الإسرائيلي، قصته بمناشدة إنهاء الاحتلال. كما تربط العديد من الموضوعات الوثائقية الأخرى أيضاً بالهدف الفلسطيني المتمثل في إقامة دولة خاصة بهم.. دولة خالية من الجنود الإسرائيليين. ويوضح خليفي، أن تضحيات هؤلاء الناس مبررة لأن هدف الانتفاضة عادل، من خلال ربط العنف والمأساة في هذه القصص بأهداف الانتفاضة. كما يتم، بالمثل، استخدام الكثير من اللقطات عينها لإثبات ظلم وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي. وتمثّل لقطات الجنود الإسرائيليين، وهم يطلقون النار على الأولاد الصغار الذين يرشقون الحجارة، وكذلك لقطات النساء اللواتي يخرقن حظر التجول لشراء الطعام لعائلاتهن.. تمثّل كلاهما، بقوة، بعضاً من العنف المفرط الذي تمارسه القوات الإسرائيلية، بما يسمح لهذه اللقطات بتقديم مساهمة لمحاولة نزع شرعية وجودهم في فلسطين. ويتضمن خليفي أيضاً مقابلة مع امرأة مسنة تتذكر ما جرى في نكبة 1948، ونكسة 1967، وتروي كيف طان والدها يملك مساحات شاسعة من الأرض، فقد الكثير منها في العام 1948، وخسر المزيد مما تبقى في العام 1967. تشير، السيدة، إلى أرضها وتقول أن هذه القطعة هي كل ما تبقى من العديد من الأفدنة التي كانت لوالدها ذات يوم والتي استحوذ عليها الإسرائيليون الآن. هذه السيدة أكبر من أن تكون ناشطة في الانتفاضة، وليس لديها أطفال يمكن أن يشاركوا في المقاومة، وبالتالي، يمكن القول، أن إدراج لقطاتها في الفيلم ليست، ببساطة، سوى وسيلة لتذكر أحداث عامي 1948 و1967 وبدرجة اكبر وسيلة لنزع شرعية الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية. وهذا يستتبع منطقياً، أنه إذا كانت القضية الإسرائيلية غير شرعية والقضية الفلسطينية عادلة، فإن تصرفات حركة المقاومة لها ما يبررها. ومع ذلك، يقدم خليفي صوراً تبرر وتدعم احتجاجات الفلسطينيين واستخدام العنف المعتدل الذي يغلب عليه رشق الحجارة. ويعمل مشهد المرأة العجوز، التي تناقش أحداث عامي 1948 و1967، على تبرير أفعال الفلسطينيين من حيث أنه يقدم أدلة على أخطاء الماضي. فإذا أخذ الإسرائيليون الأرض من الفلسطينيين في عامي 1948 و1967، فإن محاولات الفلسطينيين لاستعادة تلك الأرض لها ما يبررها. كما يحتوي على أمثلة وأوصاف للإجراءات العنيفة والقاسية المفرطة للاحتلال الإسرائيلي مثل هدم منازل العائلات الفلسطينية الأبرياء. لم تعرف عائلة بطل الرواية عن مشاركته في المقاومة، لكن الجيش الإسرائيلي دمّر منزل العائلة بغض النظر عن براءة العائلة. يضمّن خليفي، في الفيلم، مشهداً لجنود إسرائيليين يجبرون شابين على محو رسومات على أحد جدران المدينة، وهو ما كان يمكن فهمه لو كان الشابان هما من قاما بالكتابة على الجدران، لكنهما كانا مجرد شخصين في طريقهما باتجاه المدينة عندما استوقفهما الجنود وطلبا منهما إزالة الكتابة ومحوها، وعندما يحاولان الرفض، يهددهما الجنود بالبنادق. هذه الأنواع من تكتيكات الإذلال والقوة المفرطة تبرر بشكل أكبر قرار الفلسطينيين بالثورة على الاحتلال. وبينما يؤكد الفيلم بشدة على جميع المعتقدات المجتمعية الأربعة، فإن الجزء الأكبر من العنف المرئي في الفيلم موجه إلى تصوير الفلسطينيين على أنهم ضحايا الاحتلال -وهو موضوع سيتم فحصه بالتفصيل في القسم التالي.
ب) أسلوب الفيلم والعنف والتأذي
يستخدم ميشيل خليفي، في فيلم “نشيد الحجر”، أسلوبين مميزين في التصوير لإيجاد التباين بين تجارب العائلات والتجمعات الفلسطينية و النضالات الفردية والشخصية للزوجين اللذين لم يكشف عن هويتهما، (يؤدي دوريهما كل من “بشرى قرمان” و”مكرم خوري”). وبينما يتم تصوير الزوجين بأسلوب تقليدي اعتيادي، يظهر خليفي لقطات المجتمع وقصص العائلات بأسلوب وثائقي، وفي حين يستخدم أيضاً المقابلات الشخصية في الفيلم الوثائقي التي تعبر عن غضب واستياء الشعب الفلسطيني، أثناء وصفهم أحداثاً شخصية، على عكس الزوجين الدراميين اللذين يصفان أيضاً أحداثاً شخصية، ولكن مع التركيز بشكل أكبر على تنوع المشاعر والحميمية، فنظهر الخبرات المتضمنة في الحوادث بدلاً من مجرد الغضب، ولهذا تنقل الصور الخارجية للمجتمع إحساساً بالفوضى والعنف والخسارة، بينما ينقل الحوار الهادئ، بين الزوجين، إحساساً بالاستقرار الهادئ وتصميم الأفراد الفلسطينيين على مواجهة الاحتلال، ولكن كلا الأسلوبين المستخدمين في الفيلم ينقلان صوراً قوية للعنف، إما بصرياً، في حالة اللقطات ذات الأسلوب الوثائقي، أو من خلال الوصف اللفظي في المشاهد الاعتيادية التقليدية للزوجين الحبيبين. ويستخدم هذا العنف كوسيلة للتأكيد على قيام الاحتلال الإسرائيلي بإيذاء السكان الفلسطينيين ككل.
يتعلق المحتوى، في الغالبية العظمى من اللقطات الوثائقية التي يستخدمها خليفي في الفيلم، بتدمير أو تعطيل المجتمعات الفلسطينية. وتظهر أولى هذه المشاهد في بدايات الفيلم، حيث تظهر عناصر الشرطة الإسرائيلية وهي تقوم بإغلاق مدرسة فلسطينية للبنات في القدس. تتقاطع هذه اللقطات الوثائقية وتتعارض بشدة مع مشاهد العاشقين اللذين يتحادثان بهدوء في أجواء حميمية. تبدو لقطات الشارع خارج مدرسة البنات فوضوية -تنطلق صفارات الإنذار في الخلفية، ويتحدث العديد من الأشخاص بلهجة سريعة، ويصرخ أفراد الشرطة الإسرائيلية وهم يلقون الأوامر ويلوحون ببنادقهم. وتكون الكاميرة في هذه المشاهد مهتزة، واللقطات قصيرة وغير مؤلفة بشكل تقليدي اعتيادي، مما يساهم في تنامي الشعور بالفوضى والخوف الناجم لدى العديد من الأفراد الذين تتم مقابلتهم. على الرغم من أن المشاهد تتضمن مقابلات موجزة مع عدد قليل من الطالبات وبعض أولياء الأمور والمدرسين، إلا أنه لا يتم تقديم هذه الحالة كتجربة شخص واحد، بل تظهر كأنها حكاية وتجربة يشارك فيها المجتمع ككل. وتظهر الفتيات الصغيرات، ومعظمهن يرتدين الحجاب، محملات في مؤخرة شاحنات الشرطة بينما تبحث أمهاتهن عنهن بشكل محموم. كما أجريت مقابلات مع مجموعة أخرى من الفتيات يحاولن القول أن عناصر الشرطة أغلقوا غلق المدرسة لزعمهم قيام بعض الفتيات كن يرشقن الحجارة، مع إصرار الفتيات على نفي ادعاءات الشرطة، بل أن الأمر ببساطة، يتمثل في قيام الشرطة باستفزازهن حسب ما تقول الفتيات. وتظهر المعلمة، التي تتحدث لفترة وجيزة إلى الكاميرا، في حيرة من أمرها مما يتوجب عليها أن تفعله، لأنها لا تستطيع العثور على المدرسين أو المسؤولين في المدرسة. وهذه اللقطات بمثابة مؤشر على آثار الاحتلال على مستويات متعددة في المجتمع. يؤثر الفعل الفردي المتمثل في إغلاق المدرسة على المجتمع، من المهنيين الذين يدرِّسون في المدرسة ويديرونها إلى الفتيات الصغيرات اللائي يحضرنها وعائلاتهن. ويهدف هذا الإجراء أيضاً إلى هدف غير قتالي مليء بالنساء والفتيات المدنيات. ومن الواضح أن خليفي قادر على استخدام صورة إغلاق مدرسة البنات، بالقوة والعنف، للإشارة إلى أن المجتمع بأكمله يعاني من الاحتلال، وليس فقط الشباب الذين يقاتلون في حركة المقاومة. كما يستخدم خليفي الشريط الوثائقي لإظهار الصلات بين التجارب الفردية والعائلية والمجتمعية للانتفاضة. ومن أفضل الأمثلة على هذا الترابط قصة محمد، المتشابكة مع قصص مجتمعه وعائلته. وعلى الرغم من أن اللقطات الفعلية المعروضة ليست لأحداث عنيفة، إلا أن محمد يصف، بالتفصيل، الظروف العنيفة التي أصيب فيها ويكشف عن ندبة خلّفتها الشظية التي أصابته. لكن خليفي يبدأ، قبل تقديم لقطات لمحمد، بمقابلة والدي محمد، حيث وصف والده الصبي كيف أنه لم يعد قادراً على مشاركة أكل التفاحة مع ابنه، وتأسف والدته كيف لم يعد محمد قادراً على تناول طعامها الذي كان يحبه، وسبب شكوى الأب والأم أن ابنهما فقد معظم أمعائه نتيجة إصابته. ويشر خليفي، من خلال تقديم قصة محمد عبر والديه، إلى أن قصة محمد لها تداعيات تصل إلى أبعد من الصبي ذي السبعة عشر عاماً والانتفاضة وعائلته ومجتمعه. تم تصوير محمد نفسه لأول مرة وهو في سريره في المستشفى رفقة أحد أصدقائه، الذي يساهم بشكل دوري في المقابلة، وكذلك في اللقطات. تبدو غرفة محمد، في المستشفى، مزيّنة بصور شهداء من منطقته، ويقع وصفه لجرحه وتجربته الشخصية ضمن صياغة السياق الأوسع للانتفاضة ومجتمعه. فيتحدث، غالباً، عن رغبة الفلسطينيين في أن تكون لهم دولتهم الخاصة بهم ويتطرق إلى الإذلال اليومي الذي عاناه هو والفلسطينيون الآخرون على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما يشير، ويصف العديد من صور الشهداء المعلقة فوق سريره ويسمي كل شهيد ويصفه باقتضاب كأن يقول: “كان لديه ثمانية أطفال” أو “كان عمره خمسة عشر عاماً فقط”. وتروي والدته كيف ذهب محمد في اليوم السابق لإطلاق النار عليه لالتقاط صورته وادعى أنه سيكون شهيداً عما قريب. وهو يدرك أن تجربته مشابهة ومرتبطة بمئات من الشبان الفلسطينيين الآخرين الذين أصيبوا أو قُتلوا في ظل الاحتلال، كما أن مجتمعه يعترف بهذه الصلة. محمد هو الضحية الأكثر وضوحاً للعنف في هذا الجزء من الفيلم، لكن تم تصويره على أنه ضحية واحدة فقط ضمن سلسلة طويلة من الضحايا المتشابهين من خلال صور الشهداء. يستخدم خليفي محمد كمثال على العنف الذي يعيشه المقاومون، لكنه يوسع أيضاً قصة المقاومة لتشمل بقية المجتمع أيضاً. لا يظهر محمد في عزلة. وعندما يعرض خليفي لقطات لعودة محمد إلى حيّه، يتضح أن جيرانه ينظرون إليه كبطل، ويحافلون بعودته وهم يرقصون في الشارع، ووالدته وسط الحشد. لكن حتى هذا الاحتفال لا يمكن أن يفلت من خطر العنف، حيث تقف مجموعة من الجنود الإسرائيليين بحذر من مسافة بعيدة، وبنادقهم مشدودة على أجسادهم. يستخدم خليفي قصة محمد كدليل على انتشار آثار عنف الانتفاضة على المجتمع الفلسطيني. قصة جرح أحد الأطفال وشفائه منسوجة بشكل لا ينفصم عن قصة مجتمعه الذي يقاتل نيابة عنه والذي هو أيضاً ضحية للاحتلال.
وبينما تتضمن اللقطات الوثائقية مقابلات مع أفراد يروون قصصهم الشخصية، مثل الزوجين الدراميين اللذين لا نعرف اسميهما، فإن هذه القصص، غالباً ما تكون روايات مصورة وعنيفة تُروى بأصوات غاضبة ومختلطة بخطاب الانتفاضة. ولعل من أبرز المقابلات من هذا النوع التي ضمّنها خليفي، تلك المقابلة مع رجل في منتصف العمر يصف وفاة ابنه, ويوّر خليفي المقابلة حيث يكون الرجل جالساً في مواجهة الكاميرة ويتحدث مباشرة، بينما يحيط به أفراد من جيرانه، وليس ثمة ما هو عنيف في هذا المشهد، غير أن العنق ينسل إلى المشهد من خلال وصف الرجل لموت ابنه. فطبقاً للرجل، طلب منه جندي إسرائيلي، عندما يهم بمغادرة المسجد ومعه ابنه، نقل البراميل بعيداً عن الشارع. ونظراً لوجود نساء وأطفال، ولأن الجندي كان قد كسر ذراع أحد الأطفال بالفعل، فقد امتثل الرجل للأمر وطلب ابنه المساعدة من أجل إنهاء المهمة بسرعة، وأثناء ذلك هاجمت مجموعة من الجنود المكان على حين غرة، فأصيب الابن البالغ من العمر ستة وعشرين عاماً بعشر رصاصات ومات على الفور في مكانه في الشارع. لا يرى المُشاهد مناظر عنيفة بينما الرجل يروي قصته بهذه البساطة، لكن ثمة غضب ملموس في صوت الرجل يتصاعد اثناء حديثه، وعندما يصل إلى بعض المواضع في روايته يصرخ مستذكراً موت ابنه. وبعد أن ينهي الرجل سرد قصة موت ابنه، يربط ما حدث له ومعاناته الخاصة بمعاناة المجتمع ككل فيعرض أمام الكاميرة طفل صغير مصاب بطلقة مطاطية سببت انتفاخاً و تورماً في قفصه الصدري، وكأنه يوحي أن قصة موت ابنه ليست حدثاً منفرداً أو منعزلاً. استخدم خليفي، هذا المشهد، مرة أخرى فرداً واحداً لتمثيل معاناة وضحية المجتمع ككل. ومثلما هو الحال مع الفتيات في مشهد مدرسة البنات، وكذلك مشهد المقبلة مع والد الابن المقتول لا يظهر هؤلاء على أنهم من مقاتلي المقاومة، وكما يقول الأب، لم يفعل ابنه ما يستوجب أن يُطلق عليه النار ويُقتل في الشارع، وكل ما في الأمر أنه كان في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. بعبارة أخرى، كان ابنه محض ضحية للعنف الإسرائيلي غير المبرر. ثمة عدم وضوح في هذه المشاهد ذات الأسلوب الوثائقي، وتتجلى الضبابية أكثر بين ما هو شخصي وما هو عام على صعيد الأفراد الذين أجريت معهم المقابلات وكذلك من خلال دمج الصور والأصوات والأشخاص الآخرين داخل المشهد. ويعكس نسج الصور هذا، التي يظهر بعضها هادئ وجميل، وبعضها الآخر صاخب وفوضوي، وبعضها حزين، والبعض الآخر ثابت، كل هذا، يعكس التجربة اليومية للفلسطينيين في ظل الاحتلال ويخدم التأكيد على حتمية مزاعم الفلسطينيين بتعرضهم للتأذي من الوجود الإسرائيلي.. بينما لا تزال هناك تجارب ممتعة للفلسطينيين، وبينما تستمر الحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة، يتم مواجهة هذه التجارب على فترات منتظمة بتجارب من الصدمة والحزن والغضب والإذلال، والتي ينتج عنها مزيج من الشعور بالتأذي الذي يبرزه خليفي في المشاهد الوثائقية. ولكي يعتقد المُشاهد أن الفلسطينيين مثقلون في هذا التأذي، يضيف خليفي مشاهد أكثر اعتيادية وتقليدية بين العاشقين للمساعدة في إثبات أن الفلسطينيين يواصلون حيتهم في فلسطين المحتلة من خلال الهدوء والمثابرة، على الرغم من كونهم ضحايا العنف الدائم. ويقوم المخرج بتشكيل وترتيب مشاهد الزوجين والعناية بها بصورة ملفتة، فتظهر الزوجة، في المشهد الأول، وهي تجلس على السرير في الغرفة المعتمة، إلى يمين وفي منتصف كادر الشاشة تقريباً، ويتسرب الضوء الوحيد من النافذة التي على اليمين. وتحتل الزوجة غالبية اللقطة أثناء حديثها؛ ويختلف الحال عندما يسير الرجل ضمن الكادر، ثم يجلس على السرير أمامها، فيخلق تكويناً على شكل حرف L، ليسيطر، بدوره، على اللقطة، وتظهره الإضاءة القادمة من النافذة أكثر وضوحاً بسبب لون قميصه الأزرق الفاتح، مما يجعله يبدو، اثناء حديثه، الموضوع الأساسي للمشهد. ويعتني خليفي، بدقة بجميع مشاهد الحبيبين تقريباً، بعكس لقطات المشاهد الوثائقية التي تبدو طويلة وثابتة وهادئة، ناهيك عن الحوار الهادئ والثابت أيضاً.
يتناقض الشعور بالثبات الذي يخلقه استخدام هذه العناصر الاعتيادية مع مواضيع محادثات الزوجين. يناقش الزوجان تجربتهما الشخصية مع الاحتلال بتفاصيل دقيقة، وبينما يصفان أحداث حياتهما بأصوات هادئة، فإن الأحداث ذاتها ليست كذلك، بل هي عنيفة ومأساوية. ومع هذا لا يكون التركز على عنف الحدث، بل على تجارب العنف الشخصية لكليهما، كأفراد، وعلى بعضها كزوجين. ويستخدم خليفي عناصر فيلمية تقليدية، مثل الإضاءة وتأليف المشهد، لتسليط الضوء على راوي هذه القصص وعزمه على مواصلة وجوده الطبيعي قدر الإمكان في فلسطين في مواجهة العنف والصدمة التي يعانون منها كأفراد، ولعل تضمين هذه المشاهد يؤمن المادة المناسبة لخليفي لإظهار تعارض الغضب الجماعي الموجود في اللقطات الوثائقية مع التجارب العاطفية الشخصية المعقدة للزوجين، ويساعد مثل هذا التباين، خليفي، على استيعاب أكبر قدر ممكن من تجربة شعور التأذي الفلسطيني في فيلمه، فضلاً عن تصوير الضرر الشخصي الأقل وضوحاً والذي يواجهه الفلسطينيون نتيجة للاحتلال. ففي المشهد الأول للزوجين، يصف الرجل يوم اعتقاله وطرد عائلته من منزلهم نتيجة مشاركته في المقاومة وسجنه، ثمة مشاعر عديدة تثيرها القصة التي يرويها، لكن ملامح وجهه تبقى دون تغيير وهادئة. يتأسف لأن الأسرة فقدت منزلها نتيجة أفعاله، ويتذكر تفاصيل المبنى والأشياء والمجردة التي أجبرت الأسرة على تركها وراءها. يتناقض وصفه، والمشاعر التي يثيرها، بشكل حاد مع مشهد الأسلوب الوثائقي الذي أدرجه خليفي في نهاية الفيلم، حيث تظهر اللقطات عملية إخلاء عائلة من منزلها وهدم البيوت المجاورة بأكملها. يتصاعد المشهد بصخب وينقل مشاعر الفوضى التي تشعر بها الأسرة، فتظهر الجدة وهي تبكي لفقدانها منزلها، بينما يقف الأطفال الصغار في حيرة ن أمرهم مما يجب عليهم فعله، ويقوم الرجال بتجريد المنزل من أي شيء ذي قيمة يمكن للأسرة الاحتفاظ به، وتظهر متعلقات الأسرة ملقاة في الفناء، ثن ينتقل المشهد إلى شابة تتحدث بسرعة وبغضب أمام الكاميرا، وتؤكد على استمرارية المقاومة، رغم عدم امتلاكهم ما يكفي من المال لشراء الطعام أو الدواء، وها هم الآن باتوا بلا منزل يأويهم أيضاً، لن يتمكن الاحتلال من القضاء على المقاومة، هكذا تقول الفتاة بغضب. وهذا، بالأساس، المشهد ذاته الذي يصفه الرجل، ولكنه في هذا الأسلوب الوثائقي ينقل المخرج حالة الغصب حصراً دون التداخل مع مشاعر أخرى، بينما التوصيف الذي يقدمه الرجل \ الزوج لتجربته الشخصية لعملية الطرد من المنزل تنطوي على مشاعره الشخصية الخاصة المرتبطة بالفقد والحزن بالإضافة إلى الشعور بالذنب بسبب ما تسبب به عن غير قصد بأن جعل عائلته هدفاً للجيش الإسرائيلي. ويتحدث عن الطريقة التي نظرت بها أسرته إليه، وكأنهم لم يروه من قبل، حيث تم اعتقاله وكيف كان مسؤولاً عن تدمير منزل عائلته. كما يروي كيف عاشت أسرته في منزل مكوّن من غرفة واحدة لفترة طويلة بعد هدم منزل الأسرة، ومع كل هذا، فهو لا يتعرض للوم عائلته، بل على العكس فقد وقفت، الواقع، عائلته إلى جانبه. ويسمح الرجل للقارىء أن يتفحص ويركز، من خلال السرد الشاعري للرجل\ الزوج، على الصور التي تضيع في مزيج من الضوضاء والغضب في المشهد الوثائقي. ويزعم الرجل أثناء حديثه أن “رأسه مليء بصورة كرسي مُلقى في السماء، وجوارب أخيه الصغير تطفو في الهواء”. هذه الصور التي تم التقاطها من خلال حواره تسمح للمشاهد بتركيز الصورة الأوسع التي رسمتها المشاهد الوثائقية على تجربة شخصية أكثر ضيقاً. وبينما تتناثر قطع الأثاث والثياب في هذه اللقطات الوثائقية، يرسم الرجل صورة قوية لهذين العنصرين المحددين اللذين أصبحا جزءً من ذاكرته. لم يعد ثمة موضع، في هذا الوصف، لأشياء عشوائية مبعثرة حول أشخاص مجهولين، إنها كرسي عائلته وجورب يخص أخيه. تصبح صور هذا الحدث العنيف شخصية وأكثر واقعية.
وفي المقابل، تروي المرأة \ الزوجة، عدداً من الحكايات التي تضفي طابعاً شخصياً على بعض موضوعات المشهد الوثائقي. ومن أكثر رواياتها إثارة وصفها لحبها الأول وإجهاضها اللاحق. فتصف، في هذه القصة، ذهابها إلى الجامعة في حيفا حيث التقت بحبها الأول هناك. وتتحدث عن تعلم التمرد والمقاومة لكنها تنسى نفسها في هذا السياق. لقد حملت وأجهضت لكنها أصيبت بعدوى واعترفت لعائلتها عندما لم يعد بإمكانها إخفاء ذلك. ثم تتابع القول، لتصف نقاشها مع عائلتها حول الطريقة التي يجب أن يقتلوها بها، ثم يقرروا، في نهاية المطاف، طردها ونفيها. تصف المرأة، أثناء سردها، مشاعر الحب والخوف والحزن والعار والشعور بالذنب. يتضمن هذا السرد موضوعات يتناولها المشهد الوثائقي، ومجمل الفيلم ككل/ بصورة واسعة، بما في ذلك اضطراب الحياة الأسرية الناتج عن التمرد. هناك عدة مشاهد وثائقية تشير إلى انحراف في الأنشطة النموذجية للعائلة/ كما ثمة، هناك، صور متكررة للأسواق التي كانت مفتوحة ذات يوم وصارت الآن مغلقة ومهجورة بسبب حظر التجول الذي فرضه الجيش الإسرائيلي على المدن. حتى أن خليفي يضم صوراً لنساء وأطفال يكسرون حظر التجوال في غزة من أجل الذهاب إلى سوق مؤقت وشراء الطعام، لأن المدينة كانت مقفلة بسبب حظر التجول الذي استمر لعدة أيام ويكاد الطعام ينفد من العائلات. ورغم أن هذا النشاط يعتبر عادياًـ إلا أنه الآن بات يظهر كسلوك “إجرامي” (حسب المعايير الإسرائيلية)، فظهر ذهاب النسوة لشراء المواد الغذائية، أثناء حظر التجوال، كأنه عمل أجبرن عليه بسبب الاحتلال والانتفاضة.
وثمة حادثة أخرى، ربما أكثر تنافراً، تم تصويرها في أسلوب وثائقي، وهي مشهد مجموعة من الأولاد الصغار، ربما في الثامنة من أعمار، يلعبون “سبع حجرات”، لكنهم، في الواقع، يستخدمون الرصاص المطاطي الذي عثروا عليه في الشارع بدلاً من الكرات. يتحدث الأطفال أمام الكاميرة بأن الجنود صادروا كراتهم، لذا فالبديل الأفضل الآن هو الرصاص المطاطي. ثم يذهب أحد الأولاد ليُظهر للكاميرا حفنة من أنواع مختلفة من الرصاص ويصف افرق بين كل نوع ويشرح ما يسببه كل نوع عندما يصاب به أحدهم. يذكرنا هذا بمشهد بطفل يُظهر لشخص بالغ مجموعة من الرخام ويصف الفرق بين رخام “عين القط” ورخام “دم الثور”. وإذن حتى النشاط الذي يبدو غير ضار، مثل لعب الأطفال بالكرات، قد تغير نتيجة للانتفاضة. وفي كلتا الحالتين، تظل مواضيع المشاهد الوثائقية مجهولة الهوية وغير شخصية. لا يوجد ذكر لمشاعرهم حيال هذه التغييرات في أنشطتهم اليومية باستثناء الانزعاج والغضب.
وتظهر تجربة المرأة\ الزوجة في المقاومة الحب، على عكس موضوعات المشهد الوثائقي، كأنها قد غيرت حياتها بطريقة رأساً على عقب تقريباً، كما تسببت، هذه التجربة، لها ولعائلتها بالمزيد من الألم والمعاناة، فمن جهة جعلها طغيان حبها الأول وتعرفها على تجربة المقاومة تنسى من هي وتبتعد عن روابطها الأسريّة، ومن جهة جلبت تجربته تلك العار لعائلتها فابتعدوا عنها وهجروها، لنتذكر عندما كان أفراد عائلتها يناقشون الطرق الممكنة لقتلها، و كانت الطريقة الأخيرة المقترحة هي الحرق، وكيف قوبلت بالرد: “كيف يمكنهم حرقك عندما يكون البلد مشتعلاً؟” القرار الأخير هو أنه يجب نفيها، لكن هذا الاقتباس يشير إلى أنه ربما يكون الدمار الذي سببته الثورات وجعل موتها نافلة لا عنى لها إزاء العنف، بهذا يكون الدمار هو السبب الوحيد لبقائها على قيد الحياة. فالانتفاضة لا تساهم فقط في فقدانها للذات، بل إنها تعرقل أيضاً، بما يبدو في مصلحتها، السياقات العقابية العائلية على سلوكها. ويتعرف المُشاهد، بعكس المشهد الوثائقي، على مشاعر الخوف والعار والشعور بالذنب، بالإضافة إلى عواطف عائلتها أثناء عملية اختيار طريقة معاقبتها. يظهر أقاربها من الذكور في حالة غضب وخجل من سلوكها، وتظهر أمها غارقة في الحزن. توضح هذه اللقطة كيف يغير الاحتلال والانتفاضة من طبيعة العلاقات الأسرية، وهي تبدو لقطة شخصية أكثر من تلك الصور الموجودة في المشهد الوثائقي، كما تظهر مستوى أكثر تعقيداً من الناحية العاطفية للمُشاهد ليختبرها بدلاً من مجرد تأمل صور معممة وعنيفة. قد يبدو هذا المشهد في البداية وكأنه يتناقض مع تأكيدي بأن الفيلم يؤكد الاعتقاد بأن الفلسطينيين لا يمكن أن يرتكبوا أي خطأ. ترى “مي تلمساني ” أن ميشيل خليفي يستخدم النقد المزدوج في معظم أفلامه، بما في ذلك نشيد الحجر (Telmissany 81-82)، بينما يشير خليفي نفسه وكينيدي إلى أنه يحب الانخراط في النقد الداخلي التقليدي / الحداثي (Kennedy 40; Khleifi and Alexander 33). في حين يبدو أن هذا المشهد هو نقد للمعايير الثقافية الفلسطينية التقليدية للتعامل مع الابنة المتمردة والعار، إلا أنه يمثل نقداً لما يحدث في فلسطين على الصعيد الداخلي، وليس بوصفه مشكلة خارجية مع الاحتلال.
وبينما يؤثر الاحتلال على قرار الأسرة، فإن العملية بحد ذاتها ليست ناتجة عن الاحتلال أو عن مقاومته. يشير تحليل روحانا وبار- تال للمعتقدات المجتمعية، على وجه التحديد، إلى السلوكيات التي ترتبط، بطريقة ما، بالنزاع نفسه، لذلك على الرغم من أن الأفراد لا يزالون قادرين على ارتكاب أخطاء في حياتهم الشخصية والعائلية، إلا أن السلوك الفلسطيني فيما يتعلق بالمقاومة لا يزال يعتبر صحيحاً وعادلاً.. يصف الزوجان أيضاً الأحداث التي مروا بها معاً. وكان أبرز حدث ناقشوه اعتقاله وسجنه خمسة عشر عاماً. ناقشوا انفصالهم نتيجة سجنه عدة مرات طوال الفيلم وكان كل نقاش يسلط الضوء على الاختلافات في تجاربهم الشخصية للحدث ذاته. وكان أول ما ناقشوه قرارها بقص شعرها. يذكر كيف أحب شعرها الطويل، وكثيراً ما كان يفكر في إحساسه ورائحته أثناء وجوده في السجن. لكنها تشرح كيف اضطرت لقصّه من أجل محو حبها الأول، الذي أحب شعرها الطويل أيضاً، و “إنهاء معاناة [حبها] الثاني”. يستخدم خليفي هذا المشهد ليثبت أنه على الرغم من أن الناس قد يواجهون الأحداث ذاتها، إلا أنهم يقومون بذلك بطرق مختلفة، وتأتي الأحداث وتجري لتعني وترمز إلى أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين. ويركز المشهد الوثائقي، على عكس مشاهد الزوجين، على المشاعر المشتركة والتجارب المشتركة. فيصف، على سبيل المثال، الرجل الأول الذي تمت مقابلته في غزة حول وفاة ابنه، كيف داهم الجنود الإسرائيليون منزله في منتصف الليل، وقتلوا أحد أبنائه، وأخذوا آخراً معهم. ويظهر غضبه واضطرابه وهو يصف هذا المشهد ويحيط به عدد من الرجال من جيرانه، وتتخلل لقطات له وللرجال لقطات من مناطق مختلفة في غزة. وعندما ينتهي الرجل من سرد قصته، يزعم رجل آخر، يجلس بجانبه، أن الأمر عينه حدث لجاره بعد يومين وعاد الجنود لتفجير منزل الجار بعد بضعة أسابيع. هناك تركيز، في هذه المشاهد، على التجربة المشتركة. يروي الفرد قصته أو قصتها، ولكنه يسارع في سرد قصص أخرى مثل قصصه أو قصصها من أجل إظهار أن عنف الاحتلال منتشر. وبالمثل، تكون هذه المشاعر، التي تظهر أثناء سرد هذه القصص، هي المشاعر التي تتشاركها الجماعة أو المجتمع. لا يتحدث الأفراد في المشاهد الوثائقية، عن تجاربهم بطريقة شخصية أو حميمة قط، وعادة ما يظهرون مشاعر الحزن أو الغضب، وهي مشاعر يتشارك فيها جميع الحاضرين أثناء التصوير. إن إصرار الخليفي على تضمين الرواية الشخصية الحميمية للزوجين إلى جانب اللقطات الوثائقية يسمح للفيلم بالتقاط الطبيعة الجائحة المتفشية للاحتلال للمجتمع الفلسطيني بأسره، وكذلك الوسائل التي يتعامل بها الأفراد مع العنف الذي دفعتهم إليه الحرب. يقدم “نشيد الحجر” صورة مقربة للتجربة الفلسطينية للاحتلال والانتفاضة تشمل الضرر النفسي والعاطفي للأفراد وكذلك الأضرار البنيوية التي تلحق بالمجتمعات والوحدات الأسرية. وتوضح هذه الصورة\ الحلقة المستديرة، بدورها، الطرق كافة، التي يتأذى بسببها الفلسطينيون من عنف وعسف الاحتلال.
إن الاستخدام المستمر للعنف طوال الفيلم لإظهار المعتقدات المجتمعية المختلفة التي يدعي روحانا وبار- تال أنها ضرورية أثناء تفشي النزاعات الإثنية المستعصية والتركيز بشكل خاص على إظهار الفلسطينيين كضحايا، بلا منازع، للعنف الإسرائيلي لتأكيد سردية المحاكاة الفلسطينية الذي تأسست على قاعدة تلك المعتقدات.
إن إعادة تأكيد هذه المعتقدات، في الفيلم، يرتبط بقبول الغرب العام للاعتقاد المجتمعي بأن الفلسطينيين هم الضحايا، والاستخدام المكثف للعنف البصري يرتبط بوجود حركة مقاومة منظمة داخل فلسطين. تسبب تشبع وسائل الإعلام بصور لشبان فلسطينيين يرشقون الجنود الإسرائيليين بالحجارة وهم يطلقون أسلحة آلية، تحولاً في الواقعية المفرطة للغرب. وقد سمح الحضور الساحق لهذه الصور للغرب بقبوله، لبعض الوقت، أحد أهم جوانب سردية المحاكاة الفلسطينية: أي، أن الفلسطينيين، وليس الإسرائيليين، هم الضحايا الحقيقيون لهذا الصراع.
ملاحظات
العنوان الأصلي: Palestinian Film: Hyperreality, Narrative, and Ideology
المؤلف:Sarah Frances Hudson
الناشر: University of Arkansas- 2011
…..
هوامش القسم الأول:
Alexander, Livia. “Palestinians in Film: Representing and Being Represented in the Cinematic Struggle for National Identity.” Visual Anthropology. 10(1998): 319-333.
—. “Is There a Palestinian Cinema? The National and Transnational in Palestinian Film Production.” Palestine, Israel, and the Politics of Popular Culture. ed. Rebecca L. Stein and Ted Swedenburg. Durham: Duke University Press, 2005. 150-172.
Baudrillard, Jean. Simulacra and Simulation. Trans. Sheila Faria Glaser. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995.
Brand, Roy. “Identification with Victimhood in Recent Cinema.” Culture, Theory &Critique. 49.2(2008): 165-181.
Bresheeth, Haim. “A Symphony of Absence: Borders and Liminality in Elia Suleiman’s Chronicle of a Disappearance.” Framework. 43.3 (2002): 71-84.
Canticle of the Stones. Dir. Michel Khleifi. Arab Film Distribution, 1990. VHS.
Gertz, Nurith and George Khleifi. Palestinian Cinema: Landscape, Trauma and Memory. Bloomington: Indiana University Press, 2005.
–. “A Chronicle of Palestinian Cinema.” Film in the Middle East and North Africa: Creative Dissidence. Ed. Joseph Gugler. Austin: University of Texas Press, 2011. 187-197.
—. “Palestinian „Roadblock‟ Movies.” Geopolitics. 10(2005): 316-334.
Kennedy, Tim. “Wedding in Galilee (Urs al-jalil).” Film Quarterly. 59.4 (2006): 40-46.
Khleifi, Michel and Livia Alexander. “On the Right to Dream, Love and be Free: An Interview with Michel Khleifi.” Middle East Report. 201 (1996): 31-33.
Mearsheimer, John and Stephen Walt. “The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy.” Middle East Policy 13.3 (2006): 29-87.
Rouhana, Nadim and Daniel Bar-Tal. “Psychological Dynamics of Intractable Ethnonational Conflicts.” American Psychologist 53.7 (1998): 761-770.
Smith, Charles. “The Arab-Israeli Conflict.” Fawcett 231-253.
Telmissany, May. “Displacement and Memory Visual Narratives of al-Shatat in Michel Khleifi’s Films.” Comparative Studies of South Asia, Africa, and the Middle East. 30.1 (2010): 69-84
 Aljarmaq center Aljarmaq center
Aljarmaq center Aljarmaq center