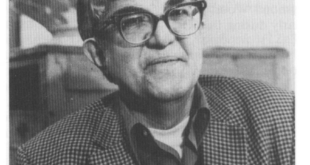تمهيد
لا يكاد يُذكر الجدل الفكري في العالم العربي خلال الألفية الجديدة إلا ويستحضر اسم الراحل فاضل الربيعي كواحدٍ من أبرز مَنْ امتلكوا الشجاعة في إثارة الأسئلة القلقة في وجه السرديات السائدة. وبين مُؤيد له محتفياً لجرأته في تفكيك المرويات التاريخية، ورافضٍ لما عدّه انحيازات واستنتاجات متعجلة، بقي الربيعي صوتاً استثنائياً يصعب تجاهله. إذ لم يكتف بدور الباحث المنقب في النصوص القديمة عن الثغرات، بل قدم مشروعاً “معرفياً” يسائل المسلمات ويقوض الركون “للحكايات الجاهزة”، بل ينطلق نحو فضاءات التأويل والنقد مبتعداً عن طرح الإجابات القاطعة، ليحوَّل إنتاجه المعرفي إلى ورشات متحركة للسؤال وإعادة النظر في ما هو مطروح، وفي ما هو قيد البحث. فعناوينه الجريئة أشبه بمفاتيح تغري القارىء (المتخصص وغير المتخصص) باقتحام أبواب مغلقة في الذاكرة الجمعية، فتتقاطع في نصوصه تأويلات مفردات تاريخية مثل الطعام والجوع والنسب والأسطورة، لتتحول إلى بنى رمزية متحررة من هيمنة التأويل الرسمي، وتنبثق كأسئلة تتجاوز يقين هذا التأويل وتلك السلطة وتعيد تشكيل المعنى، وكيفية الربط الجدلي بين الأنساب والزواج والطعام بصفتها عناصر توليدية في تشكيل المرويات التاريخية والأسطورية وآليات فاعلة في بناء المتخيل الجمعي العربي. فلم تستخدم هذه العناصر كمستندات توثيقية فحسب، بل تحولت إلى أدوات رمزية جرى توظيفها لترسيخ هُويات متعالية وسلطات محددة بعينها ضمن ترتيبات اجتماعية معينة.
لم يكن كتاب “شقيقات قريش”(1) محاولة لإعادة تفسير الوقائع التاريخية من زاوية جديدة فحسب، بل مثّل زحزحة مراكز الثقل الدينية والجغرافية التي رسَّختها القراءات التقليدية في الوعي الجمعي. وتجاوز -في هذه المحاولة- من إعادة البناء السردي للمعنى وتصحيح المرويات، إلى إعادة رسم إحداثيات الخريطة ذاتها، حيث يتحول التاريخ القديم من حيز التأويل المجازي إلى فضاء تعيين مكاني ملموس مثقل بالصراعات، تتقاطع فيه التواريخ بالجغرافيا والأساطير بحدود الوعي، والمرويات بحدود الصراع ذاته، فيتشابك في مشروعه التاريخي بالأسطوري والديني بالسياسي كنوع من تشريح للسلطة التي حولت الأسطورة إلى حدود مكانية، دون اختزالها في المتخيل، ودون فصل نظري بين المقدس والدنيوي، بل تفكك العلاقة بين السلطة والمعنى وبين الذاكرة والجغرافيا. ومن هنا، نفهم قراءته استدعاء جريء لسؤال الشرعية: شرعية التاريخ المكتوب، وأداة سلطوية أنتجت خرائط ذهنية ورثناها كمسلمات، حتى صارت تضاريس المكان نفسها – في وعينا – تشبه نسخة مزيفة من ذاكرة سرقها المنتصرون. وليس مجرد نقض للبعد الرمزي.
ولأن الكاتب انشغل لسنوات عدة بموضوع تاريخ فلسطين القديم، فلم يعد يتعامل مع الجغرافيا العربية كخريطة جامدة، أو محايدة بل كـجسد تاريخي تتنازعه السرديات، ويتناوب عليه التأويل والتأويل المضاد. فانطلق، في قراءته، يُنقّب في طبقات اللغة والتاريخ والتراث المتراكمة، يفكك الموروث العربي القديم فيكشف المدخلات التاريخية التي ترسخت كحقائق (دينية أو ثقافية، أو غيرها) تحمل في جوهرها أصداء السلطة أكثر مما تعبر عن الحقيقة، بما يشبه مكاشفة معرفية (صادمة للبعض أحياناً!) لتقاطعات السرديات الكتابية مع الأنساب العربية، فيتحول النقد -هنا- إلى سلاح مزدوج ذي حدين: يطلق سيل الأسئلة التفكيكية بشأن التفسير التقليدي، ويفتح أبواب التأويل لتفسير الأساطير بعيداً عن قيود “الشرعيات التاريخية” نحو جذورها الاجتماعية والسياسية والثقافية. وبهذه المناسبة، لم يكن التحليل اللغوي -في مشروعه- عملية تتبع جافة لجذور المفردات، بقدر ما كان استعادة لذاكرة لغوية ضائعة في طيات التحولات السياسية والدينية، لكنها محفورة في وعي الجماعات تنعكس فيها صورتها عن ذاتها وماضيها. وتمثلت دينامية إعادة تشكيل هذه التصورات، داخل أطر ثقافية مرنة جديدة، بكسر الطابع الأسطوري لها، بعيداً عن “قدسية الموروث”.
لا يخرج موضوع الكتاب في بنيته ومضمونه، عن معظم إنتاج الربيعي المعروف لجمهور قراءه في حقل التاريخ القديم، ويقدمه المؤلف كموضوع بحث ومشروع ثقافي ونقد “جينالوجي” لما هو مسكوت عنه في ذاكرة المنطقة عن بنية النسب، وطابع السلطة المتجذر فيها، والعلاقة بين البيولوجيا والشرعية الرمزية. كما لا ينفصل العنوان عن أطروحات الكتاب، فـ “الأنساب” و “الزواج” و “الطعام” ليست مجرد مفردات ثقافية، بل ينبغي لها أن تكون إضاءات لما هو منسي من الذاكرة الجمعية القديمة، فهي -بحد ذاتها- مواضيع وبنيات مركزية في الموروث العربي، وعناصر عضوية في تكوين الهوية الثقافية. فيكشف ما يعتبر “حقائق تاريخية” ثابتة ونهائية، ليست سوى تصوّرات اجتماعية أعيد إنتاجها على امتداد الزمن، عملت أو تحولت -بصفتها أدوات فاعلة- على تشكيل هُوية ثقافية متجددة، تتغيّر بتغير الشروط والوقائع، وتعاد صياغتها بما يخدم ترتيبات السلطة والرمز في كل مرحلة.
مدخل شخصي
تستند قراءتي هنا إلى عدة مستويات زمنية وفكرية: المستوى الأول يعود إلى قراءتي “الانطباعية” الأولى، في العام 2002/2003، حين لفتني الطابع الاستفزازي الذي يتسم به خطاب الكتاب، دون أن أمتلك حينها أدوات كافية لتفكيكه أو مساءلته بعمق. أما المستوى الثاني، فيعود إلى العام 2012، وقد تبلور من خلال تفاعلاتي الشخصية مع الكاتب، عبر لقاءات وحوارات مطوّلة، اتسمت أحياناً بالاتفاق، وغالباً بالاختلاف، إلى أن وصلت إلى قطيعة حاسمة في العام 2013. خلال هذه المرحلة، تأثرت قراءتي تأثراً بالغاً بإنتاج الربيعي في مجال تاريخ فلسطين القديم وجغرافية التوراة، وهو ما انعكس على موقفي النقدي الحاد من الكتاب لاحقاً.القراءة الثالثة هي الأحدث، وهي في رأيي الأكثر نضجاً وهدوءَ. جاءت بعد نبأ وفاة فاضل الربيعي (في 29 آذار 2025)، وحملت في طياتها محاولة للعودة إلى الكتاب بمنظور أكثر شمولاً، لا تغلب عليه مواقف شخصية أو انفعالات سابقة، بل يسعى لالتقاط ما في المشروع من طموح معرفي، وما فيه أيضاً من مواطن التباس أو فجوات تأويلية.
لا أستطيع النظر إلى هذا الكتاب كعمل معزول عن مشروع الربيعي الأوسع، ولا ككتاب أكاديمي تقليدي يمكن تقويمه بأدوات محايدة. فقد وجدتني -مع كل قراءة جديدة- أمام عمل يتحرك بين الحفر الأركيولوجي الجريء، والانزلاقات التأويلية الخطرة. وأظن أن قوّة الكتاب تكمن في قدرته على إزعاج القارئ، على خلخلة يقينيات مستقرة، وإن لم يكن ذلك دائماً مدعوماً بأدلة صلبة أو منهجية متماسكة. وهو في هذا يشبه عمل “التفكيك الثقافي” لا من حيث دقة الحجة، بل من حيث تحريضه على إعادة التفكير.
لقد شعرت، مراراً، أن الكتاب يتصرف كأداة شغب داخل الوعي العربي المحافظ؛ يبعثر المسلّمات، لا ليقدّم بديلاً واضحاً، بل ليكشف هشاشة ما اعتُبر صلباً ونهائياً. ولعل ما استفزّني أكثر من أي شيء، هو أن أسئلة الكتاب تتقاطع -بشكل غير مباشر– مع أسئلتي الشخصية حول الهوية والمنفى واللغة والموروث، دون أن تقدّم لها إجابات. بل تركتني أمام مرآة صدئة، أعيد فيها طرح الأسئلة، لا على الكاتب، بل على نفسي.
مقدمة
تشكل إعادة رسم الخارطة التاريخية والمكانية للمنطقة نقطة انطلاق، في مشروع فاضل الربيعي، لفهم جديد لـ”التاريخ” كبنية سردية تنتجها اختيارات رمزية وثقافية وجغرافية، عدا عن كونه سلسلة وقائع موضوعية. وينتمي هذا الفهم إلى محاولة أوسع لإعادة فحص الروايات التي اعتبرت “تاريخاً”، بينما هي، في جوهرها، سرديات أعادت المجتمعات إنتاجها وصياغتها استناداً إلى رؤى وتأويلات متغيرة، حيث تتقاطع النصوص (دينية وغير دينية)، على اختلاف مصادرها، مع طبقات الجغرافيا القديمة والحديثة، في محاولة لفهم الكيفية التي يتداخل بها الشرق المعاصر مع الشرق القديم في البنى الذهنية والثقافية التي تنتجها المجتمعات وتعيد إنتاجها، وليس على صعيد الجغرافيا فقط. ولذلك لا يبدو مستغرباً ربطه بين “قريش” و”إسرءيل” حين يتناول سرديات “الطرد، والترحال، والشتات”، عبر العصور، بوصفها سرديات تأسيسية، أعادت تشكيل الذاكرة والأسطورة عبر العصور. ومن هنا تأتي دعوة الكتاب إلى التفكيك أركيولوجي لهذه البنى السردية، وكشف الطبقات المهملة أو المقموعة المتراكمة عبر الزمن. واقتراح قراءة الأنساب كأنساق دلالية مشبعة بتوظيفات ثقافية واجتماعية، أعيد تشكيلها في محطات مختلفة لتخدم مصالح فئات اجتماعية فاعلة. وعليه، تصبح إعادة القراءة النقدية ضرورة منهجية، لفهم التحولات العميقة التي طالت الوعي الجمعي، -خصوصاً- ما يتعلق بتمثلات المجتمعات لذواتها ولأصولها، ولعلاقتها بالآخر. فالتفكيك، هنا، ليس نقضاً أو دحضاً، بل عملية استقصاء يسائل “جينالوجيا” السلطة الكامنة في قلب الموروث(2). بما في ذلك من تفكيك الخطاب السردي الذي منح المشروعية للسلطة عبر الزمن، فالفكرة المركزية التي يلمّح إليها التحليل النهائي للكتاب تشير إلى أن الأنساب، والزواج، والطعام لم تكن مجرد ممارسات اجتماعية، بل تحولت إلى أدوات رمزية لإنتاج الهُويات، وتثبيت الهرمية الاجتماعية، وتبرير مراكز النفوذ.
تمهيد منهجي: الجغرافيا بوصفها مدخلاً لتفكيك السرديات التأسيسية
لم تعد قراءة النصوص الدينية والأسطورية رهينة التفسير الرمزي أو اللاهوتي، بل تحوّلت إلى ميدان جدلي تتقاطع فيه المعرفة والنقد والتأويل التاريخي. ويقدم الكتاب أطروحة منهجية مغايرة، ترتكز على الجغرافيا بوصفها أداة تحليلية لفك البنية المغلقة للنصوص التأسيسية لإعادة ترتيب عناصر النص عبر تفكيك الخرائط الذهنية والجغرافية التي صاغت المعنى التاريخي والديني لها، دون الاكتفاء بالتفسير الرمزي، فينطلق من فرضية محورية مفادها أن الموقع الجغرافي للأحداث كما هو معتمد في الروايات التقليدية، ليس سوى نتاج إسقاطات لاحقة، أُعيد فيها بناء “المقدّس” على نحو يخدم سلطة سياسية أو دينية بعينها، فتتحول الجغرافيا من خلفية محايدة إلى أداة كشف، وإعادة توظيف أدوات المقارنة الأسطورية، والنقد التاريخي، والمعجم اللغوي، وتحليل النقوش، وتشابه الأسماء بين المواقع، لاقتراح سردية بديلة تستعيد الفضاء العربي كحاضنة أولى لتلك الوقائع.
اللافت في هذه المقاربة أنها لا ننشغل في البنى الرمزية أو الوظائف النفسية للأسطورة -كما تفعل دراسات المدرسة الرمزية-، بل تتخذ مسافة منهجية واضحة منها، وتركّز على إعادة موضعة الأسطورة في سياقها الجغرافي-اللغوي الأصلي. فالهدف ليس تفسير اللاوعي الجمعي، بل قراءة النص قراءة مادية تُزعزع يقين الخرائط الراسخة وتكشف عن التواطؤ التاريخي في صناعتها. وتتميز قراءة الكتاب بمحاولة تفكيك النسق المكاني السائد عبر ما يمكن تسميته بـ”الجينالوجيا الجغرافية للمقدّس”، حيث تصبح الخريطة ساحة صراع رمزي مبتعدة قدر ما تستطيع عن التوصيف المحض للأمكنة. غير أن اعتماد الربيعي المفرط على مفهوم “الانزياح اللغوي” يظل نقطة إشكالية في مشروعه، إذ يُوظّف أحيانًا كدليل تأويلي وحيد دون إسناد مادي كافٍ، ولكن ما يحسب له فهمه للجغرافيا كمنظومة دلالية فاعلة في إنتاج التاريخ مما يعيد طرح سؤال التأسيس من زاوية تداخل البيئة والسرد، بعيداً عن قضايا الإيمان بحقيقة تاريخية مغلقة، وبعيداً عن اعتبارات الجغرافيا كعلم للمواضع والأماكن. فتبرز، أي الجغرافيا، بصفتها ساحة صراع على التمثيل التاريخي، وتقدم تصوراً مغايراً لتاريخ الشرق القديم، كمقدمة لتجاوز المركزية الاستشراقية واقتراح قراءة تنبثق من الواقع اللغوي والبيئي العربي، علماً أن السعي لإعادة تشكيل هذا الواقع كمنتج ثقافي خاضع لصراعات الذاكرة والسلطة لا يتوقف عند طرح أسئلة على التراث الجغرافي والديني فقط.
لكن هذا الطرح، رغم جرأته، يثير تساؤلات معرفية ومنهجية تتعلق بحدود الاشتقاق اللغوي وبمصداقية القرائن الظرفية. فإلى أي مدى يمكن لتشابه الأسماء تأسيس سردية تاريخية متماسكة؟ وهل يمثل دليلاً كافياً أم أنه مجرد انزياح لغوي؟ وهل يمكن للأدلة غير المباشرة وحدها إعادة ترسيم جغرافيا النص، أم يستلزم الأمر مراكمة قرائن مادية، تتجاوز المقارنات الرمزية واللغوية؟
يبقى التحدي في التمييز بين القرائن الظرفية (كالاشتقاق اللغوي) والأدلة المكانية (كالنقوش واللقى الأثرية)، وفي تحديد ما يكفي منها لتبرير إعادة رسم خرائط النصوص، سواء كانت مقدسة أو غير ذلك. وتبدو الأمثلة التي يقدمها الكتاب مشروطة بتوثيق زمني دقيق، وبضرورة اعتماد معايير إثبات صارمة تتجاوز المقارنة الأسطورية وحدها. فلا يكفي الاستدلال بتشابه الأسماء أو المفردات، دون دعم تقدمه معطيات مادية، مثل حركة الهجرات، أو التحولات المناخية قابلة للرصد والتحري.
من هذا المنطلق، يُقدَّم الربيعي كتابه كمحاولة لتفكيك البُنى الرمزية وإعادة تشكيل الهُوية، بما يتجاوز التصورات التقليدية للقبيلة (كيان مغلق ومنعزل)، وإعادة غرسها في شبكة العلاقات الرمزية التي تربط الجماعات ببعضها عبر أنساق الجغرافيا الاجتماعية، والوشائج اللغوية والثقافية في نسيج متماسك يعيد تعريف الانتماء بمعزل عن الثنائيات الجامدة: (داخل/خارج، أصيل/دخيل). ولا يقتصر هذا التصور على علاقات النسب البيولوجي، بل يتوسّع ليشمل التماثلات الرمزية والدلالية بين الأسماء، والأنساب، والأمكنة، من خلال مقاربة أنثروبولوجية تفكيكية تعتمد تحليلاً لغوياً دقيقاً. فيكون تحليل المفردات-أسماء الأشخاص، والأماكن، والأطعمة، والطقوس- مدخلاً لكشف البنية الرمزية للتاريخ غير المكتوب، عبر تحليل الرموز والأساطير التي ترتبط بالأنساب، والطعام، والزواج، والمجاعة، فتُقرأ هذه العناصر كتمثيلات رمزية لتحولات في توازنات السلطة وبنية المجتمع، في ظل أزمات مناخية أو اقتصادية. فاللغة، بما تختزنه من طبقات دلالية وتحوّلات صوتية، تتيح استنطاق التراكمات الثقافية والدينية التي غالباً ما تسقط في السرديات الرسمية.
بهذا المعنى، يقترب منهج الكتاب من الفيلولوجيا التاريخية، إذ يُعامل المفردة كوعاءً للذاكرة الجماعية، ومرآةً لتصورات المجتمع عن ذاته والآخر. ويمثّل هذا التوجه جزءً من مشروع أوسع لتفكيك الرواية التاريخية السائدة من هوامشها تشكّل -في قراءته- مفاتيح لتأويل البُنى العميقة للصراع الرمزي والاجتماعي، أي من المجاعات، الصراع على الكلأ والرعي، تحوّلات الزواج، وشبكات النسب، التي طالما عُرضت كوقائع ثانوية أو “فولكلورية”. كما تستعير المقاربة أدوات التحليل البنيوي، لإعادة تأويل البنية الرمزية للهويات العربية، ومساءلة الرواية التأسيسية المهيمنة، عبر أدوات لغوية وثقافية وأنثروبولوجية متداخلة، دون التقيد بإعادة إنتاجه حرفياً، إذ تعيد توظيفه داخل سياق عربي محلي: فـ”مائدة الطعام” تصبح حلبة لصراع رمزي على النسب والشرعية، و”أنماط الزواج” تتحول إلى مؤشرات على تبدلات في البنية القبلية، و”سنوات الجوع” تُستخدم كعلامات لإعادة ترسيم الحدود بين الجماعات المتنازعة. كما أن الأسطورة، في هذا السياق، لا تُعد نقيضاً للحقيقة، بل تشكّل صيغة موازية لها، تنقل منطق الجماعة وتموضعها في العالم، وتُعيد تنظيم الوقائع في إطار تعبيري يخدم أغراضًا دينية واجتماعية بعينها. وهكذا تنقلب المفاهيم السائدة،
فلا يُنظر إلى النسب كوثيقة محايدة، بل كخطاب سياسي، وتتفكّك كما تتفكّك الأسطورة لفهم وظيفتها. ويتحوّل التاريخ، في هذا الإطار، من سردية مغلقة إلى مجال مفتوح للتأويل، ومن وثيقة إلى فضاء للتخيّل الرمزي. وهنا لا يطرح الكتاب سؤال “الصحة” التاريخية بقدر ما يطرح سؤال المنهج:
كيف يمكننا ابتكار أدوات تحليل تُدمج اللغة بالأرض، والذاكرة بالأنساق الرمزية، من أجل كتابة سردية تُنصت للهامش، وتؤسس معرفة تحرّر الهوية من سجن المرجعيات التأسيسية؟
إن “شقيقات قريش” ليس كتاباً تاريخياً تقليدياً، بل بياناً منهجياً يطمح إلى إعادة قراءة التاريخ العربي كنصّ ثقافي مفتوح، ويقترح أدوات نقدية قادرة على مساءلة الموروث، وتفكيكه، دون الوقوع في شرك التبعية المعرفية أو القطيعة الجذرية.
تفكيك السرديات التأسيسية التاريخية
يقدم الكتاب تصوراً جذرياً للهُويات يتعارض مع السرديات القومية المهيمنة في المنطقة (العربية والكردية والصهيونية- اليهودية والفينيقية والسريانية والقبطية، أو الأمازيغية بدرجات متفاوتة) الساعية إلى تثبيت هُويات “فرعية” تاريخية، استناداً إلى أسس أحادية وسرديات متجانسة ظاهرياً تعزّز الإقصاء والتجزئة، تنبني على أدلة تاريخية مُتحيزة أو مُشوهة، تُحول الهُوية من بناء اجتماعي ديناميكي إلى كيان ثابت لتبرير المطالب السياسية حول الأرض والانتماء. ولكن لهُوية ليست “ميراثاً مطلقاً”، بل سياق تفاوضي يتشكَّل بالتفاعل المستمر مع الشروط السياسية والاقتصادية والثقافية المحيطة، ولا يمكن حصرها في سرديات الحتمية أو الأصول الواحدة. وتظهر السرديات الكبرى تماثلاً بنيوياً بين الحلقات التاريخية المفصلية، مثل “خروج بني إسرائيل من مصر”، و “إيلاف قريش”، وشتات اليمن بعد “سيل العرم”، والرحلة الهلالية، وطرد عرب الأندلس، ونكبة فلسطين… وغيرها، وبين الأساطير المؤسسة القديمة (كـ “الخروجِ من جنة عدن”، والطوفان الكبير، ورحلة غلغامش). فهي جميعاً بنى سردية يعاد صياغتها وفقاً لحاجات السلطة المهيمنة. فعلى سبيل المثال، لا ينظر إلى “التوراة” كنص ديني فقط، بل كسردية قَبَلية عربية قديمة يعاد قراءتها كمرآة لتاريخ اليمن وجنوب جزيرة العرب، حيث تتحول أحداثها إلى انعكاس لرؤية قبيلة “إسرءيل” المهيمنة. وبالمثل، يعيد التاريخ العربي الذي كتب في العصر العباسي إنتاج سردية “قريش” كمركز قَبَلي ثقافي وسياسي.
يحفل الكتاب بمثل هذه الطروحات النقدية التي تشبه في كثير من جوانبها حقل الدراسات الأنثروبولوجية الثقافية، فلا ينظر إلى الهُويات والأنساب التقليدية كحقائق ثابتة، بل يعمل على خلخلة أسسها كظواهر تاريخية قابلة للتشكيل. كما يسلط الضوء على كيفية تحويل السلطة، بمؤسساتها الدينية والسياسية، الأنساب من سجلات قَبَلية إلى خطابات شرعية تُكرّس الهيمنة. وتبدو مقاربة الربيعي للتاريخ العربي المبكر امتداداً للمنهج التفكيكي، لكنها تذهب أبعد من مجرد تحليل الخطاب، إذ تدمجه بالأنثروبولوجيا الثقافية لتقديم قراءة جذرية لهُويات المنطقة وسردياتها. فبدلاً من المقارنة الرمزية العابرة للثقافات التي استخدمها كامبل(3) وبرتشارد(4) للكشف عن التماثلات بين الأساطير، يعيد الربيعي توجيه هذه الأدوات نحو تفكيك مركزية السردية التوراتية التي شكلت الإطار الذهني المسيطر على تأويل تاريخ الشرق القديم، ويعيد توطين الأحداث ضمن جغرافية الذاكرة العربية في قراءة داخلية لتاريخ الشرقِ ليميط اللثام عن طبقات من النسيان والتأويل السياسي .
كما يمثل هذا الانزياح “الراديكالي” ابتعاداً عن منهج كلود ليفي شتراوس، الذي عالج الأسطورة كنظام مغلق يعكس البنى الذهنية للجماعة، في نظر إليه الربيعي كـساحة صراع مفتوحة، تنتج فيها الجماعات رموزها لتكريس الهيمنة أو مقاومتها. فالزواج والطعام، ليسا مجرد طقوس ثقافية، بل أدوات لرسم الحدود السياسية بين النقي والمدنّس، المحلي والغريب، الداخل والخارج، تماماً كما تحدد الأنساب بصفتها خريطة سياسية تسجل فيها انتصارات القبائل وهزائمها – عبر سرديات الانتماء والقرابة – من يحق له امتلاك الأرض أو الشرعية الدينية.
يتعدى الربيعي، ضمن هواجس مشروعه المتعددة، النقد التاريخي إلى تفكيك شرعية الخطاب الديني-السياسي الذي حوَّل السردية التوراتية إلى “تاريخ مقدس” للمنطقة. فيفكك هذا الخطاب بأدوات تحليل لغوي-أركيولوجي للمفردات والرموز ليكشف طبقات من التوظيف السياسي، على سبيل المثال: كيف أصبحت “قريش” مركزاً دينياً بعد أن كانت حلفاً قبَلياً؟ وكيف تحوَّلت رحلة إبراهيم إلى مكة من أسطورة محلية إلى سردية كونية؟ وتتبدى في مثل هذه الأسئلة رؤيته للتاريخ كحقل صراعٍ على تمثيل الذاكرة، أكثر منه سرد تسلسلي للأحداث. وتمثل هذه القراءة تركيباً منهجياً يجمع بين الأنثروبولوجيا البنيوية ونقد الخطاب ما بعد الكولونيالي، بيد أنه يمنح الأولوية للسياق المحلي، باعتباره مفتاح فهم نشأة السرديات الكبرى. فهو لا يكتفي بكشف آليات إنتاجها، بل يتعقب تحولاتها عبر الزمن، محاولاً معرفة كيف تحول “الشتات” (من اليمن إلى فلسطين) إلى أداة لصناعة هُوية جماعية مضادة؟ وكيف جرى توظيف “رحلات التيه” القديمة إلى سرديات تبرر الهجرة القسرية الحديثة؟ بما يعني إعادة تشكيل الوعي التاريخي العربي بعيداً عن الثنائيات الاستشراقية التي حبست الشرق في فلك البدائي/المتحضّر، الشرقي/الغربي.
ورغم قوة مشروعه النقدية وإسهامه النوعي في هذا الصدد عبر اقتراح مسارات بديلة، يظل سؤال المنهج مطروحاً بإلحاح:
هل تفتح قراءة الربيعي التفكيكية أفقاً معرفياً بديلاً متماسكاً للسرديات المهيمنة، قادراً على البناء، أم أنها تكتفي بتقويض السرديات المهيمنة دون طرح سردية بديلة؟
تكمن أهمية هذا السؤال في أنه لا يختبر فقط صلابة أطروحة الربيعي، بل يحدّد كذلك ما إذا كان مشروعه قابلاً للاستمرار، أم سيبقى لحظة تفكيك عابرة داخل خطاب لم يكتمل بعد. وهذا ما يضع أهل الاختصاص أمام تحدي استكمال مشروعه النقدي.
اللغة كمفتاح لفهم التاريخ
اللغة وسيلة تواصل، أو نظام علامات تحفظ الثقافة وتضم في بنيتها آثاراً متراكمة لتحولات اجتماعية وسياسية عميقة. يفتح هذا التصور أفقاً مهماً لفهم المجتمعات والثقافات القديمة، من خلال استنطاق اللغة باعتبارها وعاءً للذاكرة الجمعية، فالكلمات تشبه حفريات لغوية تحمل في دلالاتها المتغيرة شواهد على الصراعات وتشكل الهُويات، فكلمة “قريش” لا يقتصر معناها، على سبيل المثال، على دلالتها القبَلية، بل تصبح نصاً مصغراً قابلاً للتفكيك لكشف التحولات من حلف قبلي إلى رمز مقدس. وتفترض مثل هذه القراءات عدم حيادية الكلمات لاحتوائها على ترسّبات الذاكرة الجماعية، وتعمل كمؤشرات على التغيّر السياسي والديني في سياقها التاريخي. غير أنها، رغم أهميتها، قد يصيبها الضعف حين يجري فصلها عن السياقات المادية والآثار المحسوسة، خاصة عندما تُبنى الفرضيات اللغوية بمعزل عن الشواهد الأثرية أو الوثائقية. وسوف تتخذ “اللغة” موقعاً مركزياً في الكتاب، باعتبارها مستنبتاً للخبرة التاريخية ومفتاحاً لفهم التحولات العميقة التي طرأت على وعي الجماعات، فمفردات اللغة تشفّر في بنيتها مسارات التغيير في الذاكرة الجمعية، وتُحيل إلى وقائع تاريخية عميقة، كثير منها لم يُوثَّق في السجلات الرسمية، ومن هنا يتخذ الكتاب منها موقفاً نقدياً حاداً، معتمداً مقاربة تحليلية تُذكّر ببعض المستشرقين النقديين الذين أعادوا قراءة النصوص التوراتية والتراثية عبر أدوات المقارنة والتفكيك البنيوي (5). غير أنه يتخطى هذا المسار المقارن، ويذهب إلى إعادة رسم الجغرافيا الرمزية للأحداث، مستنداً إلى فرضيات لغوية وتاريخية تهدف إلى إعادة توطين السرديات الكبرى داخل المجال العربي.
فاللغة، كما يؤكد الربيعي، مفتاحاً حاسماً في فهم التاريخ، لكنها لا تُغني عن المفاتيح الأخرى، مثل الآثار والوثائق والوقائع المادية. ومتى توافرت هذه الأدوات جميعها، يصبح من الممكن قراءة التاريخ العربي كما تختزنه اللغة وتلمّح إليه الجغرافيا الاجتماعية. ومن خلال هذه المقاربة اللغوية -التاريخية الاجتماعية يتخذ الربيعي من اللغة أداة مركزية لاستنطاق التاريخ غير المدون، فيعيد تحليل المفردات والمصطلحات بوصفها انعكاسات لتحولات اجتماعية طمست أو أعيد إنتاجها في السرديات الرسمية. ولا يتوقف عند المعنى القاموسي للكلمات، بل يتتبّع جذورها وانزياحاتها التاريخية وتحوّلات الألفاظ، ليكشف عن بنى اجتماعية وثقافية اندثرت أو أُعيد تشكيلها، ما يتيح قراءة بديلة للتاريخ تتجاوز السرديات الكبرى التي كرّستها المؤسسات الرسمية، ليعيد بناء العلاقة بين الكلمة والواقعة للكشف عن السياقات الأصلية التي وُلدت فيها المفردات، وليس تلك التي ترسبت لاحقاً في الذاكرة الجمعية.
تمنحه هذه المقاربة، التي تمزج بين التحليل اللغوي والتاريخ الاجتماعي، أداة تحليل مزدوجة: فمن جهة تُفكك الرواية الرسمية عبر تحليل البنى اللغوية المتماسكة، ومن جهة أخرى، تعيد تأويل المفاهيم وفق أصولها الاجتماعية والثقافية، بما يعزّز الطابع الجدلي والإشكالي لمشروعه النقدي. كما أنها تدشن، أفقاً غير مألوف لفهم التكوين الثقافي للعرب، خصوصاً في مرحلة ما قبل الإسلام. وهي، من جهة، مساهمة مبتكرة في إعادة التفكير بعلاقة اللغة بالواقع الاجتماعي، لكنها، من جهة أخرى، تفتقر، ربما، إلى القوة الإثباتية المطلوبة إذا لم تُدعَم بالأدلة المادية—من وثائق، أو نقوش، أو بقايا أثرية. فاللغة قد تحتفظ بآثار من ذاكرة الجماعة، وتُلمّح إلى أنماط عيشها وصراعاتها، لكن الإفراط في تحميلها دلالات حاسمة دون قرائن مادية، قد يحوّل القراءة إلى تمرين تأويلي أكثر منه اكتشافاً معرفياً. وهنا تبرز الحاجة إلى تكامل المنهج اللغوي مع أدوات التأريخ التقليدية لتعزيز صدقية المشروع وتوسيع أفقه.
وحين تتعين اللغة بصفتها أرشيفاً للتاريخ غير المكتوب، لا تعود وسيلة تواصل فقط، بل سجل ثقافي حيّ يختزن طبقات من المعاني والتجارب والتواريخ المنسيّة، يستخرج منها دلائل على أحداث كبرى طمرها الزمن، مثل المجاعات التي ضربت المجتمعات القديمة وأثّرت في بنيتها الاجتماعية ومخيالها الديني، من خلال تحوّل أسماء شخصيات تاريخية أو طبيعية إلى رموز أسطورية وآلهة. فالتاريخ اللغوي للكلمات يعطيها أهمية مركزية للألفاظ بدلالتها الاجتماعية مشحونة بذاكرة الجماعة، وهي هنا ليست مفردات محايدة أو جامدة، بل هي في أصلها توصيفات اجتماعية أو انعكاسات لنمط حياة معين تحولت مع الزمن إلى سجل حي للثقافات القديمة، وتتحول القراءة المغايرة لـ “تاريخ” الكلمة من مجرد بحث في المعنى إلى محاولة لفكّ شيفرات حضارية دفنتها الأجيال المتعاقبة، فلا تكتفي اللغة هنا بنقل المعنى، بل تختزن في بنائها الدلالي البذور الأولى لتشكّل الهُوية، والصراعات، والتحولات الكبرى التي عرفتها المجتمعات العربية القديمة.
حفريات اللغة والتاريخ الاجتماعي
ينطلق الكتاب من فرضية معرفية تعيد تعريف المهمة التاريخية ذاتها، فلا يمكن إنجاز فهم التحوّلات الاجتماعية من خلال الوثائق الرسمية أو السرديات السلطوية وحدها، بل يقتضي الغوص في الذاكرة اللغوية للجماعات، باعتبارها مستودعاً خفياً للمعرفة التاريخية. ويُوجّه في هذا السياق نقداً صريحاً لمنهجيات البحث التقليدية التي أغفلت هذا الجانب، مؤكّداً أن خبرات القبائل العربية، وذكرياتها الجمعية، وكوارثها المفصلية، بقيت في الغالب خارج التوثيق المؤسسي، ولم تُلتقط من قبل المؤرخين الكلاسيكيين.
ويستند الربيعي إلى فرضية مركزية مؤداها أن اللغة لا تُستخدم للتعبير عن المعاني فحسب، بل تحفظ أيضاً ذاكرة الجماعة ومفاتيح تحولاتها الكبرى. فالتحليل المعجمي للمفردات القديمة، ورصد وانزياحاتها الدلالية، يُمكنه الكشف عن تاريخ خفي لم يُدوَّن، لكنه تسلل إلى النصوص الشفوية والأساطير والمرويات الأدبية، التي لا يجوز التعامل معها بصفتها خرافات أو رموزاً ميثولوجية عابرة، بل ينبغي قراءتها كمصادر معرفية قادرة على تفكيك المفاهيم السائدة، وإعادة بناء البنية الرمزية لتاريخ الجماعات العربية القديمة.
بهذا المعنى، يتعامل الربيعي مع الذاكرة اللغوية بوصفها أرشيفاً موازياً، لا يقل أهمية عن الوثيقة النصّية، بل يتفوّق عليها في بعض الأحيان، خاصة عندما يتعلق الأمر برصد التحولات العميقة التي عصفت بالبُنى الاجتماعية والاقتصادية في الجزيرة العربية، نتيجة الكوارث البيئية الكبرى، كالمجاعات أو التصحر أو تحوّل خطوط التجارة. ويعود إلى أزمنة سحيقة يستنطق فيها المرويات التوراتية، والأساطير العربية السابقة للإسلام، ليتتبع آثار مفاهيم مهيمنة مثل: قصص إبراهيم، وإسماعيل، وداود، والعماليق، وهاشم، بوصفه الجد الأعلى لقريش.
ويركّز بشكل خاص على سلسلة “المجاعات الكبرى”، التي أنتجت هجرات وتحولات اجتماعية واقتصادية، تجسّدت في النصوص كوقائع معيشة ولغوية. إذ تحوّلت بعض المفردات، التي كانت تشير في أصلها لظواهر مناخية أو أزمات غذائية، إلى أسماء آلهة، أو أجداد أسطوريين، أو رموز دينية، ما يجعل من تحليل دلالات الألفاظ مدخلاً لا غنى عنه لفهم البنية العميقة للهوية الجمعية، ومفتاحاً لإعادة تأريخ الحوادث الكبرى خارج الترتيب الزمنـي الذي فرضته السرديات التوراتية، أو الإسلامية اللاحقة. وفي هذا الإطار، يولي أهمية مركزية لتحليل التحولات الدلالية في المفردات: فالإله قد يكون، في أصله، رمزاً لمورد طبيعي، والجدّ القبلي قد يرمز إلى طبقة اجتماعية أو موقع وظيفي داخل البنية القبلية. وهذا النمط من التحليل يتطلب حفراً لغوياً دقيقاً في الذاكرة الثقافية العربية، وينأى عن اختزال النصوص إلى بعدها اللاهوتي أو في إطار التلقي الديني المحض.
من ناحية أخرى لم يتعامل فاضل الربيعي مع الأسطورة بوصفها وهماً أو انعكاساً لوعي بدائي، بل قرأها كمستودع رمزيّ كثيف، يختزن في بنيته اللغوية والاجتماعية خبرات الشعوب وتحولاتها العميقة. فهو لا يقدّمها بديلاً عن الوثيقة التاريخية، وإنما كنص موازٍ، وربما أسبق من حيث التكوين الزمني والدلالة. فالأسطورة تمثل شكلاً من أشكال الذاكرة الجمعية، تعمل على ترميز الصدمات الكبرى، مثل المجاعات والتهجير والحروب والكوارث المناخية، ضمن بنى رمزية يمكن استنطاقها وفكّ شفراتها. فهي ليست خرافة إذن، بل لغة الجماعة حين تعيد شرح أسباب نجاتها أو فنائها، تماسكها أو انهيارها. ووسيلة لفهم المصير الجماعي عبر الرمز. وتأويل هذه الأساطير عبر أدوات لغوية وأنثروبولوجية سيعيد تركيب المشهد التاريخي الأصلي، ويكشف عن أنماط للوعي السياسي والاقتصادي ظلّت مهمشة أو غير مقروءة في السرديات الرسمية.
يحوّل الربيعي الاشتغال على اللغة من مجرد تأويل نظري إلى أداة تحليلية تكشف عن أنساق المعيش اليومي، مثل: نظم الطعام، وشبكات القرابة والعلاقات الاجتماعية والتحولات الاقتصادية. فالمفردة ليست بنية لغوية معزولة، بل “كيان” رمزي يجسد العالم الاجتماعي، ويؤرشفه، ويتيح تحليلها مدخلاً لفهم التاريخ غير المكتوب، ذاك الذي لا يظهر في السجلات، ولا تحفظه الوثائق، بل يُستعاد استحضاره من بقايا وهوامش اليومي والمهمّش والمسكوت عنه. وبهذا المعنى، تحتل الأسطورة مكانة مركزية في مشروع الربيعي كوثائق رمزية مشفّرة، يتطلب فهمها تفكيك بنيتها اللغوية والرمزية. وهي محاولة جريئة لتجاوز الانقسام التقليدي بين التاريخ والعقيدة، وبين الوثيقة والخيال، عبر تأسيس منهجية مزدوجة تعتمد على التأويل اللغوي والتحليل الاجتماعي معاً.
ويستعرض في إطار هذه الذاكرة الجماعية حول دور المجاعات والهجرات في تشكيل الأنساب، أسماء بعض القبال العربية، وصلة بعض الأسماء بمائدة الطعام وطقوس العبادة، والربط بين الأسماء وظروفها الاجتماعية والاقتصادية، حيث تشكل مرآة للبيئة والذاكرة الجمعية. فاسم “جديس”، على سبيل المثال، يُشير إلى جماعة نزحت من اليمن بفعل المجاعة، ولا يقتصر الاسم على الدلالة قبلية، بل يرى أن معناه اللغوي الأصلي يتضمن النفي من الأرض والاندثار، أو الاستبعاد، أي “ما ليس من الأرض”. (يرد في المعجم “ج د س” بالفتح لجميع الحروف. ويقال جَدَسَ الأَثَرُ: دَرَسَ. وجَدَسَ الشَّيْءُ: يَبِسَ واشْتَدَّ. وجَدَسَت الأَرضُ: بَارَتْ فَلَمْ تُعْمَر بزرع، أَو غَرْس فهي جَادسٌ، وجادِسَةٌ والجمع : جَوَادِس). هذا الانزياح الدلالي يحمّل الكلمة أبعاداً وجودية، فـ”جديس” تُشير، وفق هذا الفهم، إلى جماعة منفية، مقطوعة الصلة بأرضها الأصلية، وتعيش في ظلّ فقدان وجودي لمكانها الأول.
أما “قريش”، فيستعرض اشتقاقاتها المتعددة بوصفها مداخل لفهم تعقيدات الهوية الجمعية، فيعرض تأويلات ربط الاسم بـ بـ”السمكة العظيمة” التي كانت تُعبد قديماً، أو “التقرّش”، أي التجمّع حول المال والتجارة، وهو لا ينتصر لتأويل بعينه، بل يعتبر أن قيمة الاسم تكمن في تعدد معانيه، فهو يحتفظ في بنيته اللغوية ببقايا دلالية تربط بين العبادة، والشدائد، والمجاعات، مما يجعله حاملاً لطبقات من الذاكرة تتقاطع فيها العوامل الاقتصادية والدينية معاً. بهذا المعنى، تتحول الكلمة إلى طبقة قابلة للحفر في الوعي فقدان الأرض تُختزن فيها الكوارث، والطقوس، والتحولات، تماماً كما تحتفظ الأرض في طبقاتها ببقايا العصور السابقة. يسلّط هذا المنهج الضوء على التعددية الدلالية داخل الكلمة الواحدة، ويقوّض بذلك سلطة التفسير الأحادي. فالفهم التاريخي، عند الربيعي، لا يتحقّق إلا عبر تفكيك المعنى المتراكم، والاعتراف بأن اللغة تحجب بقدر ما تكشف، وتُلمّح بقدر ما تُصرّح.
كما يقدم اسم “عوص” كنموذج دال على تحول الدلالة البيئية (الجفاف والمجاعة) إلى رمزية اجتماعية تعبر عن الصمود والفخر. فالكلمة، التي ارتبط معناها في الأصل بالجدب والمجاعة، تحمل اشتقاقاتها اللاحقة إشارات إلى القدرة على التحمل وتحدي القسوة، على نحو ما تفعله نباتات الصحراء التي تنمو فقر التربة وقسوة المناخ. وهكذا تتحول المعاناة إلى سردية للفخر والشرعية، ولا يمثل هذا التحول انزياحاً لغوياً فحسب، بل استراتيجية ثقافية تعيد إنتاج الكارثة كرافعة للهُوية. ، حيث يصير “عوص” -بحسب بعض روايات النسابين- “جداً أعلى” لبعض القبائل، بصفته شخصية رمزية تمجد مرونة القبيلة وصبرها على الجوع والجفاف وغير ذلك من الكوارث الطبيعية.
كما يرتبط اسم “آكل المرار” بتناول ثمرة المر. ليصبح الاسم بحد ذاته استعارة رمزية تعكس تحوّل الطعم المر الكريه إلى دلالة على التحمل والصبر. فالمرار الذي كان يستخدم في البداية للإشارة إلى المذاق السيء، صار يستثمر رمزياً ليعبر عن القوة، وليجسد بين الذائقة والصبر في المخيال الجمعي، ويكشف هذا التحول عن آلية “تسليع الرمزية اللغوية”، إذ يعاد توظيف الكلمة لخدمة أهداف التماسك الاجتماعي، حتى إن الاسم ذاته صار يطلق لاحقاً على نوع من الحجر الصلب هو “المرمر”.
ويمكن، ضمن هذا البعد الرمزي، قراءة أسطورة “امرؤ القيس”، كصراع بين الطعام الرديء (أي قيم التهميش والتسوية مع الفقر كاستراتيجية للبقاء)، والطعام الجيد (رمز النخبة والرفض). هذه القراءة التفكيكية، التي تزاوج بين دراسة الأسماء والأنساب وبين اقتصاد العشيرة والأنثروبولوجيا الوظيفية(5)، فأمرؤ القيس ضمن هذا المنظور يمثل “البطل الحقيقي” الرافض للتسوية مع الواقع المتدني (يتمثل هنا في الطعام الرديء)، في مقابل العبد “البطل المزيّف” الذي يرضى ويستسلم للواقع المؤلم كضرورة بيئية دون اعتراض. ويتحول الطعام إلى مقياس رمزي للهُوية بين من يسعى إلى التحرر والتغيير ومن يتماهى مع الإذلال ويضفي عليه شرعية رمزية. وثمة طقس غذائي استثنائي بعض الشيء، يتجسد في طهي الدم أو شربه، كممارسة طارئة على هامش الجفاف والمجاعة، حين كان المهاجرون يشربون دماء الطرائد بديلاً عن الماء. وينطلق من هذه الملاحظة لتقديم قراءة مغايرة للآية}حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ{، [المائدة: 3]، مشيراً إلى أن الدم المحرم هنا هو دم الطرائد ذاك الذي يشرب عمداً وليس الأثر المتبقي في الذبائح، ويفسر هذا التحريم في ضوء السياق الثقافي والبيئي لتلك المرحلة، بوصفه رداً ثقافيا على أزمة الموارد، وليس مجرد حكم فقهي تقليدي معزول. وهكذا يصير الدم علامة على ذروة الفاقة، واستجابة تشريعية لما يكشفه الجوع من طبقات المعنى، فـ”قدسية الجوع” هنا تمثل عنصراً مركزياً في تشكل الطقوس والمعتقدات في الثقافات القديمة.
تمثل هذه النظرة قراءة نوعية عميقة في دلالات الأسماء والأنساب العربية، وتعدّ إسهاماً لافتاً في ربط التحليل اللغوي بالأنثروبولوجيا الثقافية، عبر تتبع الأثر الذي تتركه الكوارث البيئية (كالمجاعات) في تشكيل السرديات التأسيسية. إذ لا يقتصر التحول الدلالي للأسماء من معاني القحط إلى رموز الصمود على كونه ظاهرة لغوية، بل يُفهم في سياقه بوصفه استراتيجية ثقافية تُعيد توظيف المعاناة لصناعة الشرعية وتعزيز التماسك الجماعي، كما أشرنا سابقاً.
يقدم هذا المنهج بُعداً جديداً في فهم التاريخ العربي القديم، من خلال تتبع تحولات المعنى عبر الزمن، بما يتوافق مع أطر علم اللغة التاريخي، خصوصاً في ما يتصل بمفهوم الانزياح الدلالي(6) في اللسانيات. غير أن هذا الطرح، على وجاهته، يواجه تحديات منهجية جوهرية؛ فلا يتوافر دليل أثري أو نصي قاطع يؤكّد الارتباط العضوي بين أسماء بعينها وسياقات المجاعة أو الجدب، ما يفتح الباب أمام الاتهامات النقدية بـ”الانتقائية التأويلية”، أي تقديم قراءات موجهة وفقاً لأطر ثقافية أو رمزية مسبقة.
كما أن اختزال المجاعة بوصفها العامل المفسّر المركزي لتحولات الدلالة، يُخفي خلفه طبقات أعقد من التفاعل تشمل الاقتصاد، وبُنى السلطة، وتطور الأنماط الإنتاجية، وهي عوامل لا يمكن تهميشها في تحليل نشأة الهُويات وتحولاتها. وتبدو الإشكالية أكثر عمقاً حين يُنظر إلى الأسماء كـ”نصوص مغلقة” تنزع عنها تعدد المسارات الممكنة، متجاهلة التأثيرات الدينية الوثنية مثلاً، حيث كانت بعض الأسماء تكتسب قداستها من طقوس ومعتقدات محلية، وليس فقط من آثار المجاعة أو الندرة.
بيد أنه لا يمكن إنكار القيمة التحليلية الجريئة لهذا المشروع، لا سيما في جهده الواضح لتفكيك الثنائيات التقليدية بين التاريخ والأسطورة، وكشف الآليات التي تُحوّل الكوارث الطبيعية إلى سرديات ذات طابع قدسي. فقد أجاد الربيعي، إلى حد بعيد، في تتبع كيفيات انتقال المعاني من الجوع إلى الصبر، ومن القحط إلى الكرامة، وكيف يمكن للأسماء أن تتحوّل إلى مستودعات دلالية لصراعات البقاء. غير أن بعض استنتاجاته ما تزال بحاجة إلى تدعيم نصي وأثري أكثر صرامة، خصوصاً حين يتّسع التفسير ليشمل النصوص الدينية ذات الطبيعة التأسيسية. فبينما يسهم هذا المشروع في تعميق دراسة الأنثروبولوجيا الثقافية العربية، إلا أن تضخيم أثر البيئة دون إدماج البُعد السياسي والاجتماعي بشكل كافٍ، قد يفضي إلى ما يمكن تسميته بـ”المركزية البيئية”، أي اعتماد العامل البيئي كمرتكز تأويلي أوحد .وعليه، يستدعي تطوير هذه المقاربة دمج المعطيات اللغوية بالأدلة الأثرية والنقوش التاريخية، كتوثيق تحركات القبائل ونقوش جنوب الجزيرة، وتوسيع إطار التحليل ليشمل تفاعلات البيئة مع الدين، ومع الاقتصاد، ومع السلطة. فالأسماء، في هذا السياق، أرشيف حيّ لتاريخ اجتماعي صامت، وشيفرات خفية لصراع قديم بين السلطة والمعنى، بين الحاجة والتقديس، بين اللغة والنجاة. ورغم ما تتيحه اللغة من إمكانات تحليلية واسعة، سيمثل الإفراط في التعويل عليها دون الاستناد إلى وثائق تاريخية أو معطيات أثرية، خللاً منهجياً يُضعف الحُجّة، ويُفضي إلى استنتاجات يصعب التحقق من صحتها.
أصابت هذه الثغرة المعرفية منهج الربيعي بشيء من الوهن، تماماً كما أصابت من سبقه في هذا المسار، مثل كمال الصليبي وزياد منى وفرج الله صالح ديب وغيرهم. فاللغة كائن حي متحوّل، تخضع مفرداتها لتحولات دلالية متراكبة، وقد تتعرض معانيها للتشويه عبر النقل الشفهي أو التدوين المتأخر. لذا، لا يكفي الركون إلى التحليل اللساني -بمعزل عن القرائن النصية والأثرية- لتشييد أطروحات متماسكة علمياً، بل سيجعلها عرضة للتأويل والتشكيك، ويقطع الصلة بما يُعرف في السياق الأكاديمي بـ”الحقيقة التاريخية”. ومن هذا المنطلق، يُؤخذ على الربيعي ميله للإصغاء إلى صوته وحده، ونفي الأصوات المخالفة. بل يتّجه أحياناً لبناء فرضيات بديلة تفتقر في كثير من الأحيان إلى أدلة حاسمة. وهذه الإشكالية تتفاقم في ظل غياب نصوص تاريخية صريحة داعمة، ما يدفعه للاعتماد شبه الكامل على التحليل اللغوي والاجتماعي، فتضعف قدرته على اختبار صحة فرضياته، لا سيما في مجالات مثل الأنساب أو التاريخ الشفوي، التي تفتقر بطبيعتها إلى سجلات موثوقة.
ويتجلى هذا القصور حول نسب إسماعيل، وعلاقته بتقاليد النَسَب العربية، وتشكيكه في المواقع الجغرافية المذكورة في المصادر الدينية والتاريخية. ورغم مشروعية إعادة النظر في السرديات التقليدية، يفقد غياب البناء العلمي الصارم هذه الأطروحات شيئاً من مصداقيتها، ويفتح الباب أمام نقد أكاديمي يعتبرها أقرب إلى فرضيات تأويلية منها إلى نماذج تفسيرية قابلة للاختبار. وتكمن معضلة الربيعي الجوهرية في تعامله مع موضوعات معقدة بطبيعتها، كالتاريخ الشفوي، والأنساب، والجغرافيا الثقافية. وهي ميادين تستعصي على التوثيق الحيادي، الأمر الذي يدفعه أحياناً إلى التعويض عن هذا الغياب بتحليل لغوي مكثف قد يتحول إلى بديل مُضلّل. والحل هنا لا يكمن في هدم هذه السرديات، بل في تبني منهج متعدد التخصصات، يدمج بين التحليل اللغوي، والأنثروبولوجيا الأثرية، والنقد الأدبي، عبر تتبع التحولات الصوتية والدلالية وربط النصوص بالمعطيات المادية، وتحليل نشوء الأساطير في سياقاتها الاجتماعية. ويمكن للّغة، هنا، التحول من أداة لهدم المرويات إلى جسر بين الماضي وتأويلاته المحتملة، شرط التخلي عن النظرة الاختزالية التي تطبع منهج الربيعي، والتي تميل إلى تفسير التاريخ من منظور لغوي محض. فالتاريخ لا يتحرك بانزياح المعاني وحده، بل بتفاعل مركّب للعوامل البيئية، والاقتصادية، والسياسية. والاعتراف بهذه “التعددية السببية” يمثل مدخلاً ضرورياً للحوار مع الاتجاهات النقدية المعاصرة في دراسة الشرق القديم.
إعادة التفكير في التصوّرات التاريخية
يشكّل التحليل السياسي والاجتماعي مدخلاً أساسياً لفهم دور التحولات الاجتماعية في صياغة السرديات التاريخية والأساطير المؤسسة، ليس كوقائع، بل كاستراتيجيات لإنتاج الشرعية. ويبرز ذلك بوضوح في تحليله للصراعات القبّلية مثل النزاع بين العدنانيين والقحطانيين، حيث أُنتجت أنساباً مصطنعةً، وتشكلت هُويات انتقائية، خضعت لموازين القوة، ومنحت قبائل بعينها مكانة على حساب غيرها. ولم تكن هذه الأنساق مجرد روايات عن الماضي، بل امتدت لتشكّل الهُويات السياسية والاجتماعية، عبر سرديات تمنح التفوق الأخلاقي والسياسي لجماعة دون أخرى. وهنا تتحول الأسطورة – بصفتها أداة لإنتاج المعنى – إلى آلية لإعادة ترتيب الواقع، وتوزيع السلطة والمكانة. وتغدو هذه الروايات، بما تحمله من مجاز، جزءاً من بنية اجتماعية جديدة تُعيد تعريف مفاهيم مثل الشرف، والنسب، والزواج، في ضوء تحولات دينية وسياسية عميقة.
يُبرز الكتاب كيف شكّل الإسلام قطيعة رمزية مع ممارسات سابقة، خصوصاً في قضايا الزواج والنظام الأسري. فبينما عرف المجتمع ما قبل الإسلامي أنماطاً أكثر تحرراً وتعدداً، جاءت الشريعة لتعيد صياغة مفهوم الأسرة على أسس واضحة: الزواج الأحادي، المسؤولية الأبوية، والنسب المحدد. ولم يكن ذلك مجرد تحول قانوني، بل مشروع لإعادة بناء المجتمع بما ينسجم مع بنية الدولة الدينية الناشئة. وفي هذا السياق، لم تنفصل البنية الدينية عن السياسية، بل تداخلتا، فأصبحت إعادة تشكيل الأنساب وسيلة لإعادة توزيع السلطة. ويكشف التحليل الأنثروبولوجي هنا المساحات الرمادية التي تفصل القطيعة عن الاستمرارية. فبعض ما جاء به الإسلام لم يكن رفضاً تاماً لما سبقه، بل انتقاءً لما يخدم مشروعه، وتجاوزاً لما يتعارض معه. وتُصبح التحولات في النظام الأسري، والعلاقات الاجتماعية، واستراتيجيات السرد، انعكاساً لصراع أعمق: بين الموروث القبلي والإيديولوجيا الدينية الصاعدة. لم تكن المسألة مجرد انتقال من عرف إلى شريعة، بل صراع على المعنى، وعلى تعريف الجماعة، وأدوار الأفراد، وحدود السلطة.
من هذا المنطلق، لا تبدو الرواية التاريخية، مجرّد تسجيل لما حدث، بل مفاوضة بين أطراف متصارعة، كل منها يسعى لتحويل نصه إلى “أصل”، ورموزه إلى “حقيقة”. لذلك، يدعونا الكتاب لإعادة التفكير في مفاهيم مثل: النسب، القبيلة، الجماعة، الشرعية، والتاريخ نفسه. فهل يمكن قراءة التاريخ كمجال رمزي للصراع، وليس كمجموعة من الوقائع؟ وهل يمكن تفكيك الروايات بدلاً من إنكارها، وإنما لفهم شروط ولادتها، وأسباب استمرارها، ومن استفاد منها؟
يبتعد الربيعي عن دور المؤرّخ التقليدي، ليقترب من موقع المفكّر الذي يرى التاريخ خطاباً تُعيد إنتاجه السلطة، ويُعيد تشكيله الصراع. ويسلط الضوء على كيفيات تحول الأحداث إلى مرويات، والمرويات إلى مرجعيات، تخدم توازنات القوة في كل عصر. وفي هذا الإطار، يغدو الإسلام حدثاً ثقافياً وتحولاً بنيوياً، ليس على مستوى الطقوس فقط، بل على مستوى تنظيم العلاقات الاجتماعية. فالصدام مع ممارسات ما قبل الإسلام – كالتعدد الجنسي والزواج غير التعاقدي – مثّل لحظة مفصلية. إعادة تنظيم الزواج، وترسيخ الأسرة الأحادية، لم يكن استجابة لقيم عابرة، بل إقصاءً لمنظومة قبلية ذات منطق خاص بها، أكثر ارتباطاً بالتحالفات والمصالح التكاثرية.
ويقودنا هذا إلى سؤال أكثر عمقاً: كيف يمكن تفكيك السرديات الإسلامية المبكرة بوصفها نصوصاً سياسية، دون الوقوع في فخ التقديس أو الإنكار؟ وكيف نعيد تأويلها بطريقة تفتح أفق حداثة عربية تُصالح بين التاريخ والنقد، بين النص والواقع؟
في المجمل، يقدّم الربيعي قراءة تفكيكية غنية، تُظهر كيف عدم اكتمال تفسير الأساطير والمرويات دون إدراك أبعادها السياسية والاجتماعية، وعلاقتها بالسلطة والمعرفة. فالمسألة لم تكن يوماً: “ماذا حدث؟”، بل: “كيف رُوي ما حدث؟ ومن رواه؟ ولماذا اختيرت هذه الرواية دون غيرها؟”. ولعل أهمية عمله تكمن في هذا بالضبط: كشف أن المرويات ليست محايدة، بل انعكاس لعلاقات القوة، وصراع على الحق في السرد، وعلى مشروعية النسيان والتذكّر.
الجذور الفيلولوجية
يتبنى الربيعي منهجاً فيلولوجياً محدداً في إعادة قراءة وتحليل المصطلحات العربية والإسلامية، ويبدو قريباً من أطروحات مستشرقين كبار مثل: إغناتس غولدتسيهر وجون وانسبرو(7)، لكنه يوسع هذه الأطروحات لتشمل أبعاداً جيوسياسية وثقافية. فبينما ركز غولدتسيهر على نشأة المصطلحات الإسلامية وتطورها ضمن المسارات الدينية والفقهية في الحقب الإسلامية المبكرة، وانشغل وانسبرو ببنية النصوص الإسلامية وتكونها التدريجي قي بيئات ثقافية متعددة، متأثرة بالخطاب التوراتي والبيئة السريانية، انبرى الربيعي لقراءة هذه المصطلحات كمنتجات لتفاعلات ثقافية عابرة للحدود الجغرافية والدينية، وكمؤشرات على صراع تأويلي ممتد بين السلطة والمعنى. فهو لا يكتفي بتتبع الأصول اللغوية للكلمات ودراسة كيفية تطورها عبر الزمن، لتقديم تفسير جديد لأصولها ودلالاتها، بل يقرأها كمفاتيح لفهم تشكّل الهوية والسرد التاريخي، ويربطها بسياقات حضارية وجغرافية متداخلة تشمل العربي والإسلامي والعبري. ويشدد على أن كثيراً من النصوص والمفاهيم الإسلامية لم تنشأ دفعة واحدة، بل تطورت ضمن سياقات سياسية وثقافية متباينة، عبر الترجمة أو التأويل الديني والسياسي، وهو ما يتعارض مع التصوير السائد في الروايات الرسمية التي تقدمها كمنظومة مكتملة ومغلقة، مما يتطلب إعادة قراءتها وتأويلها خارج الأطر التي فرضتها السلطة الدينية والمؤسسية، لصالح قراءة أكثر انفتاحاً على تاريخ الترجمة، والتأويل، وتداخل اللغات.
ينشغل فاضل الربيعي بتفكيك السرديات الرسمية والتأويلات التقليدية التي صاغت الوعي العربي والإسلامي، ويعيد فحص المفاهيم اللغوية داخل تلك السرديات الكبرى والتي شكلت بنيتها الرمزية كمفاهيم متحوّلة انبثقت ضمن سياقات ثقافية وجغرافية وسياسية متغيرة. يركّز في قراءته على جغرافية الحدث وأصول المصطلح، فيضع موضع الشكّ الأسس التي بُنيت عليها الروايات التاريخية السائدة. وينطلق من فرضية أساسية ترى أن المعاني لم تُنتج دفعة واحدة في زمن الوحي أو التدوين، بل أعيد تشكيلها لاحقًا، عبر قرون من التأويل وإعادة القراءة، وأن المفاهيم المتداولة اليوم ربما تكون نتاج تلك القراءات المتأخرة، وليست بالضرورة انعكاساً أميناً للواقع التاريخي الأول. ولهذا يدعو إلى قراءة النصوص القديمة في ضوء التطورات الدلالية والتغيرات الثقافية التي لحقت باللغة، باعتبارها كائناً حياً يتبدّل مع الزمن.
ومع أن الربيعي يستخدم أدوات تحليلية تشبه ما اعتمده الباحثون في الدراسات الاستشراقية النقدية، إلا أنه يوظّفها ضمن مشروعه الخاص لإعادة تأريخ الأحداث المؤسسة في الوعي الديني، مستنداً إلى جغرافيا بديلة، وإلى تحليل لغوي يعيد ربط المفردات بمواطنها الأصلية. فمشروعه لا يقتصر على نقد الرواية الإسلامية الكلاسيكية، بل يمتد إلى إعادة فحص المرويات العربية السابقة على الإسلام، فيجمع بين التحليل اللغوي والتأويل الجغرافي، في قراءة تتجاوز الفقه اللغوي المحض لتصوغ أطروحة تأريخية بديلة، تعيد التفكير في المكان، والزمان، والحدث، كمكونات قابلة لإعادة التفسير.
لا يسعى الربيعي إلى تقديم نظرية جديدة مغلقة، بقدر ما يعمل ضمن منهج تفكيكي-أنثروبولوجي ونقد تاريخي مقارن، يتقاطع مع الأطروحات النظرية المتعلقة بنقد المعرفة والمؤسسات، ويستفيد من الأدوات الخاصة بتحليل البنى الرمزية، ومن مناهج الاستشراق النقدي في قراءة النصوص. لكنه، بخلاف كثير من المستشرقين، ينطلق من داخل الثقافة العربية، وبمنظور يعيد الاعتبار لمصادرها الأصلية، بعيداً عن التأثيرات الاستشراقية الأكاديمية في التفسير أو التأريخ. ويظهر ذلك في قراءته المعمّقة لأصول العرب بفحص الأنساب، والزواج، والطعام في المرويات القديمة لفهم تحوّلات الهُوية، وتحريرها من الثوابت الموروثة التي علّقت بها عبر قرون من التفسير السلطوي، ويقترح أن هذه الهُويات ليست جوهراً ثابتاً، بل بنى متغيرة، تتشكّل باللغة، والمكان، والسرد.
إن هذا التوجه لا يكتفي بتفكيك المصطلح في معناه اللغوي، بل يكشف وظيفته الرمزية والسياسية في إنتاج الشرعية، وتثبيت السرديات المهيمنة، ويصبح الاشتغال الفيلولوجي فعلاً نقدياً على المعنى وليس على اللفظ في تحليل الصراع.
وبهذا المنهج الفيلولوجي المتجذر في تتبّع الكلمات وتحليل تحولاتها عبر الزمن والثقافات، يدخل الربيعي إلى قلب السردية، لا بهدف نقضها فقط، بل لكشف بنيتها التأويلية والسلطوية. فهو يرى أن كثيراً من أسماء المواقع والأحداث ليست أسماء ثابتة لجغرافيا محددة، بل شيفرات لغوية صيغت لاحقاً وأُعيد إسقاطها على خرائط السلطة الاستعمارية والدينية. ولذلك، يعيد قراءة هذه الأسماء من منظور لغوي-تاريخي، متتبعاً اشتقاقاتها وتحولاتها بين العربية، والعبرية، والسريانية، ومبرزاً كيف أُعيد إنتاجها في سياقات سياسية معينة(8)
ويتجلّى البعد الفيلولوجي في منهج الربيعي بوضوح خاص حين يتناول الأنساب العربية باعتبارها بنية خطابية تشكّلت في لحظة سياسية حرجة، بهدف شرعنة موقع قريش في رأس الهرم الاجتماعي والديني فتقرأ الأسماء والأنساب من خلال ربطها بحقول دلالية متقاطعة: الأسطورة، الجغرافيا، والوظيفة الرمزية. فيقدّم إسماعيل في هذا السياق لا كشخصية توراتية أو قرآنية فحسب، بل كعُقدة رمزية في بنية النسب العربي ـ القرشي، وظيفتها تأصيل قداسة النسب المكيّ، ومنحه شرعية روحية وسياسية. فبحسب تحليل الربيعي، تمَّ توظيف قصة إسماعيل وأمه هاجر لإضفاء بُعد “تأسيسي” على الحضور القرشي في مكة، يربطهم مباشرة بإرث النبوة، ويقطع الصلة بقبائل أخرى نافست قريش على المركز والمكانة. وإلى جانب النسب، يركّز الربيعي على ثيمة الجوع كآلية لإنتاج المعنى. فقد مثّل الجوع شرطاً لتكوّن هوية العرب في الصحراء، وهو ما ولّد قيمة الكرم كاستجابة جماعية لحالة حرمان مستمر، ليصبح الكرم بنية تعويضية تشكّل جوهر الهوية العربية، ويتحوّل إلى أداة لبناء الزعامة والسيادة، خصوصاً حين يوظّف في سياق التنافس على المكانة بين القبائل.
وفي قلب هذا السياق، تحتل قريش موقعاً استثنائياً، إذ تحوّلت من قبيلة تجارية تتوسّط طرق القوافل، إلى قبيلة “مُؤسِّسة” لنموذج الحكم، عبر إعادة صياغة موقعها في النسب، وقدرتها على احتكار الرموز الدينية (الكعبة، الحج، السقاية، الحجابة)، ثم لاحقاً احتكار السياسة باسم الدين، تحت مسمّى “الخلافة”. وهنا يعمل الربيعي على تفكيك هذا التحول، لا كحدثٍ تاريخي فقط، بل كبنية لغوية وسردية، أُعيد فيها تشكيل المصطلحات والنسب والفضاء الرمزي، بما يخدم صعود قريش إلى قمة السلطة الدينية والسياسية.
ويمكن تعميم هذه المقاربة في أقصى درجات فعاليتها، عندما نحاول -على سبيل المثال- إعادة تفكيك المفاهيم التأسيسية التي شَكلت بنية السلطة في الإسلام المبكر، مثل “الخلافة”، و”البيعة”، و”السقيفة”، كمصطلحات نشأت ضمن صراعات سياسية واجتماعية حادة، ثم أُعيد تأويلها لاحقاً لتبرير شرعية معينة. فـ”السقيفة”، ليست مجرد حادثة تاريخية، بل مفهوم دال على بنية السلطة القَبلية- الدينية في آنٍ واحد. وهنا يمكن توظيف أدوات التحليل الفيلولوجي لتتبع أصول المصطلح، وتحوّلاته، ودلالاته للكشف عن التداخل بين البنية اللغوية والبنية السياسية للحدث. بل يمكن الذهاب أبعد نحو مصطلحات إسلامية مركزية، مثل “أمير المؤمنين” و”الخلافة”، وهي مصطلحات لم تتشكل من عبث، بل في فضاء مشبع بتجارب ثقافية سابقة، سواء في الجزيرة العربية أو في فضاءات قريبة منها، ما يستدعي إعادة قراءتها على ضوء هذا التداخل الحضاري واللغوي. وبهذا، لا يعود تحليل المصطلحات مجرد تمرين لغوي، بل يتحول إلى مدخل نقدي لكشف طبيعة السلطة التي وُلدت في لحظة السقيفة، ولتفكيك الروايات الرسمية التي أحاطت نشأتها بهالة من الإجماع والقداسة.
مائدة الطعام: الرمزية التاريخية والواقع الاجتماعي وفهم التاريخ غير المكتوب
يطرح شتراوس في عمله الموسوعي “النيء والمطبوخ” منظوراً أنثروبولوجياً للطعام بصفته بنية رمزية تنتمي إلى لغة الأسطورة، وتُجسّد في آنٍ معاً العلاقة المركبة بين الطبيعة والثقافة، وليس بوصفه مورداً اقتصادياً أو موضوعاً اجتماعياً مباشراً، ففكرة التحوّل من النيء إلى المطبوخ لا تمثل مجرد عملية مادية أو انتقالاً وظيفياً (من الطبيعة إلى الثقافة) في طرق إعداد الطعام، بل هي تحول في البنية الذهنية الجماعية التي ينتج، من خلالها، المعنى. هذه الثنائية ليست مجرّد تصنيف تقني، بل استعارة كبرى لتنظيم العالم، ولتفسير كيف يصوغ البشر تصوراتهم عن أنفسهم وعن محيطهم. ويرى شتراوس أن الطعام يشكل وسيلة رمزية لفهم المجتمع وتمثيله، تماماً كما تفعل المعتقدات والأساطير. فيصبح الطعام أحد الأدوات التعبيرية عن المجتمع إلى جانب الرموز الفكرية والمعتقدات الدينية. فـ “”الثنائية بين النيء والمطبوخ ليست مجرد تقسيم وظيفي للطعام، بل هي استعارة لتنظيم الحياة الاجتماعية… وBottom of Form
الطعام هو أحد الأدوات التي تمكّننا الطبيعة، من استيعابه، وبالتالي من تحويله إلى ثقافة.(10)” ويصبح النيء، باعتباره “عنصر خام” وغير قابل للتحكم به، يحيل إلى الفوضى، إلى الطبيعة الأولى، إلى ما قبل التنظيم الاجتماعي. بينما يرمز المطبوخ إلى السيطرة والضبط الثقافي والتحضر، أو التهذيب، أي إلى لحظة دخول الإنسان إلى الحيز الثقافي.
لا ينظر شتراوس إلى الطعام من خلال بعده البيولوجي فحسب، بل ينظر إليه بصفته لغة رمزية تختزل صراع الإنسان مع بيئته، وتكشف عن تشابك المقدس بالدنيوي، وتبرز كيف يُعبّر الفرد عن الجماعة، وكيف تُبلور الجماعة وعيها بنفسها من خلال ما تأكله، وكيف تأكله.
يطرح الربيعي فكرة مغايرة عن المقاربة البنيوية المغلقة لشتراوس، لكنها مبتكرة في جوهرها، ويذهب إلى مناطق أكثر التباساً، فينطلق من رصد العلاقة بين ما كان يُؤكل زمن المجاعات، وبين البنى الاقتصادية والاجتماعية غير المدونة في سجلات التاريخ الرسمي. فالطعام ليس جزء بيولوجي من المعيش اليومي فحسب، بل هو عنصر ثقافي أيضاً يعكس جوانب المجتمع المتعددة وخرائط النفوذ داخله. فلا تقتصر أهمية الطعام على بعد بيولوجي أو حاجة معيشية، في سياق المجاعة، على البقاء، بل يصبح وسيلة لقراءة التاريخ من الهامش، أي التاريخ الذي لم تدونه الطبقات المهيمنة، فدراسة ثقافة الطعام تمثّل مدخلاً لفهم البُنى الخفيّة للمجتمع، مثل أنماط التبادل، وتوزيع الموارد، والطقوس المرتبطة بالحظر والسماح، والعلاقة بين الجسد والسلطة.
يتقاطع هذا الطرح مع مقاربات الأنثروبولوجيا الثقافية بخصوص الطعام كأداة لتشكيل الهويات الجمعية، ومؤشر دقيق على تحولات السلطة(11). غير أن الربيعي يتجاوز البعد الرمزي، إذ يربط بشكل مباشر بين “ما يؤكل“ و “من يُؤكل له”، كاشفاً عن منظومات اقتصادية غير مرئية، تستعملها السلطة في إدارة الندرة، حيث يصبح من يملك الطعام هو من يحكم. وتأخذ بعض أطعمة المجاعة (كشرب الدم مثلاً) معانٍ رمزية مزدوجة: قد تُرفع إلى منزلة أسطورية كعلامات صمود، أو تُجرَّم كوصمة عار. ويُربط تحريم بعض الأطعمة (كالميتة مثلاً) بالسياسات البيئية والطقسية التي تسعى إلى ضبط المجتمع في أوقات الخطر، على نحو يُذكّر بطرح ماري دوغلاس التي ترى في الطعام نظاماً دالاً على البُنى الهرمية.
ولعل مساهمة الربيعي الأبرز، تكمن في إضافته بعداً جغرافياً-سياسياً لمفهوم الجوع، حيث يُعاد فهم الصراع على الطعام بوصفه صراعاً على الأرض، وعلى السلطة، وعلى الرواية التاريخية نفسها. حيث يعيد تعريف المجاعات، من كوارث طبيعية ناتجة عن تغيرات مناخية، إلى حوادث تأسيسية أعادت تشكيل الخريطة الاجتماعية والسياسية في جزيرة العرب. فالجفاف لم يكن مجرد ظرف عابر، بل آلية تاريخية فعالة لإعادة إنتاج السلطة من خلال تفكيك التوازنات القائمة وصياغة تحالفات جديدة. وقد أدّت الحاجة إلى البقاء والنقص الحاد في الموارد الغذائية إلى إعادة ترتيب موازين القوى بين القبائل، حيث انهارت القبائل الرعوية العدنانية، وصعدت في المقابل قبائل تجارية كقريش.
لم تكن المجاعات، إذن، مجرد خلفية مأساوية للحدث التاريخي، بل شكّلت عاملاً بنيوياً في عمليات إعادة التنظيم الاجتماعي والتحولات الهيكلية في العلاقات الاجتماعية والسياسية، ومحركاً خفياً أعاد تشكيل البُنى السياسية. ويعتمد هذا الطرح، الذي يجمع بين التحليل اللغوي والأنثروبولوجي، على تفكيك المفردات التاريخية والثقافية لفهم البنية العميقة للتاريخ العربي المبكر، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية، لا سيما في ظل غياب الأدلة الجغرافية أو الأثرية الداعمة لاقتصاره في أحيان كثيرة على مفردات تاريخية وثقافية، لكنه يواجه تحديات تأويلية، إذ قد لا تكفي التحولات الدلالية – كقراءة معنى “المرار” مثلاً – لتُعتمد دليلاً على تحوّل اجتماعي شامل، بل تبدو في بعض الأحيان تأويلات انتقائية تنطوي على قدر من الانحياز. كما أن المثال الوارد في الفقرة السابقة بشأن تحريم شرب الدم، يفتقر إلى الربط الزمني الدقيق بين التشريع والظروف المناخية التي يُفترض أنها أنتجته، مما يصعّب تعميمه بوصفه نموذجاً تفسيرياً.
يشكّل الربط بين التحوّلات الاجتماعية وأنماط الاستهلاك الغذائي في أزمنة المجاعة إسهاماً لافتاً في إعادة قراءة التاريخ، غير أن هذه الفرضية تظلّ، دون سند مادي واضح، معلّقة في فضاء الاحتمالات. إذ لا يكتمل أثرها التفسيري إلا إذا دعمتها شبكة من المعطيات المادية – مثل دراسات الطبقات الجيولوجية، أو البقايا الأثرية لمواقع الجفاف – بما يكشف تأثيرها المباشر في بنية المجتمعات. فـ “ثقافة الطعام”، رغم ما تتيحه من إمكانات تحليلية لتفكيك السرديات المهمّشة، ورغم جدّيتها المتزايدة كأداة معرفية لفهم التحولات الصامتة، لا تكفي وحدها لتفسير التغيرات البنيوية، بل تستدعي تكاملاً منهجياً مع علوم أخرى كعلم الآثار الأنثروبولوجي، والمناخ التاريخي، وتحليل النقوش والمدونات. ولعلّ هذا الوعي هو ما دفع الربيعي إلى تبنّي قراءة تفكيكية غير تقليدية للتاريخ العربي المبكر، حيث استخدم اللغة وثقافة الطعام كمداخل لتحليل التحوّلات الاجتماعية غير المدونة، وسعى من خلالها إلى إعادة بناء السردية التاريخية عبر تأويل الموروث الغذائي وتحليل المفردات، مما منح مشروعه بعداً ثقافياً وإنسانياً داخل الجدل الأكاديمي المعاصر.
يمتاز هذا المنهج بجعل اللفظ نافذة أنثروبولوجية تُطل على تاريخ لم يُدوَّن، وتُعيد الاعتبار لما أهملته المدونات السلطوية. غير أن مصداقية هذا المسار تظل رهينة بتكامل المعطيات اللغوية مع الأدلة المادية، ومدى قدرة هذا الربط التأويلي على الصمود أمام معايير البحث التاريخي المقارن. ذلك أن الإفراط في تحليل الألفاظ – بمعزل عن الشواهد الأثرية – قد يفضي إلى استنتاجات قائمة على فرضيات لغوية لا تسندها قرائن مادية كافية، وهو ما يُضعف قوة النتائج التي يتوصّل إليها الربيعي، رغم أهمية قراءته التي تدمج بين اللغة والتاريخ الاجتماعي لفهم التحولات التي تجاهلتها الوثائق الرسمية.
لا يُختزل الطعام، في كونه مجرد حاجة بيولوجية، بل يعد -في نظر الربيعي- عنصراً ثقافياً مركزياً، يسهم في صياغة الهُوية الجمعية وتحديد وترميز البنية الاجتماعية. فاختيارات ما يُؤكل – خاصة في الفترات الحرجة من التاريخ كالمجاعات – تفتح نافذة على أنماط الحياة، والعلاقات الاقتصادية، وشبكات التبادل التي لم توثقها السجلات الرسمية. إذ تكشف الأطعمة التي ظهرت خلال أزمنة الشحّ والجفاف عن مؤشرات دقيقة تتعلق بمصادر الثروة الغذائية، وطرائق توزيعها داخل الجماعة، واستراتيجيات التكيّف في مواجهة الأزمات، وكيف أعادت المجتمعات ترتيب أولوياتها وإدارة مواردها وفق منطق الضرورة.
ولا يقف هذا التحليل عند حدود الاقتصاد السياسي، بل يتوسع ليشمل البعد الرمزي والديني، حيث تُعدّ طقوس الطعام والقرابين المرتبطة به تمثلات حية للمعتقدات الجماعية. ولا يبدو النظام الغذائي، في هذا الإطار، مجرد استجابة لحاجات جسدية، بل يغدو وسيلة تعبير رمزية عن قيم المجتمع، وحدوده، وتسلسلاته الهرمية. وبهذا المعنى، تصبح المائدة وثيقة ثقافية قابلة للقراءة، تكشف عن الديناميات الخفية التي شكّلت المجتمعات في لحظات تحوّلها الحاسمة، بما تحمله من دلالات تتجاوز بعدها المادي لتتصل بالسياق الرمزي. فالعلاقة بين المائدة والمعبد، أو بين طقوس القرابين وتحريم بعض الأطعمة، لا تعبّر عن “شريعة دينية” وحسب، بل تُمثّل آليات ثقافية تؤسس للفصل بين المقدّس والمدنّس، وترسم حدود الجماعة وتسلسلها الهرمي وذاكرتها الجماعية.
انطلاقاً من هذه الرؤية، يعيد الربيعي الاعتبار للطعام بوصفه فاعلاً مركزياً في سردية التاريخ الاجتماعي، لا مجرد خلفية هامشية. فاختياره لهذا المنظور لا يقتصر على إثراء الحكاية، بل يحمل طاقة نقدية تمكّنه من الكشف عن ديناميات كامنة، مثل تأثير المجاعات على تفكك التحالفات القبلية، أو دور التغيرات البيئية في تشكيل أنماط العبادة وتحوّلات الهوية الثقافية.
في إطار قراءة أنثروبولوجية للترميز الثقافي للأسطورة، يصعب فهم كثير من الأساطير التي وصلتنا، على نحو دقيق، من دون ربطها بثقافة الطعام، بوصفها نظاماً ثقافياً متجذراً في تاريخ الندرة والمجاعات. فهذه الأساطير، في جوهرها، لا تُعدّ مجرد حكايات رمزية، بل تمثل سجلاً أنثروبولوجياً شفوياً لأزمنة القحط والجوع، التي أعادت تشكيل وعي الجماعات، وأعادت ترتيب مفاهيمها حول البقاء، والانتماء، والشرعية، والهُوية، من خلال تحوّلات وجودية فرضتها تلك الأزمات.
تتحول الطقوس الغذائية، وعادات تناول الطعام، في هذا السياق، إلى عدسة تحليلية كاشفة للبنى النفسية والاجتماعية الكامنة في المجتمعات القديمة. فكل ممارسة غذائية مرتبطة بزمن محدد أو شعيرة طقسية، لا تُعبّر عن اعتقاد ديني فحسب، بل تحتفظ في بنيتها بأثر تجربة جماعية قاسية، غالباً ما تُروى في هيئة خوف متوارث من الجوع، أو رجاء بالخصب، أو توق إلى الاستقرار في ظل انهيار بيئي أو اجتماعي. وبهذا المعنى، لا تُقرأ الأساطير بمعزل عن تجربة الطعام، بل تكشف عن كونها تأريخاً رمزياً لمراحل من الفقر والتحولات الطبقية، لم يسجل في النصوص الرسمية، بل تسلل إلى الذاكرة الجمعية في صورة مرويات خيالية. ولا تقتصر مائدة الطعام هنا على كونها حيزاً بيولوجياً محايداً، بل تتحول إلى ساحة صراع رمزي تُعاد فيها صياغة مفاهيم الشرعية، والهيمنة، والنسب، والانتماء. فشحّ الموارد، وإعادة توزيع السلطة، ونوع الطعام، وتحديد من يُسمَح له بالجلوس إلى المائدة ومن يُقصى عنها، ومن يقدّم الطعام ومن يتلقّاه، كلها علامات سيميائية دقيقة تُجسّد البنية الطبقية، وتُفصح عن اشتباك الجماعة مع واقعها الوجودي.
تصبح المائدة، وفق هذا الفهم، مرآة مكثفة للشرعية الثقافية، لا من خلال محتواها المادي فقط، بل عبر آليات إقصاء خفية تُعيد تعريف “الحق في الأكل” كامتياز رمزي يُعبّر عن التوازنات الدقيقة داخل الجماعة. إنها فضاء محمّل بالصراعات على النسب والمكانة، حيث يشكل ترتيب الجلوس، ونوع الطعام، وحجمه، ومن يُقدّمه أو يُستثنى منه، وحتى لغة الجسد أثناء الأكل، شبكة أنثروبولوجية تُرسم من خلالها خرائط الهيمنة داخل النسق الاجتماعي، وتُحدد فيها مواقع السلطة القادرة على فرض المعايير وإعادة إنتاج الفجوة بين من يملكون حق السرد الثقافي ومن يُحكم عليهم بالصمت.
التاريخ الشفوي بوصفه أداة لإعادة فهم الأنساب
يقدّم الربيعي مقاربةً أنثروبولوجيةً نقديةً لقراءة متجددة للأنساب والهُويات، تسعى إلى تفكيك التصوّرات الجامدة، وتعيد النظر في بنيتها كأنساق ثقافية متحوّلة لا كمعطيات نسبية ثابتة. وتتقاطع هذه المقاربة، في وجوه متعددة، مع أطُر نظرية معاصرة في حقل الأنثروبولوجيا الثقافية، مثل دراسات “الهُويات السائلة” و”التاريخ الاجتماعي للذاكرة”، إلى جانب الأوجه الثقافية التي تعالج الهُوية كسردية دينامية متغيرة تبنى وتهدم في سياقات ثقافية، حيث لا تُفهم الهُوية بوصفها جوهراً جينالوجياً راسخاً، بل سردية متحرّكة تتكوّن وتتفكّك ضمن سياقات اجتماعية متغيرة، وتُعاد صياغتها تبعاً لتحولات بيئية واقتصادية ورمزية.
لا يتوقف الربيعي عند استعادة الماضي أو إعادة تأويله، بل يتجاوز ذلك إلى بناء أدوات وأنساق تحليلية تساعد على فهم “تموضعات” الوجود العربي خارج الثنائيات التقليدية (أصيل/مُستحدَث، ثابت/مُتحول)، عبر تفكيك البُنى الاجتماعية التي تنتج التصورات حول النسب والانتماء، وتسليط الضوء على التشابك المعقّد بين العوامل الطبقية والاقتصادية والسياسية في توليد سرديات الانتماء. كما أنه لا يقيّد مشروعه بإطار تحليلي مغلق أو هيكل تفسيري واحد، بل ينزع إلى مساءلة الأسس الخطابية التي تمنح “الأنساب” طابعاً بيولوجياً طبيعياً، في حين أنها، في جوهرها، ليست سوى ممارسات ثقافية تُنتَج وتُستهلك ضمن شروط اجتماعية محددة. فالنسب، كما يراه، ليس رابطة دم فحسب، بل هو بناء اجتماعي طويل الأمد، يشكّل ما يُشبه “الذاكرة الجمعية المتخيلة” التي تنسج ماضياً قَبَلياً موحداً، يخدم الحاجة إلى إثبات شرعية رمزية أكثر مما يوثّق وقائع تاريخية أو بيولوجية دقيقة. ويعيد هذا التحول من البيولوجيا إلى الثقافة، تعريف النزاعات على الأنساب؛ إذ لم تعد صدامات بين سلالات وروابط دم متنافسة، بل تحوّلت إلى حروب رمزية على السلطة الثقافية، وعلى امتلاك الحق في سرد الماضي، وتعريف معنى الانتماء في الحاضر. وتتكشف هنا البُنى الخفية التي تحكم عمليات إعادة إنتاج الشرعية عبر اللغة والرمز، في ظل تحولات اقتصادية تفرض إعادة توزيع الهيمنة والمكانة داخل البنية الاجتماعية.
وبناءً على هذا التصور، لا تُفهَم الأنساب كحقائق معطاة، بل كاستراتيجيات رمزية تحول أسماء الأعلام إلى علامات دالة على تحولات تاريخية أعمق: كالانتقال من البداوة إلى الحَضَر، أو من الاكتفاء إلى التهميش، أو من السيطرة إلى التراجع. فـ”العائلة”، في هذا السياق، ليست وحدة بيولوجية بل مشروعاً ثقافياً يعيد من خلاله المجتمع إنتاج مروياته عن نفسه، باستخدام أدوات مثل الذاكرة الشفوية، لا كمصدر محايد للتاريخ، بل كأرشيف رمزي مرن يُصاغ ويُوجَّه لخدمة احتياجات الجماعة في لحظتها المعاصرة.
الأنساب بوصفها تمثيلات رمزية لا وقائع تاريخية
ينطلق الربيعي من مقاربة نقدية ترى في الأنساب خطاباً ثقافياً لا حقائق بيولوجية، فيقارب الروايات التاريخية بوصفها تمثيلات رمزية تنشأ في سياقات اجتماعية متغيرة، وليس وقائع ثابتة تسجل تسلسلاً زمنياً دقيقاً. وبدلاً من الانشغال بصحة تلك الروايات أو زيفها، يركّز على تحليل وظائفها الرمزية، ويفتح من خلالها أفقاً تأويلياً يضيء تشابك السرديات مع المصالح الاجتماعية والثقافية للجماعات التي تنتجها. ومن أبرز الأمثلة التي يعالجها إعادة تأويله لادعاء الانتساب إلى شخصية “فالغ” (أو “فالج”)، التي تظهر في المرويات القديمة كجدّ أعلى مشترك بين العرب العاربة والعبرانيين. لا ينشغل الربيعي هنا بإثبات وجود هذه الشخصية من عدمه، بل يقرأها كرمز أنثروبولوجي يُجسّد تشابه أنماط العيش بين جماعات رعوية وزراعية بدائية، حيث يصبح “الجدّ الأعلى” استعارة ثقافية تشير إلى وحدة في نمط الإنتاج أكثر مما تدل على قرابة دموية. وبالمثل، يفكك أسطورة النَسَب المرتبطة بشخصية “عابر”، الذي تقدمه السردية التوراتية الأصل البيولوجي المزعوم للعبرانيين. ومن خلال تحليل لغوي وتاريخي دقيق، يُظهر غياب أي دليل أثري أو لغوي يُثبت وجود جماعة تاريخية بهذا الاسم، ليتبيّن أن “عابر” ليس أكثر من بناء لغوي مُختلق، استُخدم في الخطاب الاستشراقي “العرقي” لتبرير المشروع الاستيطاني، عبر اختزال تاريخ فلسطين إلى “فراغ ديموغرافي” يُملأ بخطاب نَسَب مفبرك يُشرعن حضوراً استعمارياً طارئاً.
لا تتوقف هذه القراءة عند حالة “فالغ” أو “عابر”، بل تمتد لتشمل معظم سلاسل الأنساب في المرويات العربية والتوراتية، حيث يرى الربيعي أن الأسماء لا تشير إلى كيانات بيولوجية بقدر ما تُشفّر تحولات ثقافية وبيئية واقتصادية. فالنسَب – في تحليله – ليس سجلاً محايداً للولادة والدم، بل لغة رمزية تعبّر عن الانتقال من الرعي إلى الزراعة، من الجبل إلى السهل، من القبيلة إلى الدولة، أو عن صراعات داخلية حول الشرعية والسلطة.
في هذا السياق، تتحوّل أسماء مثل “قحطان” و”عدنان” من أصول وراثية إلى سرديات تأسيسية، تُعيد الجماعات عبرها تشكيل ذاكرتها الجمعية، بما يتلاءم مع شروط اللحظة التاريخية وحاجاتها الرمزية. وهكذا يغدو النسب مشروعاً ثقافياً مرناً، ووسيلة لإنتاج سردية حية تعيد الجماعة من خلالها بناء مكانتها وهُويتها في فضاء متغير. بعيداً عن النزوع إلى الماضي الساكن.
فهل يمكن- في هذا الإطار- قراءة “طرد إسماعيل” بوصفها سردية تأسيسية، تعكس صراعاً رمزياً عميقاً في تشكيل الهويات القبلية؟
يُعيد الربيعي تأويل قصة الطرد من منظور أنثروبولوجي نقدي، فلا يتعامل معها كواقعة تاريخية قابلة للتحقق، بل كسردية هُوياتية تُجسّد التحوّلات البنيوية في تشكّل مفهوم “العروبة”. هنا، لا يُقدَّم الطرد كفصل عائلي معزول، بل كرمز لانقسام ثقافي كبير بين العرب العاربة (القحطانيين) والمستعربة (العدنانيين). حيث يتموضع إسماعيل، في لحظة الطرد، بوصفها نقطة الانزياح من النسق العبري-القحطاني نحو نسق “عدناني” مستقل، يُعيد إنتاج ذاته وفق منطق رمزي جديد. ولا ينفصل هذا التحول عن السياق الاجتماعي، بل يتجذّر فيه. فالانفصال بين إبراهيم وهاجر لا يُقرأ كحدث شخصي فحسب، بل كتمثيل رمزي لتحولات في البنى الاقتصادية والتحالفات القبلية. ويشير إلى انتقالٍ من نمط الزراعة المستقرة في الشمال (المرتبط بالعدنانيين) إلى نمط الرعي المتنقل في الجنوب (المرتبط بالقحطانيين). وهذا الفارق الاقتصادي لا يُختزل في نمط المعاش فحسب، بل يتبلور في البنية الرمزية للهُوية: “قحطان” ترتبط بالقحط والترحال، بينما “عدنان” تحيل إلى الإقامة والخصب، كما تعكسه دلالة “عدن” في القرآن: “جنات عدن”(12).
من هنا، تُقرأ التقسيمات النسبية (قحطان/عدنان) باعتبارها استعارات ثقافية تُمثل اختلافات في الأنماط الاقتصادية، أكثر مما تُعبّر عن وقائع روابط دم قبَلية وراثية. بل إن هذا الانقسام عينه تطور إلى صراع على الرأسمال الرمزي، الذي يتجلى -مثلاً- في استخدام “عار الجوع” كأداة تراتُب اجتماعي، تحسم موقع الجماعة في سلم الشرف والمكانة. ويبلغ هذا الصراع أوجه في لحظة سياسية مفصلية: دعم القحطانيين للعباسيين في مواجهة الأمويين. ويقرأ هذا الموقف كامتداد لصراع جيوسياسي أقدم، تبلور رمزه في واقعة استلحاق زياد بن أبيه، التي زعزعت قدسية النسب وفتحت المجال لإعادة تعريف الشرعية الثقافية والسياسية.
لم تكن هذه المجتمعات، لا سيما في ظل أزمات القحط والتنقّل، تعتمد مفهوماً صارماً لـ”الحرام” كما تطور لاحقاً، بل عاشت ضمن بُنى مرنة، وإن كانت معقدة، سمحت بتكييف علاقات النسب تبعاً للحاجة الاقتصادية والظروف الجغرافية. وانعكس هذا في اللغة الرمزية ذاتها، فـ “عار الجوع” لم يكن مجرد وصمة اجتماعية، بل وسيلة تأريخ لهُوية الجماعة عبر علاقتها بالطعام والكرامة والموارد.
ويفتح هذا التأويل الباب لفهم أعمق لمرحلة التحول من “النسب الأمومي” إلى النظام الأبوي. فـ”هاجر”، التي طُردت في ظاهر الرواية، تظهر هنا بوصفها رمزاً لتحالف أمومي سابق، قائم على التنقل والتضامن في مواجهة ندرة الموارد. أما “الطرد” بحد ذاته، فلا يفهم كإقصاء أنثوي، بل يعكس تحوّلاً جذرياً من نظام قائم على التحالفات الأمومية (المرتبطة بالترحال وندرة الموارد) نحو سلطة أبوية مستقرة (قائمة على تكديس الثروة وتنظيم الوراثة).
في هذا السياق، يمثّل الإسلام نقطة انعطاف كبرى. إذ لا يكرّس النسب الأبوي دينياً فحسب، بل يجعله أداة مركزية لبناء السلطة السياسية في الدولة الناشئة. وتتحول هاجر، من “أم منبوذة” إلى “رمز تأسيسي” في الذاكرة العربية الإسلامية، بما يعكس التفاوض بين السرديات الشفوية والسلطة الذكورية. بل إن إعادة إنتاج رمزية هاجر لاحقاً، بتحميل شخصية عائشة بعض دلالاتها، قد تُفهم نوستالجيا نادرة في التاريخ الإسلامي المبكر، يُشير إلى محاولة دمج عناصر من ماضي أمومي في بنية بطريركية جديدة.
يوسّع الربيعي من نطاق تحليله ليُظهر العلاقة العضوية بين التقلبات المناخية والتحولات الاقتصادية، وبين إعادة إنتاج المفاهيم الاجتماعية المرتبطة بالزواج، والأسرة، والممارسات الجنسية. ففي المجتمعات القبلية التي عانت من شحّ الموارد وتقلّب البيئة، لم تكن الُبنى الاجتماعية محكومة بمنظومات معيارية ثابتة، بل خضعت لأنماط تكيّف مرنة استجابت لضغوط البقاء. في هذا السياق، تتولّد الممارسات الثقافية بوصفها آليات دفاعية لتدبير العلاقات الإنسانية، وتوزيع الموارد، وضبط التوازنات القَبَلية. كما شكّل ظهور الإسلام لحظة قطيعة معرفية مع هذا “التراث الجنسي التعددي”، الذي كانت بعض أشكاله – كالزنا – تُدرَك في سياق قبلي كامتداد وظيفي لتعدد الزوجات، قبل إعادة تعريفها في منظومة أخلاقية إسلامية كانتهاك لحدود شرعية جديدة (13).
يعيد الربيعي تأويل تنوّع أنماط الزواج قبل الإسلام ضمن “الاقتصاد الأخلاقي للترحال”، حيث فرض القحط، والتنقل المستمر، والهشاشة الاقتصادية، بناء علاقات اجتماعية قائمة على المرونة. ففي مراحل الجفاف الممتدة، لم تكن “العلاقات غير النمطية” انحرافاً عن المعايير، بل استراتيجية بقاء تسمح بإعادة توزيع الموارد البشرية والمادية، وتُعيد تشكيل التحالفات القَبَلية. ومع بروز أنماط من الاستقرار النسبي في المدن والحواضر، بدأت هذه الممارسات تفقد شرعيتها الرمزية، ليُعاد توطينها في الإسلام ضمن أشكال قانونية مقنّنة: كالنكاح المشروط، والمهر، والميراث، وتقييد تعدد الزوجات.
تتجاوز أطروحة الربيعي البعد السوسيولوجي لتفكيك مفهوم النسَب بوصفه حقيقة بيولوجية، لتُظهره كجهاز رمزي يخفي صراعات ثقافية حول الهُوية وتوزيع الموارد. فالتصنيف بين “العدنانيين” و”القحطانيين” لا يُشير إلى انقسام عِرقي أو قرابة دم بل إلى نمطين اقتصاديين متضادين: الاستقرار الزراعي مقابل الترحال الرعوي. وهكذا يغدو النسب بمنزلة أرشيف ثقافي يُسجّل تحوّلات كبرى: من اقتصاد الغزو إلى اقتصاد السوق، ومن أنظمة التحالف الأمومي إلى البنى الأبوية المُهيمنة.
يفتح هذا التأويل الأنثروبولوجي أفقاً مغايراً لفهم تشكُّل البنى الاجتماعية والدينية في الجزيرة العربية كمحصلة لتفاعلات معقّدة بين البيئة، والاقتصاد، والسياسة، والرمز. وهكذا، لا يُقرأ ظهور الإسلام كتحوّل لاهوتي محض، بل كإعادة تنظيم جذرية للبنية التحتية للمجتمع، شملت إعادة تعريف النسب، والملكية، والعلاقات الجندرية، وأشكال التبادل.
يحرر هذا التحليل المقاربة التاريخية من أسر السرديات العقائدية الخالصة، ليُعيدها إلى سياقها الأرضي المحكوم بتقلبات الواقع، حيث لا تكون النصوص مجرد أوامر أخلاقية، بل أدوات لضبط إيقاع حياةٍ مهددة دائماً بالانهيار.
نقد المنهج: إشكاليات الفيلولوجيا وإغراء التفكيك
يطرح “شقيقات قريش” منظوراً مغايراً يوسّع أفق البحث في الثقافة العربية، خاصة في ما يتعلق بقراءة التاريخ والجغرافيا بوصفهما مركّبين معرفيين لا ينفصلان عن البنية الرمزية والاجتماعية. فلا يكتفي بإعادة تأويل الأساطير والأنساب، بل يعمد إلى تفكيكها، حين يعتبرها مركبات بنيوية دلالية حيّة تعكس تحولات الوعي الجمعي وتفاعله مع شروطه البيئية والسياسية.
هذه المقاربة، وإن كانت تُثير أسئلةً منهجية حول دقة الاستناد التاريخي وسلامة التوظيف الفيلولوجي، فهي تفتح -في المقابل- حقلاً نقدياً ثرياً يدعو إلى مساءلة السرديات التقليدية وإعادة تشكيل أدواتنا المعرفية في قراءة الذاكرة الثقافية.
ولا تكمن القيمة المعرفية للكتاب في الوصول إلى “حقيقة” تاريخية حاسمة، بل في قدرته على زعزعة ما يبدو بديهياً في أنماط إنتاج المعرفة، وجرّ القارئ نحو تأمل أشكال حضور النسَب، والهُوية، والممارسات الجنسية في المخيال الثقافي العربي.
لا يقدّم الربيعي رواية بديلة بقدر ما يُعلن القطيعة مع الرواية الرسمية وسلطتها، مقترحاً تصوراً مختلفاً للسردية العربية القديمة، وفقاً لفرضية نشوء الكثير من المرويات في سياق الصراع حول السلطة والمعنى، وليس في سياق توثيقي محض. لكن هذا المنظور “التحويلي” يصطدم بإشكالات جدّية، خصوصاً في تعامله مع معطيات الجغرافيا التاريخية والنصوص الفيلولوجية. فثمّة توتّر بين رغبته في إنتاج تأويل مغاير، وبين الحاجة إلى ضبطه ضمن أفق من الصرامة النقدية والموثوقية المرجعية. ويبدو أحياناً أن إغراء التفكيك يدفعه إلى تعميمات لا يسندها الدليل اللغوي أو الأثري بما يكفي.
من هنا، تبرز الحاجة إلى مراجعة منهجية تحاول التوفيق بين طموح المشروع وسلامة أدواته، دون إهدار للجرأة الفكرية التي تميز هذا الطرح.
فعلى مستوى الإسهام المعرفي، يتّخذ الربيعي من مائدة الطعام مثالاً لتفكيك العلاقة بين الرمزي واليومي، مقترحاً قراءتها كسجل تاريخي للصراع من أجل البقاء. فلا يقف التاريخ العربي عند سرديته الدينية أو السياسية، وهذا الانزياح في زاوية النظر يفتح أفقاً لقراءته كتاريخ من أسفل، تُروى حكايته من خلال تحول الموائد إلى حدود رمزية تُرسِّم الفوارق بين الجماعات، وتُعيد إنتاج التمايزات الطبقية والهُوياتية، حيث تدخل الأطعمة التي ارتبطت بالمجاعة -كالدم على سبيل المثال- في نسيج الذاكرة، وتتخذ موقعاً داخل سردية الهوية الجمعية ولا تبقى مجرد أثر بيولوجي.
وهنا، يلفت الربيعي النظر إلى التحولات الدلالية في إعادة قراءة بعض المفردات، مثل “المر” التي صارت تعبّر عن قسوة التجربة وخبرة الجوع، فالمائدة، التي هي وسيلة عيش بالأساس، تحولت إلى فضاء ثقافي تعبر عن مجازات صراع وتجارب الجماعة؛ ونص حي يتقاطع فيه الرمزي مع المادي، تُقرأ ضمنه أنماط العيش كانعكاس للهُويات المقموعة. وهكذا، تتحول كل المائدة واستعاراتها إلى ساحة مكثفة للصراع بين الإنسان ومحيطه، بين ذاكرته الجمعية وضروراته الجسدية.
ويتميز الطرح النقدي هنا بالقدرة على تفادي الوقوع في فخٍّ مزدوج، أي، إعادة إنتاج المسلّمات التاريخية من جهة، والانزلاق في فوضى التأويل من جهة أخرى. فهو يوظف أدوات سردية مألوفة لتفكيك آليات إنتاج الشرعية التاريخية من خلال الأسطورة. وتكمن قوة هذا الطرح في كشفه للتشابه البنيوي بين السرديات (العربية والتوراتية مثلاً)، رغم اختلاف سياقاتهما التاريخية والثقافية التي نشأتا فيها، حيث تُستثمر -في كلتيهما- الشخصيات الأسطورية (مثل ملوك اليمن القديم، الذين لا وجود حقيقي لهما في السجلات الأثرية) كأدوات رمزية تأسيسية لبناء شرعية ثقافية متخيلة. غير أن هذه الشخصيات، التي صاغها النسابون والإخباريون ضمن سلالات مفصلة، اكتسبت مع مرور الزمن موقعاً شبه مقدس داخل الذاكرة الجمعية. بل إن إنكار وجودها أصبح يُعدّ اعتداءً على الهوية الثقافية المتوارثة، وليس مجرد اختلاف في التأويل. بهذا المعنى، لا يُعَدّ النسابين مجرد مؤرخين أو مدوّنين، بل مهندسين للذاكرة الجمعية، يحوّلون الغياب الأثري إلى حضور رمزي مُلزِم، من خلال سردية تُخضع التاريخ لضرورات الجماعة ورغبتها في الامتداد والاستمرار.
تكشف ظاهرة النسابين إذاً عن كيفية تحوّل بعض الشخصيات – كملوك سبأ وحِمْير- إلى رموز تأسيسية مقبولة ثقافياً، على الرغم من انعدام الشواهد المادية التي تثبت وجودها. وقد جرت هذه العملية عبر ثلاث مراحل مترابطة: التفصيل النسبي، أي، بناء سلاسل نسب معقدة تُضفي على المتخيَّل طابعاً واقعياً، ثم التكريس الثقافي، عبر تحويل الشخصيات إلى رموز شبه مقدسة، عبر التكرار في المرويات الشعرية والإخبارية. وأخيراً التجريم الرمزي، بوصم أي تشكيك فيها بالخيانة الثقافية، بحيث يصبح نقدها مساساً بالعقد الرمزي للجماعة. وتفضي هذه الآلية إلى اختزال التاريخ الممكن في سردية أحادية تكتسب شرعيتها من قبولها الجمعي، وليس من صدقيتها الإبستمولوجية. غير أن إخضاع هذه السرديات للأسئلة العقلانية في إطار نقد أكاديمي ممنهج يواجه عقبتين مركزيتين: إبستمولوجية، تتمثل في تحوّل الأسطورة إلى “واقع رمزي” متجذّر في البنية القيمية للجماعة، يصعب فصله عن “الحقيقة التاريخية” كما تُتَصوَّر جمعياً. وعقبة أخلاقية، تتعلق بالحذر من المساس بالهشاشة الهُوياتية لمجتمعات تعتمد على الأسطورة كركيزة للتماسك الاجتماعي.
ضمن هذه المعضلة، لا يعود التاريخ مجرّد تسجيل للوقائع، بل يصبح عملية تفاوض دائمة بين الذاكرة والنسيان، تملأ فيها الجماعة الفجوات الأثرية (الانقطاعات) برموز وأساطير تلبّي حاجتها إلى الاستمرارية والبقاء. وعند هذا الحد، تبرز الفروق العميقة بين بنية النسّب في المرويات العربية ونظيرتها التوراتية. إذ تعلي الأولى من شأن “النسَب الوظيفي”، المتعلّق بالتحالفات القبلية والمصالح المادية، في حين تُقدّس الثانية “نسَب رابطة الدم” بوصفه حاملًا للوعود الإلهية (كما في سلالة داود). ولا يكمن هذا الاختلاف في جوهر النسَب ذاته، بل في وظيفته الاجتماعية: فالنسب التوراتي يؤدي دوراً لاهوتياً لتثبيت الامتياز، في حين يعمل النسب العربي كعقدة رمزية تربط بين الأرض والهُوية ضمن جغرافيا مضطربة وقابلة للتفكك.
يمثّل كتاب “شقيقات قريش”، بهذا المعنى، مساهمة نوعية في إعادة تفكيك الصراعات السياسية-الاجتماعية التي شكّلت البنية الأولى للتاريخ الإسلامي المبكر، لا يكتفي فيه الربيعي بمساءلة الرواية التقليدية، بل يذهب إلى تحليل البنية الثقافية التي صاغت قوائم الأنساب العربية والإسلامية، معتبراً أنها لا تُدوّن الانتماءات القبلية فقط، بل تُجسّد، في جوهرها، أنماط رمزية تمثل تصور العرب لأنفسهم، ولموقعهم ضمن شبكة معقّدة من المرويات الدينية والمتخيَّل المقدس.
ومن هذا المنطلق، يعيد الكتاب قراءة الخلافات القُرشية الكبرى، مُستنطقاً النصوص التراثية والمصادر القديمة، ليقدّم تأويلاً مغايراً للرؤية السائدة في المدونات الكلاسيكية. ويستند في تحليله إلى أدوات لغوية وأنثروبولوجية، تسمح له بكشف الطابع الأسطوري المتخفّي في بنية الأنساب، وتتبّع الروابط الرمزية التي تربطها بالمرويات الدينية، بعضها يعود إلى نصوص توراتية أُعيد إنتاجها في سياقات عربية. ومع ذلك، لا تنفصل أهمية هذا الطرح عن الحاجة إلى تفكيكه هو ذاته، ضمن منهجية نقدية لا تفترض يقيناً نهائياً. فبعض استنتاجاته، رغم طرافتها، تظل أسيرة التأويل أكثر من كونها نتائج مدعومة بأدلة مادية أو تأسيساً نظرياً محكماً. كما أن المنهج المستخدم، وإن اتسم بالابتكار، يظل بحاجة إلى تدقيق أكبر في ما يخص تراكب السياقات اللغوية والزمنية التي تحكم النصوص المُعتمدة، ما يستدعي توسيع المقارنة لتشمل روافد تاريخية متعددة.
ولا تقلّ القيمة الإشكالية للكتاب عن قيمته التحليلية. فالمسألة لا تكمن في تقديم “سردية بديلة” بقدر ما تكمن في إثارة أسئلة معرفية حول أدواتنا في مقاربة التاريخ الديني. ولعل الأهم من الطرح ذاته، هو تحفيزه لإعادة النظر في المسلّمات:
هل يكفي تفكيك البُنى السردية لخلق وعي تاريخي جديد؟ أم أن غياب الأثر المادي، وتضارب الأنساق الرمزية، يفرضان إطاراً منهجياً أكثر تواضعاً، يدرك حدود التأويل دون أن يتخلّى عن طموحه التفكيكي؟
وما الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المقاربة في زحزحة الصور الجامدة للذاكرة الجماعية؟
يثير اعتماد الكتاب على المنهج التفكيكي إشكاليات منهجية عميقة تضعه في قلب دائرة نقدية متحفزة. فبينما يزعم تفكيك الروايات التقليدية وتحرير النصوص من سطوة التأويلات السائدة، يكشف التطبيق العملي لهذا المنهج عن مفارقة جوهرية. إذ تبدو حدود التفكيك هنا ملتبسة، وتثير تساؤلات حول مدى صلاحيته كأداة لفهم النصوص التاريخية والدينية. ففي بعض المواضع، لا يحرر التفكيك النص بل يعيد إنتاجه داخل إطار سردي مسبق، يتّكئ على فرضيات مُعلبة تفرض قراءة انتقائية، تُخضع النص لإرادة من يقوم بالتأويل أكثر مما تنفتح على دلالاته المحتملة.
هنا تُطرح أسئلة مشروعة:
هل يسهم التفكيك في الكشف عن البنى العميقة للنصوص، أم أنه يعيد تشكيلها وفق منطق تأويلي ذاتي يفرغها من بنيتها التاريخية ويجعلها عرضة للتمطيط الرمزي؟ وهل تستند قراءة الربيعي إلى وقائع تاريخية قابلة للاختبار، أم أنها تأويلات حرة تستند إلى قرائن لغوية غير كافية؟
هذه التساؤلات لا تعبّر عن موقف عدائي مسبق من المنهج التفكيكي، بل تعكس قلقاً مشروعاً بشأن مدى صلاحيته في التعامل مع النصوص التأسيسية ذات الحمولة الرمزية والدينية الكثيفة، حيث يُخشى أن يتحول النص إلى مادة طيعة تسهِّل اختطافه ضمن رؤية نقدية واحدة، لا ترى فيه إلا ما تريد رؤيته.
من جهة أخرى، يشكل اعتماد الربيعي على المقاربة الفيلولوجية لبناء سرديته التاريخية والجغرافية نقطة ضعف منهجية لا يمكن تجاهلها. فرغم أهمية الفيلولوجيا في تحليل النصوص وتتبع تطور الألفاظ ودلالاتها، إلا أن استخدامها كمرتكز وحيد لإعادة تركيب السياقات التاريخية قد يُفضي إلى اختزال مُخل، خصوصاً في دراسة وقائع تتشابك فيها الطبقات الزمنية والاجتماعية والبيئية والسياسية. فاللغة، مهما كانت مرآة للثقافة، لا تكفي وحدها لرسم ملامح الواقع التاريخي. إذ قد يؤدي التركيز المفرط على التحليل اللغوي إلى إغفال العوامل المادية والاقتصادية والسياسية التي شكّلت خلفية الأحداث، بل وقد يُنتج وهم اليقين، حين تُختزل حقبة تاريخية معقدة في شبكة من الرموز والدلالات المجردة.
وهنا تتجلى الإشكالية المعرفية الأوسع في بعض الممارسات التفكيكية: الانزياح الإبستمولوجي الذي يجعل اللغة المصدر الوحيد للمعرفة التاريخية، ويغفل أن النصوص ليست معطيات خالصة، بل نتاج لسلطة تاريخية محددة، ومحمّلة بسياقات تتجاوز بنيتها اللفظية. وهذا لا يعني التقليل من أهمية الكتاب، بل على العكس، فالقيمة الأساسية لقراءته تكمن في تحفيزها لنقاش عميق حول تاريخية النصوص، ودفعها نحو مراجعة الأدوات التقليدية في التأريخ. لكنها تذكّرنا، في الآن ذاته، بأن التفكيك ليس غاية قائمة بذاتها، بل مدخلٌ ضمن مداخل متعددة نحو فهم أكثر تعقيداً للسرديات الدينية والسياسية.
يبقى الأهم هو الحاجة إلى منهجية تكاملية، تمزج بين التحليل النصي، والنقد التاريخي، والوعي بالتحولات الرمزية والاجتماعية، ومن دونه، قد يتحوّل التفكيك إلى ممارسة مغلقة، تُنتج بدائل رمزية لا تقل سلطوية عن السرديات التي تسعى إلى تجاوزها. ذلك أن المنهج الفيلولوجي، الذي يقوم على تحليل النصوص من خلال جوهرها اللغوي فقط، يعاني من قصور بنيوي يجعله عاجزاً، في كثير من الأحيان، عن تقديم رؤية شاملة للعلاقات التاريخية والجغرافية التي شكّلت ملامح المنطقة في العصور القديمة. فالنصوص المكتوبة، رغم ما تحمله من قيمة معرفية، لا تمثل سوى شذرات مبتورة من الواقع المادي، وتغفل-بطبيعتها-التفاعلات الثقافية والاجتماعية غير المدونة، أو تلك التي طُمست لاحقاً بتأثير قراءات دينية أو سياسية أعادت تشكيل دلالاتها.
ويتعاظم هذا القصور حين يتجاهل المنهج الفيلولوجي طبقات التأويل التي تراكمت على النصوص عبر القرون، لا سيما حين يتعلق الأمر بنصوص اكتسبت صفة القداسة، مما يجعل قراءتها مشروطة بسلطات معرفية ودينية يصعب تجاوزها دون وعي إبستمولوجي عميق. وبهذا المعنى، تبدو الفيلولوجيا وحدها أداة غير كافية لتقديم تفسير متكامل لتاريخ الشعوب أو الجغرافيا التي نشأت فيها، خاصة في سياق مركب كالتاريخ العربي، الذي يتطلب موازنة دقيقة بين تحليل النصوص المكتوبة، وفهم الديناميات الاجتماعية والسياسية التي شكّلت واقعها.
إن اختزال الحدث التاريخي أو الموقع الجغرافي إلى دلالة لغوية وحيدة، دون استحضار المعطيات الآثارية والسوسيولوجية، يُنتج قراءة ناقصة تهمّش الواقع وتُفرغه من تشابكاته المعقدة. بل إن الإفراط في التأويل اللغوي قد يصنع وهماً منهجياً، يوهم باليقين، في حين يُختزل التاريخ إلى شبكة من العلامات، تُهمّش فيها العوامل المادية المحرّكة للأحداث، مثل الجفاف، أو الصراع على الموارد، أو التحولات الاقتصادية الكبرى.
ورغم ما يحمله هذا النهج من إمكانات فكرية، فإن أعمال الربيعي – في مجملها – لم تسلم من انتقادات واسعة، لم تأتِ في جوهرها من رفض مبدئي لمنهج الربيعي التفكيكي، بل من غياب التأصيل الإبستمولوجي لهذا المنهج الذي يربط تحليلاته اللغوية بسياقاتها التاريخية والاجتماعية. فيتحول تأويل الربيعي، في نظر كثير من منتقديه، إلى تمرين ذاتي، يعتمد على أدوات لغوية دون تقديم أدلة كافية يمكن الركون إليها في دعم فرضياته أو تعميمها.
هذا النمط من القراءة، وإن بدا تحررياً في ظاهره، يواجه صعوبة بالغة في الإقناع، ليس فقط بسبب ضعف الاستناد إلى الأدلة الآثارية، بل أيضاً لأن اختزال أحداث تاريخية كبرى إلى دلالات لغوية محضة، يخلّ بتوازن التأويل، ويجعل من النقد أداة لإعادة إنتاج أحكام مؤدلجة لا تختلف كثيراً عن القراءات التقليدية التي يُفترض أن تُفكَّك. وتكمن المفارقة هنا في أن الربيعي، رغم طموحه في تجاوز الجمود التأويلي، يقع في فخ الجمود المنهجي ذاته، حيث يعيد إنتاج النزعة النصيّة (textualism) التي ينتقدها، عبر استبدال القراءة السائدة بقراءة أحادية لا تقل اختزالاً. فالفيلولوجيا، وإن كانت قادرة على إضاءة البُنى اللغوية للنصوص، إلا أنها تعجز وحدها عن تفسير كيفية إنتاج اللغة لواقع تاريخي محدد. وهنا يظهر التحدي الحقيقي، ليس فقط في تفكيك سرديات قديمة، بل في صياغة أخرى جديدة، تستوعب تعقيد التاريخ من دون اختزاله إلى مجرد لعبة لغوية أو صراع على المعاني.
فالنص، مهما اتسعت دلالاته، لا يُنتج الحقيقة بمفرده؛ إنه أحد جناحيها فقط. أما الجناح الآخر، فيكمن في الواقع المعاش الذي لم يُدوّن، والذي تظل الحاجة إليه قائمة لتجاوز التباسات التأويل واستعادة جدّية البحث في التاريخ كنتاج لتشابك اللغة مع المادة، والرمز مع السلطة، والسرد مع السياق.
لا يمكن -من منظور منهجي متماسك- اعتبار المقاربتين الفيلولوجية والتفكيكية كافيتين وحدهما لفهم البُنى التاريخية والجغرافية للشعوب القديمة، أو لتفكيك الشيفرات الرمزية التي تنطوي عليها نصوصها. فرغم الطابع الجريء والمثير الذي يميز أطروحات فاضل الربيعي، فإن القيمة النقدية لأي قراءة تظل رهينة بدرجة تأصيلها المعرفي، وبمقدار استنادها إلى معطيات تاريخية وجغرافية قابلة للاختبار، تضمن اتساق التأويلات مع البنى الواقعية التي تدّعي تفسيرها.
محاور النقد المنهجي
يتركز النقد الموجَّه إلى مشروع الربيعي، أساساً، حول ثلاثة أسس منهجية:
حدود الفيلولوجيا كأداة لتحليل التاريخ والجغرافيا.
وتُظهر هذه المقاربة ميلاً للاختزال، حين تردّ التحولات التاريخية والاجتماعية المعقّدة إلى تفاعلات لغوية داخل النصوص. ويصبح النص هنا سجين دلالاته اللفظية، بينما تُقصى القوى المادية التي تشكّل النسيج الفعلي للواقع، مثل الصراع على الموارد، أو تأثيرات البيئة والمناخ، أو بنى السلطة. وبذلك، تنزلق الفيلولوجيا من أداة تحليل إلى آلية وصف، لا تُفسّر كيف تنتج اللغة أنساق الهيمنة أو كيف تُعيد تشكيل الخريطة السياسية.
إشكالية التفكيك بين التحرير والتشويه.
رغم أن المنهج التفكيكي يتيح قراءة أكثر انفتاحاً للطبقات النصية، إلا أن توظيفه في تحليل التاريخ القديم غالباً ما يؤدي إلى انفصال النص عن سياقاته، وإخضاعه إلى تأويلات معاصرة تفقده بنيته الزمنية، مما يفتح الباب أمام “إجبار تأويلي” يعيد إنتاج النص كمرآة لمواقف القارئ، وليس كنافذة تطل على الماضي. والمثال الأبرز على ذلك، طريقة تعامل الربيعي مع خطاب الأنساب، حين يعزله عن وظيفته الاجتماعية – كآلية لترميز التحالفات السياسية – ويتعامل معه كأنه سجل لغوي قابل للتفكيك.
فجوة التأسيس الإبستمولوجي.
تكشف أعمال الربيعي عن مسافة واضحة بين طموحها النظري من جهة، وقدرتها على التوثيق التاريخي من جهة أخرى. إذ تظل فرضياته، مثل ربط أنظمة النسَب بهياكل الهيمنة، معلّقة في فضاء تأويلي، ما لم تُدعَم بأدلة مادية، من آثار، أو مقارنات تاريخية مع نماذج شبيهة، أو تحليل حَفري للنصوص يتيح التمييز بين بنيتها الأصلية والطبقات اللاحقة المضافة، وما تحتاجه هذه الفرضيات، هو الربط المنهجي بين التأويل والسياق، بغية تحويل القراءة النقدية من تمرين ذهني إلى إسهام معرفي قابل للاختبار.
بناءً على ما سبق؛ يُبرز الكتاب الدور المركزي للغة والرمزية في تشكيل الهوية الثقافية والسياسية للقبائل العربية، عبر مقاربة تفكيكية لخطاب الأنساب والصراعات الاجتماعية. ويتعامل مع النسَب بصفته بنية رمزية تعبّر عن أنماط العيش والخيال الاجتماعي وتوجهات السلطة. وبهذا المعنى، يتحول النسب إلى أدوات للصراع، وسجل متجدد لتحالفات الهيمنة أكثر من كونه شبكة قرابة ورابطة دم تقليدية، ويكشف هذا تحول النسب إلى عقدة وصل ثقافية، تربط الذاكرة الجمعية بالبنية الاجتماعية والخطاب الرمزي ويتحول إلى أداة تأريخ غير رسمية لصراعات السلطة وتوزيع الموارد، وتتحول رموزه إلى أدوات للشرعنة السياسية وإعادة إنتاج النفوذ داخل المجال القبلي والديني، لاسيما في المراحل التأسيسية للإسلام.
ورغم أهمية هذا الطرح وما ينطوي عليه من تفكيك نقدي لوظيفة النسب، إلا أنه يواجه عدداً من الإشكالات المنهجية والمعرفية:
هيمنة البعد الرمزي وتهميش العوامل المادية: حيث يؤدي التركيز على الرموز والأساطير بوصفها مفاتيح تفسيرية شبه حصرية، إلى اختزال الواقع التاريخي وتجاهل العوامل المادية الفاعلة، مثل التحولات البيئية (كالجفاف)، أو الصراعات الاقتصادية، أو التغيرات في أنماط التبادل والسلطة، يضعف هذا الميل إلى الترميز المفرط القدرة على تقديم تحليل واقعي مركّب للظواهر التاريخية.
التقليل من أهمية الأدلة التاريخية الموثوقة: حيث يميل التحليل إلى التشكيك الزائد في المصادر التقليدية، دون تقديم بدائل موثقة بالقدر الكافي، إلى جانب غياب التوازن بين النقد والتوثيق، فيجرب استبدال الوقائع التاريخية المثبتة بفرضيات لغوية وتأويلات أسطورية، بما يزعزع مصداقية السرد ويُضعف الثقة بالنتائج، مثل هذا التوجه النقدي هو أقرب إلى الانشغال بالفيلولوجيا منه بالانضباط التاريخي بمعناه الأكاديمي.
التعميم التأويلي والإسقاط المعاصر: حيث يرتكز المشروع التأويلي في كثير من الأحيان على فرضيات معاصرة يجري إسقاطها على سياقات قديمة دون مراعاة الفروق الزمنية والوظيفية للنص. فالنظر إلى الأساطير كمرآة شاملة للواقع الاجتماعي، وتفسيرها بوصفها بنى تأسيسية للوعي القبلي والسياسي، يؤدي أحياناً إلى قراءة أحادية تُغفل التنوع والتناقض داخل النصوص والسياقات.
غياب الأدلة القاطعة وضعف التراكم المعرفي: يعتمد التحليل على فرضيات تفسيرية لا تحظى غالباً بإسناد مادي كافٍ، كما يغيب في كثير من المواضع الانخراط النقدي الجاد مع الدراسات الأركيولوجية والأنثروبولوجيا الاقتصادية. هذا الانقطاع عن التراكم الأكاديمي الحديث يحرم النص من اختبار علمي ضروري. إضافة إلى ذلك، لا يخضع عمل الربيعي غالباً لمراجعة الأقران العلمية، بما يضعف قابليته للاشتباك مع النقاشات المعاصرة.
الخلط بين الرمز والتاريخ وإعادة إنتاج أسطرة الواقع: يحمل الطرح التفكيكي لدى الربيعي نزعة إلى تفسير الأحداث الواقعية بوصفها تمظهراً للأسطورة، دون التمييز الضروري بين النظام الرمزي والنظام الوقائعي. هذا الخلط يجعل من الصعب التحقق من صحة بعض الاستنتاجات، خاصة تلك المتعلقة بإعادة موضعة الأحداث الجغرافية أو إعادة تأصيل الشخصيات التاريخية.
تغييب البعد السياسي والاجتماعي في الصراع: رغم أن الكتاب يُعلي من شأن البعد الرمزي، إلا أنه لا يُعطي وزناً كافياً للديناميات السياسية والاجتماعية التي تؤطر صراعات الأنساب وتعيد إنتاجها. فالميل إلى تأويل النص انطلاقاً من مركبات أسطورية، دون ربط كافٍ بالسياق التاريخي الفعلي، يُفضي إلى رؤى تفسيرية يغلب عليها الطابع الانتقائي.
خاتمة
في ختام قراءة الكتاب، يخرج القارىء بفكرة لا تنفك تطرق ذهنه: يوسّع فاضل الربيعي أفق النقاش حول تشكّل الهُويات، ويقترح مقاربة تحليلية بديلة لفهم المجتمعات التقليدية، بعيداً عن الثوابت الجاهزة والقراءات الحرفية للأنساب والاساطير التي طالما أُعيد إنتاجها في غياب مساءلة نقدية حقيقية. ويخضعها لمساءلة معرفية تربطها بحقول الغذاء، والزواج، واللغة، والطقوس، باعتبارها أنساقاً ثقافية تعكس ديناميات السلطة وتُعيد إنتاجها. إذ لا يكتفي، بهذا الطرح، بإعادة قراءة الأنساب في ضوء السرديات التقليدية وتحليلها بوصفها سلاسل أو هياكل وراثية، بل يفككها انطلاقاً من البُنى الاجتماعية واللغوية-الرمزية التي أسهمت في إنتاجها، باعتبارها وسيلة لإعادة صياغة الهُوية الجمعية في الثقافة العربية، في مراحل التحول الحاسمة من تاريخ العرب، قبل الإسلام وبعده. ولا يتعامل مع الهُوية كمعطى ثابت أو كيان مكتمل أو ميراث مقدّس، بل كمنظومة أو تشكيل ثقافي رمزي متحول، يتغير مع تبدل الشروط السياسية والاقتصادية والثقافية، ويتداخل مع الصراع على المعنى والشرعية.
ورغم عدم انتمائه إلى الحقل الأنثروبولوجي كمتخصص أكاديمي، إلا أن استخدامه لأدوات التحليل الأنثروبولوجي جاء فاعلاً في هذا الصدد، وفتح المجال لقراءة موضوعات شديدة التعقيد، مثل الطعام، والزواج، والنسب، والأسطورة، والرمز من منظور ثقافي-تاريخي يربط بين المادي والرمزي، والأسطوري واليومي.
لم يقرأ الربيعي الأنساب كأرشيف محايد، بل تعامل معها كنظام اجتماعي- ثقافي خضع لتأويلات السلطة ومقتضيات الهيمنة وتحولات البنية. ولم يرَ في الأسطورة مجرد حكاية خيالية، بل استجابة جماعية لأزمات كبرى، مثل المجاعة، أو الانقسام الاجتماعي، وتحولات السلطة. كما تناول أيضاً طقوس الزواج والطعام، كبنى رمزية تنتج المعنى داخل الجماعة، وتُسهم في تشكيل ذاكرتها الجمعية، وليس علاقة اشتباك معيشي يومي. أما اللغة، فقد نظر إليها كحقل دلالي مشحون بالإيحاءات والرموز، أكثر من كونها وسيلة للتواصل ونقل المعنى، فقرأ الأسماء والمعاني كمفاتيح تأويلية لفهم البنية العميقة للتاريخ كما جسّدتها الممارسات الثقافية اليومية، بعيداً عن المدونات النصية الرسمية، في المسكوت عنه، وفي ما أسقطه السرد السلطوي. وبمثل هذا الجهد التأويلي، يُتيح الربيعي إمكانات نقدية عميقة لإعادة قراءة التراث العربي تُعيد مساءلة ما عُدَّ “مقدساً”، وتربطه بسياقه الاجتماعي والثقافي، وتستكشف تقاطعات الأسطورة والتاريخ على تخوم المعرفة. فرغم الجدل المستمر حول منهجه ونتائجه، تبقى أعماله محاولة جادة لفكّ الاشتباك بين السلطة والمعرفة، ولفتح نافذة تُطل على تاريخ العرب من زواياهم المهمشة، لا من سرديات الغلبة والانتصار.
نعم، التاريخ ليس حقيقة جاهزة، بل حقل صراع مفتوح، تعيد كل جماعة كتابته وفق أدواتها وتمثيلاتها.
والسؤال الأهم لا يتعلق بدقة الخرائط البديلة، بل بقدرتنا على إنتاج منهجيات أكثر شمولًا، تمزج بين اللغة والأرض والذاكرة، لصياغة سردية تتجاوز الصراع إلى إمكان الفهم.
…………….
- صدرت الطبعة الأولى من الكتاب في العام 2002، عن دار “رياض الريس للكتب والنشر”، بعنوان يحمل عنواناً استفهامياً يعبر به إلى منطقة أكثر التباساً: “شقيقات قريش: الأنساب، الزواج، والطعام في الموروث العربي”. ينقسم الكتاب إلى قسمين رئيسين:
-القسم الأول: “نفي إسماعيل (رسالة الأب إلى ابنه المطرود)” ويضم فصولاً تبحث في مواضيع “البحث عن لسان”، “مجاعة مكّة”، “حُقّ يعقوب”. يعيد فيه الكاتب تشكيل سرديات المجاعة والهجرة والشتات واللغة، في مقاربة تتجاوز الأسطورة لتدخل حقل الاجتماع الإنساني والتأويل السياسي.
-القسم الثاني: “الأنساب”، فيخصصه لفصلين، الأول عن “النسب الأمومي والانتساب إلى شجرة الإلهة الأم”، والفصل الثاني بعنوان “عصبيات النسب: الراعي والفلاح”. فيعمل على تفكيك مرويات النسب الأبوي، كاشفاً عن أنماط خفية (حسب تأويله) من الانتساب الأمومي المغيب في مسار الصراع الطويل بين نمطي إنتاج وثقافتين: الفلاحة والرعي (كتذكير بالصراع القديم بين قابيل وهابيل)، الأم والإله، الأنثى والسلطة.. عبر شرح آليات التاريخ الاجتماعي في صراع العصبيات القبلية
وتعكس القائمة الختامية للأنساب العربية و[التوراتية] اهتمام المؤلف بإعادة قراءة المفاهيم الدينية والتاريخية والدينية المرتبطة بالأنساب وتفكيكها من منظور ثقافي واجتماعي وفلسفي، يتجاوز ثنائية النص والواقع، ليصل إلى مساءلة أصل السلطة في صيغها الأولى: من يملك الحق في تسمية النسب؟ ومن يمنح التاريخ شرعيته؟
- يبدأ “البحث الجينالوجي” في الكتاب عندما يوضح أن “الوقائع” التاريخية ليست أكثر من أرشيف سلطوي معاد تدويره. وعندما ينظر أيضاً إلى أنساب العرب كأدوات ترسيخ للهيمنة، بسبب اهتمامه باللحظات التاريخية التي تحولت فيها تلك الأنساب من سجل قَبَلي إلى نص مقدس، تعيد فيه السلطة (الدينية/السياسية) توطين الأسطورة في الجغرافيا (مثل ربط إسماعيل بمكة). ويتيح مفهوم “الجينالوجيا” في سياق النقد الثقافي، أهمية خاصة، لأنه يحول النقد من مجرد هجوم على السلطة إلى تشريح لكيفية صناعتها للحقيقة وتحولها إلى أدوات خطابية صاغتها السلطة لتبرير هيمنتها على المكان والذاكرة. وعليه، حين نقول إن “التفكيك هنا ليس مجرد نقض، بل هو استقصاء يسائل جينالوجيا السلطة الكامنة في قلب الموروث”، فنقصد بذلك أن السلطة لا تظهر فقط في القوانين أو العنف السياسي، بل أيضاً في المرويات، والأساطير، والأنساب، والطقوس، والمفردات اللغوية التي تبدو بريئة ومحايدة. فهذه العناصر التي ينظر إليها أحياناً على أنها “عناصر ثقافية”، تخفي في داخلها أنماطاً سلطوية لإنتاج المعنى، وتوزيع النفوذ، وإقصاء الآخر. فتكون “جينالوجيا السلطة” غوصاً في الجذور الرمزية للهيمنة، لفهم كيف تُبنى الشرعيات، وتُشرعن الحقائق، ويُقصى المختلف، ويُعاد إنتاج المركز والهامش باستمرار. ويتقاطع هذا المعنى مع ما طرحه ميشيل فوكو حين تحدث عن الجنسانية في أوروبا، إذ لم يكن مهتماً بالبحث عن “أصل” الرغبة الجنسية، بل أراد أن يُبيّن كيف تحوّلت هذه الرغبة إلى مجال للسلطة والمعرفة، وكيف تدخلت فيها الدولة، والكنيسة، والطب، والأخلاق، لتنظيمها وضبطها، ويناء على ذلك، لا يعبر المصطلح عن كيان ثابت أو بنية هرمية مفروضة من الأعلى، بل هو بالأحرى مفهوم نقدي وفلسفي، يهدف إلى تتبع غير تقليدي لنشأة السلطة وتحولاتها عبر شبكة ديناميكية من العلاقات والقوى المنتجة عبر التاريخ التي تنمو داخل المجتمع، وتتغلغل في المعرفة، واللغة، والجسد، والمؤسسات. فالفكرة الأساسية هي أن السلطة ليست مجرد أداة يمتلكها الحكام أو جهاز الدولة، بل هي ممارسة يومية تتسرب إلى أدق تفاصيل الحياة من طقوس الجسد إلى أنظمة المعرفة، ومن الخطاب الديني إلى التراتبيات الاجتماعية. وإذ تركز الجينالوجيا على “التشظيات والانقطاعات” في تشكل المفاهيم والمؤسسات، وكشف آليات اشتغال السلطة في صياغة “الحقائق” التي نعتبرها بديهية (مثل الجنون، الجريمة، الجنسانية، الهُوية)، فإن “التاريخ التقليدي” يلتفت نحو “الأصل النبيل” أو الحقيقة المطلقة.
- ينطلق جوزيف كامبيل من فرضية وحدة التجربة الإنسانية كما شرحها في كتابه “البطل بألف وجه” The Hero with a Thousand Faces، فبنى نموذجه المعرفي على أساس تشابه البنية السردية للأسطورة المعبرة عن مراحل نضج الوعي الإنساني حول أسئلة الوجود الكبرى والمصير، بصرف النظر عن الجغرافيا أو العقيدة، واعتبرها تمثيلات نفسية عالمية تعكس هذا التطور، أطلق عليه “رحلة البطل” الذي يغادر معيشه اليومي ليواجه المجهول عبر صراع درامي داخلي يعكس التصعيد بينه وبين العالم الغامض، فيعود وقد تغير. الرحلة هنا ذاتية، ورمزية، تقرأ كبنية وجودية عامة (رحلة البطل الذي يخوض تحولاً وجودياً). في حين يستخدم الربيعي الأسطورة -بصفتها أداة تفكيكية- لإعادة تعريف وتشكيل التاريخ الجغرافي السياسي والديني. في الحقيقة يفرغ الربيعي الأسطورة من طابعها التأملي، فلا يهتم كثيراً إلى استخلاص أنماط سردية أو فهم البنى النفسية للوعي البشري، فـ “الرحلة” ليست حركة وجودية، بل مساراً مادياً يرسم حدود الأرض، والهوية، والسيادة. وإذا كان كامبيل أنتج تأويلاً فلسفياً للأسطورة (بصفتها مرآة للوعي)، فقد أنتج الربيعي نقداً “جينالوجياً” للأسطورة (بصفتها أرشيفاً للصراع على النفوذ والهيمنة)، فيتحول البطل عنده من “مفهوم كوني” إلى “رحلة السلطة”
- تتقاطع قراءة الربيعي للأساطير -جزئياً- مع منهج إدوارد إيفانز بريتشارد، في بحثه حول العلاقة بين المعتقدات والبنى الاجتماعية، فبينما درس بريتشارد الأسطورة ضمن نظام رمزي ينظم العلاقات الداخلية في المجتمعات التقليدية، ويضفي معنى على الظواهر الغامضة كالمرض والموت والكوارث، يتخطى الربيعي هذا المنظور (البنيوي الوظيفي) في نقد الحطاب المهيمن الذي تروج له الأسطورة. وتعبر الأساطير عند برتشارد عن أنماط القوة والعلاقات داخل الجماعات، نحو مقاربة تفكيكية تكشف دور الأسطورة في إنتاج السلطة وإعادة تشكيل الجغرافيا الرمزية للمنطقة. فالأسطورة نظام عقلاني يساعد الجماعة على تفسير العالم و “إدارة” القلق الوجودي، كما طرح في كتابه السحر والعرافة والدين بين الأزاندي””Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande” حيث أظهر كيف تعمل المعتقدات الغيبية على حفظ التماسك الاجتماعي وتوزيع الأدوار داخل الجماعة.
أما الربيعي، فيذهب أبعد من التأمل الفلسفي أو الرمزي إذ لا يكتفي بتحليل بنية الأسطورة، ليأخذ موقفاً نقدياً واضحاً تجاه الروايات التاريخية التقليدية وينظر إليها كأداة تاريخية تهدف إلى إعادة رسم الجغرافيا الدينية والسياسية للمنطقة (يستخدم الربيعي بعضاً من هذه المقارنات كوسيلة لتفكيك الوظيفة الإيديولوجية للسردية التوراتية الاستشراقية والصهيونية، مما يعيد تصوير الأنبياء والأحداث الكبرى في التاريخ العربي من منظور مختلف تماماً). وعلى هذا النحو يكون التاريخ خطاباً ينتجه صناع السلطة والمعرفة، فالتاريخ يُكتب لا يُروى. ورغم أن بريتشارد يعرض هذه الممارسات كجزء من تفسير العالم الاجتماعي، فإنه يراها أدوات لفهم المجهول وتحقيق التماسك الاجتماعي في المجتمعات التقليدية. ويمثل كتابه المذكور نموذجاً مهماً لدراسة العلاقة بين المعتقدات الدينية والممارسات الاجتماعية في المجتمعات التقليدية. ويمكن القول إن الربيعي استفاد من أدوات الأنثروبولوجيا الرمزية هذه لتطوير رؤيته حول كيفية تأثير الأساطير في تشكيل الهويات الثقافية والتاريخية في سياق تاريخ المنطقة. ولكشف التلاعب الرمزي في إعادة إنتاج التاريخ وتفكيك البنى التراتبية التي فرضت ذاتها كمرجعية تاريخية “مقدسة”، فتحليل الأسطورة هنا لا ينفصل عن نقد البنية السياسية للمعرفة، بل يتداخل معها في مشروع بتقاطع مع نقد الاستشراق وما بعد الكولونيالية.
- مثل جون فان سيترز الذي يعد من أبرز الباحثين الغربيين الذين اشتغلوا على نقد النصوص التوراتية من منظور أدبي-تاريخي مقارن، ولجأ إلى عقد مقارنة بنيوية بين النصوص التوراتية والعربية لتحديد مسارات التأثير والتداخل، ورغم أن اهتمامه الأساسي انصبّ على المقارنة بين التوراة ونصوص الشرق القديم (خصوصاً المصرية والرافدية)، فإن منهجه البنيوي في تحليل السرديات يُقدّم خلفية نظرية مهمة لفهم المشروع الذي يقترحه فاضل الربيعي، رغم الاختلاف الجذري في المنطلقات.
يفكك فان سيتيرز في كتابه “إبراهيم في التاريخ والتقليد” (1975) Abraham in History and Tradition، قصص الآباء “البطاركة” كما وردت في سفر التكوين، ويقارنها بحكايات وأساطير مماثلة في الموروث المصري والرافدي بتحليل البنى الأدبية التي تتكرر في سرديات الشرق القديم: الخلق، الطوفان، الهجرات، العهود الإلهية، المجاعات، وصراعات الأبطال. وخلص إلى أن هذه التشابهات لا تدل على أحداث تاريخية حقيقية، بل تكشف عن تبادل أدبي وثقافي واسع، حيث جرى توظيف عناصر مشتركة لصياغة سرديات سياسية ولاهوتية لاحقة. وفي كتابه اللاحق” البحث عن التاريخ” (1983) In Search of History: Historiography in the Ancient World and the Origins of Biblical History.، يواصل تحليل نشوء الكتابة التاريخية في التوراة، ويقارنها بسجلات الملوك الآشوريين والحثّيين، مبيّناً أن كُتّاب التوراة استعاروا نماذج التأريخ الإمبراطوري لتبرير السلطة وبناء شرعية سردية. فالنص التوراتي، لا يُمثّل سجلاً فريداً، بل يندرج في شبكة سرديات قديمة أعيدت صياغتها لتخدم أغراضاً دينية وقومية. يقدم هذا المنهج، الذي يفكك البنية السردية وينزع عنها الطابع التاريخي، خلفية نظرية مفيدة، وإن كانت غير معلنة، لمشروع الربيعي، الذي ينطلق من فرضية مقلوبة: فلا يرى في النص التوراتي منتجاً خارجاً عن الثقافة العربية، بل يعتبره امتداداً للسرديات القبلية في الجزيرة العربية، ويُعيد تموضعه الجغرافي واللغوي في بيئة يمنية ومكّية، لا شامية ولا فلسطينية. ويعتمد لذلك على تحليل المفردات والأسماء ودلالاتها في اللغة العربية القديمة، ويُعيد تأصيل الأحداث والشخصيات استناداً إلى السياقات القَبَلية والبيئة الصحراوية المحلية، وليس إلى المرويات المستوردة من التراث اليهودي أو المسيحي. تبدو المسافة بين المشروعين -مشروع فان سيتيرز ومشروع الربيعي- واسعة، لكنهما يلتقيان من حيث رفضهما للتوراة كوثيقة تاريخية محايدة. فينظر فان سيتيرز للمادة الكتابية بوصفها نصاً أدبياً مشتركاً مع محيطه، بينما يعمل الربيعي على تأصيل التوراة كنص عربي في جوهره، نشأ داخل الذاكرة اللغوية والاجتماعية لشبه الجزيرة. ورغم أن فان سيتيرز لم يتوجّه إلى دراسة النصوص العربية القديمة بشكل مباشر، فإن أفكاره حول الأدب المقارن، والاستعارة الثقافية، وبناء الهوية من خلال السرد، توفّر أدوات تحليل إضافية لفهم بنية النص التوراتي، وهي الأدوات التي يُعيد الربيعي نشرها في فضاء عربي صرف، عبر مقاربة تأصيلية جريئة، تعتمد على اللغة كأرشيف حي لذاكرة الجماعة وتحولاتها.
- تستبطن بعض أطروحات الربيعي، دون التصريح، عدداً من الأفكار الجوهرية التي طوّرها مارفن هاريس حول العلاقة بين أنماط الاستهلاك والهُوية الاجتماعية، لا سيّما في سياق اقتصاد العشيرة. ويُعد هاريس من أبرز منظّري المادية الثقافية (Cultural Materialism)، التي تردّ الظواهر الثقافية إلى عوامل مادية حاسمة، مثل البيئة، والموارد الاقتصادية، والتكنولوجيا المتاحة. ويرى هاريس أن الظواهر الثقافية والأنساق الرمزية التي تحكم استهلاك الغذاء (مثل المحرّمات الغذائية وطقوس الطعام) ليست مجرد تعابير أو دوافع دينية محضة أو تقاليد، بل تُعبّر، من الناحية الوظيفية، عن استراتيجيات عقلانية لإدارة الموارد النادرة. ففي كتابه الشهير “أبقار وخنازير وحروب وسحرة: ألغاز الثقافة”(1974) Cows, Pigs, Wars, and Witches: The Riddles of Culture، يُفسّر تقديس الأبقار في الهند كاستجابة عملية و”عقلانية” للواقع البيئي والاقتصادي؛ فالبقرة تُقدّم خدمات ضرورية فهي تنتج السماد الطبيعي، وتستخدم في الحراثة، كما يعاد تحويل روثها إلى وقود، ما يجعل الحفاظ عليها أكثر نفعاً من ذبحها لأجل الطعام. كما أن تفضيل جماعة ما لنوع معيّن من اللحوم، أو امتناعها عنه، ليس مسألة ذوق ثقافي فقط، بل يعكس تكيفاً بنيوياً مع معطيات البيئة. فحظر أكل لحم الخنزير في المناطق الصحراوية، يمكن تفسيره بانعدام الجدوى الاقتصادية من تربيته في بيئات حارة وشحيحة الموارد. وبحلل في مقاله “البيئة الثقافية للأبقار المقدّسة في الهند” (1966) The Cultural Ecology of India’s Sacred Cattle (نشر في مجلة Current Anthropology ) العلاقة بين القيم الدينية والعقلانية الاقتصادية في المجتمعات الزراعية، كما يبين انعكاس مثل هذا التكيف في بعض الطقوس الغذائية مثل هذا التكيف. ويعمّق هذه الفكرة في كتابه النظري الأساسي “المادية الثقافية: الصراع من أجل علم الثقافة” (1979) Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture الذي يدافع فيه عن مركزية العوامل المادية في تشكيل الثقافة، ويوضح أن تفسير الرموز يجب أن ينطلق من تحليل البنية التحتية الاقتصادية.
منهجياً، يعتمد هاريس على بيانات كمية مثل الإنتاج الزراعي، ومستوى التغذية، وحجم التعداد السكاني، لفهم الوظائف العملية للرموز الثقافية. أما الربيعي، فيتبنّى مقاربة مختلفة ترتكز على التحليل اللغوي، وتتبع الاشتقاقات، والانزياحات الدلالية، بهدف الكشف عن التاريخ الرمزي للمعاناة. فهو، مثلًا، لا يسعى لتفسير سبب الامتناع عن طعام معين من زاوية الجدوى الاقتصادية، بل يبحث في كيفية تحوّل مفردات مثل “المرار” إلى رمز للصبر الجماعي، أو كيف تتحوّل المجاعة إلى أسطورة تبرّر التحوّل الاجتماعي أو الهجرة أو الانهيار القيمي. ويرى كلاهما أن الطعام يتجاوز قيمته من ناحية التغذي ليؤدي دوراً رمزياً في بناء الهُوية. غير أن هاريس ينظر إلى هذه الرمزية من منظور “التكيّف البيئي”، بينما يحمّلها الربيعي وظيفة “التمثيل الرمزي للمعاناة”. في هذا السياق، تتحوّل اللغة، في مشروع الربيعي، إلى أداة تأويلية ترصد كيف تختزن الكلمات وجداناً جماعياً طويل الأمد. وقد يفضي الجمع بين المقاربتين، مادية هاريس الكمية ورمزية الربيعي اللغوية، إلى بناء مقاربة تركيبية أكثر عمقاً لفهم البنى الثقافية في المجتمعات العربية، خاصة في ظروف الندرة والأزمات، حيث تتداخل الرموز مع الحاجات، وتتشكل الهُويات عند تقاطع الاقتصاد مع اللغة والذاكرة.
6.يشير مصطلح “الانزياح الدلالي” أو (التحوُّل الدلالي) إلى تغيّر معنى الكلمة بمرور الزمن، سواء بتضييق دلالتها أم توسيعها أو تبدّلها كلياً. ورغم أن فرديناند دو سوسير لم يستخدم هذا المصطلح صراحة، فإن أفكاره الواردة في كتابه “محاضرات في الألسنية العامة” (1916) Cours de linguistique généraleتُعدّ أساساً نظرياً لفهم هذه الظاهرة، خصوصاً من خلال مفهومه عن “العلامة اللغوية”، التي تتكوّن من الدال (أي الصورة الصوتية أو المكتوبة للكلمة) والمدلول (أي المفهوم أو الفكرة التي تشير إليها الكلمة). وشدّد دو سوسير على أن العلاقة بين الدال والمدلول اعتباطية (أي ليست طبيعية أو منطقية)، فاللغة في نظره نظام ديناميكي يتغيّر بتغيّر دلالات الكلمات وعلاقاتها داخل النسق اللغوي. ومع ذلك، لم يدرس دو سوسير الانزياح الدلالي كمفهوم مستقل، بل تناوله ضمن ما أسماه بـاللسانيات التاريخية (Diachronic) التي اعتبرها أقل أهمية من دراسة اللغة في لحظتها الحاضرة (Synchronic) وهما مصطلحان مركزيان في نظرية فرديناند دو سوسير، استخدمهما لتمييز بين طريقتين لدراسة اللغة، حيث تعني الأولى حرفياً “عبر الزمن، أو على مدى الزمن”، وتشير في اللسانيات إلى دراسة تطوّر اللغة عبر الزمن. أي كيف تغيّرت الكلمات، والبنى، والنحو، والمعاني من حقبة إلى أخرى، على سبيل المثال تطور كلمة “بيت” من الأكادية إلى العربية، أو كيف تحولت بنية الجملة العربية بين العصر الجاهلي والعصر الحديث. وهذا يعني تحري اللغة بوصفها كائناً يتغير تاريخياً، وتبحث عن التحولات في المعنى والصوت والبنية. أما الثانية فتعني حرفياً “في ذات الزمن أو متزامن” والقصد منها في اللسانيات دراسة اللغة في لحظة معينة من الزمن، كأنك تلتقط صورة ثابتة لها. على سبيل المثال كيف تعمل اللغة العربية اليوم من حيث النحو والمعجم والبنية؟ أو كيف تعمل قواعد الفرنسية كما هي في القرن العشرين، دون الالتفات إلى تاريخها السابق. وهي بذلك تركز على النسق البنيوي الداخلي للغة، كما هو موجود في لحظة محددة، بمعزل عن تطورها التاريخي. ويتخذ الربيعي من الانزياح الدلالي أداة مركزية في مشروعه لتفكيك السرديات التاريخية العربية، لكنه يوسّع نطاقه ليجعله وسيلةً للكشف عن الهُويات المطموسة. على سبيل المثال، تحوّل كلمة “قريش” من دلالة قبلية تعني “التجمع حول المال” إلى رمز ديني مقدس، أو ارتباط كلمة “عوص” التي تعني الجدب، بالصلابة والصمود. فالانزياح الدلالي هنا ليس تغييراً لغوياً عشوائياً، بل استجابة لضغوط تاريخية مثل المجاعات، والهجرات، والتحولات السياسية. وفي حين يتجاهل دو سوسير السياقات التاريخية، بحكم تركيزه على بنية اللغة المعاصرة، يُنتقد منهج الربيعي لاعتماده المفرط على التأويلات اللغوية دون أدلة مادية داعمة، مما يجعل كثيراً من استنتاجاته عرضة للجدل. ومع ذلك، يشترك الاثنان في رؤية جوهرية: اللغة ليست مجرد أداة للتواصل، بل نظام ثقافي معقّد يحمل شيفرات الذاكرة الجماعية والتاريخ.
- قرأ إغناتس غولدتسيهر (Ignaz Goldziher, 1850–1921) الحديث والفقه الإسلامي من منظور فيلولوجي-أنثروبولوجي، بوصفهما نتاجاً تاريخياً وثقافياً قابلاً للتخليل والتطور، وليس بوصفهما نصوصاً تراثية مقدسة ومنزهة ومعزولة عن التطور والتأثيرات الخارجية. وتتبّع التحولات الدلالية واللغوية التي طرأت على المفاهيم الشرعية، وكيف تسربت إلى بنية التشريع عناصر يهودية ومسيحية وفارسية، مشيراً إلى بعض المفردات القرآنية التي تبدلت دلالاتها عبر العصور. ويُعد كتابه “العقيدة والشريعة في الإسلام” (1910) Introduction to Islamic Theology and Law من أبرز أعماله، وتناول فيه العلوم الإسلامية من فقه وحديث وعقيدة، وبيّن كيف تشكلت هذه العلوم في أطر تاريخي واجتماعية وثقافي متداخلة ضمن حالة من التفاعل الدائم مع البيئة الفكرية والسياسية المحيطة. ويحذو الربيعي حذو غولدتسيهر في هذا التوجه العام، لكنه يعيد تأويل المصطلحات والنصوص الإسلامية ضمن منظور خاص يرى فيها انعكاساً لصراعات جيوسياسية ورمزية بين القبائل العربية في طور الإسلام المبكر. وينطلق في مقاربته من الجذر السامي للكلمات، ويربطها بتحولات ثقافية وتاريخية أوسع، متجاوزاً القراءات التقليدية التي تفصل النصوص عن عمقها الجغرافي والسياسي، محاولاً كشف التراكمات التي بُنيت فوق النص، وتأثير الترجمة والتأويل السياسي والديني على معناه الأصلي.
أما جون وانسبرو (John Wansbrough, 1928–2002)، فقد اتخذ مساراً أكثر راديكالية، حيث قرأ النصوص الإسلامية، وخاصة القرآن، كنصوص مركّبة متأخر التدوين، نشأت في بيئة مشبعة بالصراعات الثقافية بين العرب والفرس واليهود والمسيحيين. يشكك وانسبرو بالرواية الإسلامية التقليدية حول نشأة القرآن، ورأى أن النص القرآني لم يكن نتاجاً مباشراً للحظة وحي نقي، بل تشكلت لاحقاً لاعتبارات سياسية وثقافية. وقد طوّر هذه الرؤية في كتابه “الدراسات القرآنية: مصادر ومناهج تفسير النصوص المقدسة” (Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation, 1977)، حيث قدم فيه تحليلاً تفكيكياً للنص القرآني باعتباره منتجاً أدبياً وتاريخياً، متأثراً إلى حد بعيد بالمصادر اليهودية والمسيحية، ومفتوحاً على بيئة ثقافية مركبة، ودعى إلى دراسته في ضوء هذه السياقات.
يستلهم الربيعي أدوات غولدتسيهر التحليلية، ويتقاطع منهجياً مع شكوك وانسبرو، لكنّه لا يتبنى مقاربتهما حرفياً. فهو يسعى، بدلاً من ذلك، إلى إعادة بناء سردية عربية داخلية تعاكس قراءة غولدتسيهر ووانسبرو (اللذان انطلقا من خلفية استشراقية ونقدية للنصوص، غالباً بمعزل عن البعد الجغرافي-السياسي الذي يشكّل ركيزة في مشروع الربيعي)، وتكشف عن طبيعة التكوين التاريخي للنصوص، مع التركيز على التحولات الرمزية والاقتصادية التي رافقت صعود قبيلة قريش. وفي الحقيقة يعمل وانسبرو وغولدتسيهر من داخل مؤسسات أكاديمية غربية، ويستخدمان أدوات تحليلية أقرب إلى النقد الكتابي، في حين يسقط الربيعي أدوات التحليل الفيلولوجي على مشروع سياسي-ثقافي لتحرير الوعي العربي من “السلطة النصية”. فهو، رغم اجتهاده وأصالته في الطرح، لا يخضع لمناهج البحث الأكاديمي الصارمة. ولا ينتمي إلى مؤسسة أكاديمية متخصصة بالمعنى التقليدي التقني المميز للدراسات الأكاديمية في العلوم الاجتماعية والإنسانية، بل هو مفكر حر، يعمل خارج الأطر المؤسسية، ويستند إلى أدوات تحليلية فيلولوجية ينتقيها بما يخدم رؤيته ويتفادى القيود المؤسسية التي قد تحد من حريته في التأويل، وهو ما يتيح له مساحة أرحب في إعادة قراءة التاريخ. لكن هذه الاستقلالية تجعله، في المقابل، عرضة لانتقادات حول الأخطار المنهجية المتعلقة بضعف التوثيق، أو التساهل في الاستدلال وغياب الشواهد الملموسة، أو الانزلاق إلى فرضيات يصعب تثبيتها أكاديمياً.
ومن هنا يتضح أن مشروع الربيعي أقرب إلى تأويل ثقافي-سياسي للنصوص، منه إلى بحث أكاديمي محكوم بأدوات صارمة. ورغم قربه المفاهيمي من مناهج غولدتسيهر وانسبرو، إلا أن انحيازه لسردية عربية داخلية يمنحه خصوصية، ويضعه في موقع وسط بين التقليد الاستشراقي والنقد الذاتي للنصوص من داخل الثقافة الإسلامية ذاتها. ومع، يبقى الربيعي صوتاً نقدياً مهماً، يساهم في زعزعة يقينيات سائدة حول تشكّل الإسلام ومصادره، ويدعو إلى مقاربات جديدة لفهم النصوص ضمن سياقاتها الاجتماعية والجيوسياسية، بعيداً عن قوالب التقديس أو الإسقاط الإيديولوجي.
8.تقوم أطروحة فاضل الربيعي، كما تتجلى في بعض أعماله المتعلقة بتاريخ فلسطين القديم وجغرافيا اليمن، على تفكيك الموقع الجغرافي التقليدي للوقائع التوراتية، ونقلها من فلسطين إلى مناطق أخرى في الجزيرة العربية قابلة للفهم ضمن فضاء تاريخي حي متغير، وقابل للتأويل والمراجعة، مثل عسير ونجران وغيرها. وتصبح الفيلولوجيا أداة رئيسة لتحرير الجغرافيا من سطوة القيود والروايات المقدسة التي فرضتها السرديات التقليدية. فالمفردة، في هذا الإطار، لم تعد مجرد علامة لغوية، أو اصطلاحاً جامداً بل أصبحت مفتاحاً تأويلياً يكشف كيفية بناء السرديات الكبرى، ويُظهرها لمصلحة من، وعلى حساب من. ولا يدّعي الربيعي، هنا، نفي الحدث التوراتي أو تقويض وجوده، بل يعيد رسم خارطته الزمانية والمكانية على نحو راديكالي، متكئاً على منهج تأويلي في قراءة النصوص الدينية، ومُستنداً إلى تفاوت دلالات الألفاظ، وتداخل الأسماء، واختلافات الترجمات بين النسخ العبرية واليونانية والعربية للكتاب المقدس.
- يرى كلود ليفي شتراوس أن التحوّل من النيء (الطبيعة) إلى المطبوخ (الثقافة) لا يمثل مجرد عملية فيزيائية، بل هو استعارة بنيوية تعبّر عن الكيفية التي ينظم بها العقل البشري العالم من حوله. فطهو الطعام لا يُشبع الجوع فحسب، بل يُجسد طقساً رمزياً يُكرّس سيطرة الإنسان على الطبيعة ويُعيد إنتاجها في شكل ثقافي. تتكرر هذه الثنائيات (النيء/المطبوخ، الطبيعة/الثقافة) في جميع الثقافات، بوصفها بُنى عقلية عميقة. درس شتراوس هذه الثنائيات من خلال أساطير شعوب أمريكا الجنوبية، وخاصة في البرازيل. وهو يرى أن الطعام ليس مادة استهلاك فحسب، بل منظومة دلالية شبيهة باللغة، تحمل إشارات تُعبّر عن العلاقات بين الجماعات، كتحريم بعض أنواع الطعام التي تُحدّد الهُويات وتُعيد إنتاج الفوارق. ويقترح نموذجاً نظرياً عاماً، يبدو أن فاضل الربيعي استلهم منه منهجية التحليل البنيوي، لكنه طبّقها ضمن سياق مختلف، مستنداً إلى التاريخ المادي: المجاعات، الصراعات، والتحولات السياسية. وبينما ينطلق شتراوس من بنية عقلية كونية لا تتغيّر، يربط الربيعي الرمز بالواقع، ويرى أن الطعام يُشكل أرشيفاً لما لم تُدوّنه النخب: تاريخ الجوع، علاقات السيطرة، ومقاومة الهامش. وللتوفيق بين المنهجين، لا بد من فهم الإطار النظري لكل منهما: يركّز شتراوس على البنى الرمزية الكونية، فيرى أن ثنائية مثل (النيء/المطبوخ) تعبّر عن تنظيم عقلي يتجاوز الزمن والسياق. أما الربيعي، فينطلق من مقاربة مادية تاريخية، فيفكك الرمز بوصفه انعكاساً لصراعات مادية، ويرى أن المجاعة، على سبيل المثال، تُنتج تأويلاً مختلفاً للطعام، تُعيد عبره الجماعة تعريف ذاتها.
يمكن الاستفادة من تحليل شتراوس للثنائيات الرمزية لفهم تحولات الثقافة العربية، خاصة في سياقات الأزمات، كما في تحريم الدم خلال المجاعات. ومن هنا ربما ينشأ تفسير الربيعي التاريخي لبروز رموز معينة – مثل “المرار” – كعلامة على الصلابة والصبر في مجتمعات الجفاف. كما يتكامل التحليل البنيوي والرمزي في قراءة الأساطير، كقصة الطوفان مثلاً، التي يمكن تأويلها على مستويين: رمزياً، حيث تُجسّد ثنائية الخراب/الخلاص؛ وتاريخياً، حيث تشير، ربما، إلى حدث مناخي حقيقي، مثل سيل العرم في التراث العربي.
إن إغفال تحليل شتراوس يُفضي إلى اختزال الرموز في الوقائع، وتفسير التاريخ كصراع مادي فقط. وفي المقابل، تجاهل مقاربة الربيعي يُحوّل الرموز إلى كيانات مجردة، مفصولة عن شروط إنتاجها المادية. فمثلاً، تحريم لحم الخنزير في الثقافة العربية، بحسب شتراوس، يدخل ضمن ثنائية (طاهر/نجس)، ويعكس تصوّراً ثقافياً للكون. أما الربيعي فيربط التحريم بندرة الموارد في البيئة الصحراوية، حيث تربية الخنازير غير عملية أو مجدية اقتصادياً. ومن خلال هذا التكامل، يمكننا أن نفهم أن الثنائية الرمزية (طاهر/نجس) لا تُختزل في بنية عقلية فقط، بل تنبع من تفاعل مع بيئة مادية وضغوط واقعية. فـ”الرمز” يصبح لغة تعبّر بها الثقافة عن ذاتها، بينما يكون “الواقع” هو الجسد الحي الذي يُنتج هذه اللغة.
للتعرف على المزيد من أفكار شتراوس، يرجى الاطلاع على أهم كتبه التالية ضمن مجموعة الأسطوريات
النيء والمطبوخ Le Cru et le Cuit ، 1964 (أسطوريات، المجلد الأول)
من العسل إلى الرماد Du miel aux cendres ، 1966 (أسطوريات، المجلد الثاني)
أصول آداب المائدة L’Origine des manières de table ، 1968 (أسطوريات، المجلد الثالث)
الإنسان العاري L’Homme nu ، 1971 (أسطوريات، المجلد الرابع)
- تُقدّم ماري دوغلاس Mary Douglas إطاراً لفهم الطعام لا كشيء نأكله، بل كوسيلة نُعرّف بها أنفسنا، ونُعبّر من خلالها عن مكاننا في المجتمع، ومن ينتمي ومن يُستبعد، ومن يتقدّم ومن يُقصى. طعامنا يقول عنا أكثر مما نظن. فالطعام ليس مجرد حاجة بيولوجية أو أرشيف للتاريخ، بل نظام رمزي يُعيد إنتاج الحدود الاجتماعية ويصوغ الهُوية الجماعية. فبعيداً عن منظور شتراوس الذي ركّز على البُنى الثنائيات الكونية مثل النيء والمطبوخ، وعن توجّه الربيعي الذي رأى في الطعام مرآة للوقائع التاريخية المطموسة، توظّف دوغلاس الطعام بوصفه أداة لصناعة الفروق بين “نحن” و”الآخر”، ووسيلة لحماية النظام الاجتماعي من الفوضى.
تحلل دوغلاس، في كتابها الشهير “الطهارة والخطر” (1966) Purity and Danger، كيف تُشكّل الممارسات الغذائية حدوداً رمزية بين النقي والمدنّس، المقدس والدنيوي، والمقبول والمرفوض. فأنظمة التحريم الغذائي لا تنبع من دوافع صحية كما يُشاع، بل تُعبّر عن منطق ثقافي خفي يُعيد رسم تصنيفات المجتمع لنفسه وللعالم من حوله. فتحريم لحم الخنزير في اليهودية – على سبيل المثال – لا يعود إلى ضرر بيولوجي، بل إلى كونه لا ينتمي إلى الفئة المصنفة شرعاً (الحيوانات التي تجتر وتشق الحافر)، ما يجعله خارج النظام، أي رمزاً للخلل والفوضى.
ترتبط مفاهيم الطهارة في هذا السياق بمنظومة ترسيم الحدود: ما يُعتبر “نجساً” مثل الدم، لا يُقابل بالرفض لأنه مُضر، بل لأنه يُهدد البنية الرمزية التي تميز من ينتمي إلى الجماعة عمّن لا ينتمي. وفي لحظات الأزمات مثل المجاعات، تصبح هذه الحدود أكثر صرامة، دفاعاً عن التماسك الداخلي. لكن هذه الحدود لا تُمارس دائماً بالقمع أو الحرمان، بل قد تتخذ طابعاً احتفالياً. ففي الولائم، يصبح الطعام “نصاً صامتاً” يُعبّر عن التراتبيات: من يجلس في المقدمة؟ من يقدّم الطعام؟ من يشارك من؟ كلها إشارات تعكس البُنى الاجتماعية المضمرة. ووتظهر في مقالتها “فك شيفرة مائدة الطعام (Deciphering a Meal, 1975)، كيف تُعبّر الوجبات اليومية والولائم عن أنساق التراتب السياسي والاجتماعي. فالمائدة ليست مجرد لحظة استهلاك جماعي، بل فعل رمزي يعيد إنتاج النظام، كما توسع رؤيتها هذه في كتابها “الطعام في النظام الاجتماعي Food in the Social Order (1984)، مؤكدة أن الطعام يُستخدم أيضاً كأداة سلطة، سواء لتثبيت النظام أو لقمع الفئات المهمشة، مما يُقارب بشكل جزئي طرح الربيعي الذي يرى في الطعام مجالًا للصراعات والنجاة. ومع أن كلاً من دوغلاس والربيعي يربطان الطعام بالسلطة، إلا أن مساريهما يختلفان، حيث ترى دوغلاس أن الهدف من التحريم هو الحفاظ على النظام الاجتماعي وتماسك الجماعة، بينما يعتبره الربيعي أداة لكشف التاريخ المهمّش، خصوصاً في أزمنة الشح والمجاعة. وتحريم شرب الدم في الإسلام – مثلاً – يُفهم لدى دوغلاس كوسيلة لترسيم حدود الجماعة الدينية، في حين يربطه الربيعي بأزمات تاريخية فرضت هذا النوع من التحريم لحماية الاستقرار. وتكمن أهمية أعمال دوغلاس في قدرتها على إضاءة البُعد الرمزي للطعام في سياقات مثل الثقافة العربية، حيث تأخذ طقوس الذبح، وتوزيع الأضاحي، والضيافة، مكانة محورية في التعبير عن الانتماء، والشرعية، والنقاء.
- .ورد ذكر “جنات عدن” في القرآن الكريم في11 موضعاً ( الرعد، الآية 23. النحل، الآية 31. الكهف، الآية 31 . مريم، الآية 61. طه، الآية 76. فاطر، الآية 33. ص، الآية 50. غافر، الآية 8. الصف، الآية 12. البينة، الآية 8). للمزيد انظر، الموسوعة القرآنية: https://quranpedia.net/topic/3429?utm_source=chatgpt.com
- لا تذكر المصادر الكلاسيكية المبكرة، سواء الفقهية أو التاريخية، أن أيَّ قبيلةٍ فاوضت النبي محمداً لى تأجيل تحريم الزنا أو الخمر كشرط لقبول الإسلام. وتخلو كتب القرن الأول والثاني الهجري من أيّ إشارة إلى مثل هذا الاشتراط. غير أن بعض المرويات المتأخرة، الواردة في كتب كـ “الكامل في التاريخ” لابن الأثير (القرن السابع الهجري) و”البداية والنهاية” لابن كثير (القرن الثامن الهجري)، تذكر أن قبيلة ثقيف طلبت تأجيل التزامات دينية محددة، كالصلاة والزكاة، واشترطت أن لا تُكسر أصنامها بأيديها. لكن النبي رفض ذلك، وقَبِل تأجيل الزكاة فقط. أما ما ورد عن طلب “بني تميم” الإذن بالزنا، كما جاء في تفسير القرطبي، فهو من الروايات الشاذة التي تُنسب إلى الإسرائيليات. إذ يذكر النص: “جاءت بنو تميم إلى النبي فقالوا: ائذن لنا في الزنا، فإنه أيسر لنا وللنساء! فقال النبي: لا، حتى يموت الحياء”. وقد ضعّف ابن حجر العسقلاني هذه الرواية، واعتبرها غير ثابتة ونسبها إلى الإسرائيليات. وتوظف بعض القراءات الحداثية أو الاستشراقية هذه المرويات بوصفها مؤشرات على تفاوض قبَلي حول بنية القيم، لكن ضعف أسانيدها، وتناقضها مع النصوص القطعية في تحريم الزنا والخمر، يجعل منها أقرب إلى إسقاطات لاحقة، لا إلى وقائع تاريخية موثقة.
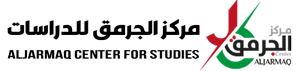 Aljarmaq center Aljarmaq center
Aljarmaq center Aljarmaq center