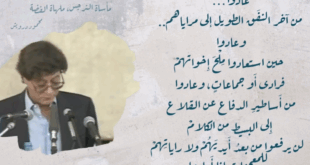السينما ليست مجرد وسيلة تسلية، أو باباً للترفيه، وليست رسالة خلاصية تهدف إلى تحويل واقعنا الأرضي إلى فردوس، بل هي “بعض” ما يمكن أن يحتويه واقعنا وأحلامنا، ومرآة ذكرياتنا وطموحاتنا ونجاحاتنا وإخفاقاتنا وآلامنا(1). هي صورة “ناقصة” عن معنى الحياة، لأننا حتى الآن لا نملك تصوراً كاملاً عن “الفردوس” و”الجحيم” كمقابلين لعوالم لا تنتمي للأرض. وكلما اقتربنا من تعريف أحدهما، اكتشفنا أن ثمة ما هو ناقص في هذا التعريف.
وإذن، السينما، ليست فناً فحسب، بل أرشيف بصري يوثق تفاصيل مهددة بالضياع والنسيان، تفاصيل “أنثروبولوجية” تسكن حياة الناس، ولا تحفظها الذاكرة الجمعية، إلا حين تتحول إلى صورة. لذلك تعد السينما شاهداً حياً على التراث وعلى التاريخ، وعلى المكان، فتمنحهم جميعاً وجوهاً وأصواتاً وحركة بتحويلهم إلى شخصيات حاضرة في المخيلة.
لكن حين نحلل أفلاماً مقتبسة من أعمال كلاسيكية أو ملاحم وأساطير أو قصص شعبي، غالباً ما نقع في فح الانحياز للنص الأدبي، فيبدو الفيلم أقل شأناً. لهذا يجب أن نتعامل بحذر، فالرؤى تجاه السينما تختلف من شخص إلى آخر، ولا توجد إجابات نهائية لأسئلتها. هذا الاختلاف ذاته هو ما يجعل من السينما أداة محفزة على التفكير، ومنصة زمنية مكثفة، حتى وإن ظلت “المتعة البصرية” واحدة من أهم سماتها.
لقد تعرفنا على الكثير من الروائع الأدبية من خلال السينما، كما تعرفنا على قصائد مجهولة عبر الغناء. وهذا لا يعني أن السينما تقدم إجابات قاطعة، بل على العكس، قد تكون مهمتها الأساسية طرح الأسئلة، وفتح أبواب التأمل.
لهذا لا يجب أن نتوقع من السينما أن تقودنا إلى تعميم نهائي، بل عليها أن تفتح النص وتكشف ما فيه، وتقدم للمشاهد “الفرجة الممتعة” التي يبحث عنها. وبفضل اعتمادها على الصورة المتحركة، صارت السينما وسيطاً ثقافياً رئيساً، قادرة على تثبيت الزمن، أو دفعه للأمام وفق ما تقتضيه الرؤية والتأويل. فمن خلالها، رأينا كيف تتحول القيم الإنسانية الكبرى -مثل البطولة، الشرف، العمل، الجنس، الجشع، الكذب، الثورة، التضحية، والظلم- إلى أشكال تتناسب مع ثقافة المجتمع الذي أنتجها، ومع المعاني التي فرضتها السلطة عبر سردها في قصص واقعية أو متخيلة، عبر أشخاص وأماكن وأشياء.
وإذا كانت كل تجربة فنية -سواء كانت مسرحية أو روائية أو شعرية- تمتلك مرجعية أخلاقية تحدد معناها، فما المرجعية التي يقوم عليها فيلم الطوق والإسورة؟
لنبدأ بالحكاية من أولها
في منتصف سبعينيات القرن الماضي كان يتردد على مقهى ريش(2) قرب ميدان طلعت حرب وسط القاهرة، فتى صعيدي أسمر، يمتلك ذاكرة حادة، يستعيد بها ما يكتبه عن ظهر قلب. وبفضل طريقته الساحرة في الحكي والسرد، دون نص مكتوب أمامه، فقد كان يردد أن “القول” هو القاسم المشترك بينه والمجتمع، وهو الرابط الحقيقي بينه وبين الناس. وإذا قال وأجاد القول فسوف يجد من يستمع إليه ويتأثر به وحين يقول سوف يكثر مستمعوه، “فالناس ليسوا صمّاً”، ولطالما معظم الناس لا يقرؤون أو لا يعرفون القراءة في هذا البلد، فما الفائدة لبرجوازي صغير مثله أن يكتب لحفنة مثقفة صغيرة من أمثاله، قد لا تمثل أحداً؟ ولعل هذا ما دفعه لعدم الإيمان بمخاطبة النخبة. كان هذا الفتى حين يحضر إلى المقهى يتجمهر حوله الحضور فيبدأ يروي ما كتبه أو ما يفكر أن يكتبه. قد يبدو هذا الأمر مألوفاً في الشعر، أما في النثر فتلك من الحالات النادرة التي يقوم بها قاص برواية قصصه. وتحويل الحكاية إلى فعل حي، يُقال ويُسمع قبل أن يُكتب
إنه يحي الطاهر عبد الله(3) الذي ينتمي-بزعم د. جابر عصفور- “إلى هذا الجيل الغاضب الذى تمرد على أشكال الكتابة القائمة والموروثة، مستعيناً بالتجريب الذى اقترن بالبحث عن أشكال جديدة وخرائط إبداعية مختلفة، وذلك بهدف مجاوزة الثنائية التقليدية بين الأصالة والمعاصرة، وبين الطليعة المهمشة والجماهير العريضة التي حلمت الطليعة بتحريكها”. فبحث عن لغة جديدة وخرائط إبداعية مغايرة جعلته “يختار الحكي الشفاهي لتوصيل قصصه التي احتفت بها الحياة الثقافية”، كصوت فريد خارج عن المألوف. ويحيى هذا -رغم رحيله المبكر- حكاية لم تنته، مثل وهم البطولة. زخم قادم من أعماق الصعيد يتدفق رحباً مع النيل فيصل إلى الشواطئ البعيدة ليواجه صدمة المدينة بإغرائها وقسوتها وأضوائها ونسائها، ورغم حياته القصيرة، إلا انه كان من القلائل الذين امتلكوا ناصية اللغة الشعرية داخل النص السردي. حتى أطلق عليه البعض لقب شاعر القصة القصيرة، لما امتاز أسلوبه من تركيب لغوي غير تقليدي ومجازات غير مألوفة تنبض بالحياة، ولعل الأهم، رفضه بلغة النخبة المتعالية، فدمج
بين الفصحى والعامية الصعيدية، مما يُعتبر تمرداً على الأنماط الأدبية السائدة. فمن خلال هذه اللغة، تشكل صوته كصوت للمهمشين، لا يتحدث عنهم من فوق، أو من خارج، بل من داخلهم، فهو لم يكن سوى واحد منهم. فقد كان يكثر من الحديث عن قريته “الكرنك”. تلك القرية المنسية التي يحاول أن يضعها على خارطة الذاكرة بشخوصها وحيزها. لم تكن الكرنك مسرحاً لأحداث عوامله فقط، بل كانت ذاكرة حيّة، حاول أن يحفظها بالحكي قبل أن يكتبها، كان يرى فيها صورة مصغّرة للوطن: منفية، منسية، ومقهورة، تماماً كما كان يرى نفسه. لقد كان يحكيها، بالأحرى يحفظها قبل أن يكتبها على الورق ثم يقوم بروايتها: “أرى أن ما وقع على الوطن وقع عليها… وهي قرية منسية منفية، كما أنا منفي ومنسي… كما أنها أيضا قرية في مواجهة عالم عصري… إذن عندما ابتعد عن قريتي أسعى إليها في المدينة، وأبحث عن أهلي وأقربائي وناسي الذين يعيشون معي… وأنا لا أحيا إلا في عالمهم السفلي… فحين التقي بهم نلتقي كـ “صعايدة” وكأبناء “كرنك” ونحيا معاً ألمنا المصري وفجيعتنا العربية وبعدنا عن العصر كشخوص مغتربة”.
الكرنك القريبة من المعبد القديم في الأقصر “طيبة الفرعونية القديمة”(4) كانت فيما مضى موضع توسلات النساء اللواتي يذهبن إلى البحيرة المقدسة لطلب الإنجاب. والوصول إلى المعبد يمر عبر “طريق الكباش”، وهو ذاته الطريق المؤدي إلى القرية. وتسمية الكرنك حديثة نسبياً، يعتقد أنها تحريف لكلمة “الخورنق” العربية، بينما أقدم اسم عرفت به هو “بر آمون”، أي معبد آمون أو بين آمون. ويمكن أن نقرأ في الرواية أن تلك الكباش المسمى الطريق باسمها “كانت بشراً في الزمن القديم، وغضبة الله هي التي حولت بشر الزمن القديم إلى حجر، عقاباً لهم على كفرهم، نعم… كيف يتزوج الأخ من أخته؟ والابن من أمه؟ وها هم البشر العصاة يرقدون في صفين متقابلين، لهم رؤوس كباش وأجساد أسود”.
فمن هو يحيى الطاهر علد الله حقاً؟
هل كان مجنون على غرار الماركيز العبقري دو ساد ؟أم ثورياً حالماً تائهاً بين الرغبة والخذلان؟ أم عاشقاً فاشلاً لجأ إلى الأدب كنوع من التعزية؟ أم هو مجرد كاتب بسيط يطارد المجد والشهرة، ويحلم بأن تخلده مدونته الأدبية؟
طيب هل وصل إلى شيء؟
لا أحد يعرف، لم يعد من “هناك” أحد ليخبرنا بما حل به، ولا ممن يكمل حكايته. ما نملكه -في الحقيقة- هو “الطوق والإسورة”(5) وبقية أعماله، نطل منها على عوالمه الداخلية وعلى صعيد مصر الذي شغف به.
كُتبت الرواية في السبعينيات في زمن السادات، عصر الانفتاح الاقتصادي والعولمة التي شرعت الأبواب لتهميش الريف المصري. وفي هذا السياق، يمكن قراءة الرواية بوصفها شهادة على التبدل العنيف الذي طال مصر وليس فقط ريفها، من خلال تجسيد الشخصية الأساسية التي تحاول العودة من الغربة إلى القرية الريف، لكنها تصطدم بواقع متغير يقصيها. أما الفيلم، الذي أنتج في الثمانينيات، في عهد مبارك، فقد حمل بدوره بصمة زمن اتسعت فيه الفجوة بين الريف والحضر. فانعكس ذلك في اختياراته الإخراجية، وفي إبرازه الحاد لمأساة القرية المصرية. فالتحولات السياسية والاجتماعية آنذاك، تركت أثراً ظاهراً في تصوير الوجع الريفي، ليس بوصفه نوستالجيا، بل كواقع منسيّ يتآكله الزمن.
وإذا كانت الرواية مشغولة بلغة مزدوجة محكية وفصحى أقرب إلى الوجدان الشعبي، تحمل في نبرتها صدى السرد الشفاهي، وتنبض بإيقاع الذاكرة الجماعية من خلال مساحة سردية مدهشة، فإن الفيلم لم يكتف باستعارتها، بل أعاد تشكيلها بصرياً وأضاف إليها أبعاداً حولت السرد إلى مادة للعرض والتأمل و”موضوع” للتمثيل، بل أكثر من ذلك، منحه بنية فنية فاعلة ولغوية، تمتلك حيوية ودرامية وجمالية تتجاوز الكلمة إلى الصورة، وتستبدل الإيقاع السمعي بإيقاع بصري محسوس. فمشهد “فرحانة” المدفونة حتى رقبتها لم يُقدَّم بوصفه ذروة درامية فحسب، بل بوصفه استعارة مؤلمة لحال بلد بأكمله -مصر- الغارقة في رمال وعود الانفتاح والسلام، تلك التي دفنتها حية، وأبقت رأسها فقط ظاهراً للهواء، كي تتنفس وهماً لا أكثر.
أتذكر جيداً أنني شاهدت الفيلم أول مرة في نهاية الثمانينيات. كنت حينها في الجزائر، وكمنت قد قرأت “الأعمال الكاملة” ليحيى الطاهر عبد اللهـ في طبعتها الأولى. ورغم إعجابي بسحر نصوصه، ومزجه الآسر والمدهش للفصيح بالمحكي، وتلك الأصالة التي يتنفسها كل سطر، إلا أنني لم أستسغ أسلوبه في بعض المواضع، فقد بدت لي بعض النصوص مفككة، والمعنى مبتور، كأن ثمة “كسر” في بنيته، كأن اللعة “تتعثر” في الطريق نحو المعنى، بل شعرت أحيانا أن هناك “لا معنى” قصدي من الناحية الشكلية للنص على النحو المألوف في الأدب. كان أشبه بمن يحاول جاهداً أن يقول شيئاً، لكنه يعجز عن الإمساك به. (هل كان هذا ما جعله يفضل الحكي على الكتابة؟ هل كان الصوت، بالنسبة له، أكثر أماناً من الحرف؟ أعرف كثيراً من الأصدقاء من يجيدون الحديث دون الكتابة والعكس بالعكس).
وفي الحقيقة لم أعد لقراءة أعماله بعد ذلك (بل لعلي قرأت أجزاء منها بشكل متقطع ودون ترتيب مسبق). لكن حين شاهدت الفيلم مجدداً، بدأت أستعيد بعض من ألق لغته وأستشعر شيئاً من منطق الصورة الرمزية في كتاباته، وبدأت أستعيد تجلي أفكار الرواية، لا من خلال النص، بل من خلال التمثيل. دون أن تغيب رؤيتي الانطباعية الأولى عن الرواية، فلم أستطع الخروج من قماطها. وهنا، لعب الأداء التمثيلي لعزت العلايلي وشيريهان وفردوس عبد الحميد دوراً حاسماً في فك شيفرة النص الأصلي. لقد ساعدني الفيلم -بوسائطه المختلفة- على الاقتراب من عالم يحيى الطاهر عبد الله الذي ظل مغلقاً أمامي لسنوات. ولو قيّض لي اليوم أن أعود إلى نصوصه، فربما أقرؤه بأعين الممثلين، وربما أبحث عن فردوس ورفاقها في ثنايا السطور، كي أجد ما غاب عني في أول قراءة.
” آه يا لالاللي… عَ اللي اتغرّب يوم ولا قال لي”
هكذا يبدأ الفيلم.. أغنية شعبية تنبع من الوجدان، ومشهد تراثي أصيل مشبع برائحة الأرض. (يصر المخرج خيري بشارة(6) على هذه الخاصية طوال الفيلم). كادر ثابت لسماء صافية وطيور بيضاء وسطر كتب عليه: “قرية الكرنك الأقصر 1933” تنتقل الكامرة لتنقل صورة فتاة مراهقة تدندن بتلك الكلمات، بينما تتنفس القرية إيقاعها البطيء. ثم تظهر لنا الصورة كاملة، دخان يتصاعد من الفرن، الأب نائماً في قيلولته، الأم تطعم فراخها وهي تستمع بسعادة لصوت ابنتها. يقطع نشوتها سعال الأب فتهرع -مع ابنتها- نحوه مسرعتان لنكتشف بسرعة عجزه ومرضه. يستند الأب على السيدتين ويسأل عن الابن الغائب.. وهكذا بأقل من دقيقة يعرفنا المخرج على أهم عناصر الحكاية وشخوصها… الزمان والمكان، والحدث الرئيس الذي سيتنامى منه كل شيء -غياب الابن، وحضور الأب المريض، والبنت التي تقف على عتبة النضج، والأم التي تحاول أن تحافظ على ما تبقى من البيت.
هذه البداية الشفافة والبسيطة برهافتها وصدقها، والمفعمة بالتفاصيل اليومية، تمنح الفيلم روحاً صادقة وملموسة، تنتمي تماماً إلى عالم يحيى الطاهر عبد الله، كما لو أنها خرجت من أعماقه مباشرة، وليس من نص مكتوب.
ثم تتوالى المشاهد لتصف لنا إيقاع الحياة الكرنك البطيئة والكئيبة الغارقة في تفاصيل المعيش اليومي، مع ميل واضح إلى الميلودراما في كثير من اللحظات (7). لكن الفيلم لا يغرق في العاطفة الفجة، بل ينهض على توازن دقيق بين الواقعية والشاعرية والتجريد، ويستدعي تقنيات التسجيل السردي الوثائقي والبناء الدرامي.
لم تكن الميلودراما الشعبية هنا للتهوين أو التماهي مع ذوق سطحي، بل كان استخدامها فعلاً سياسياً واضحاً. فالمبالغة لا تهدف إلى خلق المفارقة المضحكة، أو حتى المتعة، بل تهدف إلى الفضح التعرية. وكل فقد فردي في الفيلم يتضخم ليصبح فقداً جمعياً، وكل غياب يتحول إلى كناية عن نظام اجتماعي مأزوم يكبله الصمت والتهميش والتغريب.
فهل كانت “الطوق والإسورة” رمزاً لاستمرارية مستحيلة؟ ووعداً بأمان لم يتحقق يوماً؟
هل الغائبون في الحكاية هم رموز لسلطات وعدت ولم تف بوعودها، تماماً كوعود الغائبين الذين لا يعودون(8)؟
الميلودراما عند خيري بشارة لا تصرخ، بل تهمس. لا تبكِ، بل تنظر بصمت في العيون تصنع حكاية لا عن البكاء، بل عن العجز عن البكاء. دراما باردة، خافتة، تقف على تخوم الموت البطيء، حيث الزمن متوقف، والحكاية تدور في حلقة مفرغة، وكأنها تسأل: متى ينهض هذا الغائب؟
وهل يعود؟
وإذا عاد، فماذا تبقّى ليجده؟
يعيدنا التداخل بين الواقعي والمتخيل إلى تقاليد الحكي الشفاهي في صعيد مصر، حيث تختلط المأساة بالقدر ويتماهيان. غير أن الفيلم لا يستخدم الميلودراما بصيغتها التجارية المبتذلة، بل يوظفها كأداة لتفكيك البنى الاجتماعية، فيكشف القهر الاجتماعي والاقتصادي من خلال شخصيات مسحوقة، مشروخة من الداخل، تقاوم وتتصارع مع السلطة الذكورية، والخرافة، والفقر، والجفاف العاطفي، دون أغفال المنطق والواقع.
تبدأ أحدث الفيلم، إذن، مع الثلث الثاني من القرن الماضي في قرية صغيرة في صعيد مصر تدعى” الكرنك” في محافظة الأقصر، حيث تعيش عائلة صغيرة تعاني الفقر والعجز ومكونة من الأب “بخيت المشاري” المشلول والمصاب بالسل، والأم “حزينة” التي تعوله، والابنة “فهيمة” التي نشأت في جو يرى في “الذكورة نعمة كبرى” وفي الأنوثة “عبء ونقمة كبرى”.
تتعلم “فهيمة” كيف ينبغي لها أن تخاف من أخيها حتى لو كان أصغر منها، حتى في غيابه (يتكرر مشهد محدد بتقنية الفلاش باك تظهر فيه فهيمة الطفلة وشقيقها مصطفى وهو يدخن مثل “الرجال”، في إيحاء رمزي إلى مستقبل العلاقة بينهما، وإلى مصير كل منهما).
وحين يذكرها في رسائله ويتمنى لها “الستر” ترتعد “فهيمة” من وقعها لأنها تعرف أن الكلمة تعني “الزواج”، وأنها مقدمة على مصير ليس من اختيارها. رغم ذلاك، تتعلم “فهيمة” كيف تحبه وتشتاق إليه في غيابه، فهو ليس فقط الأخ، بل هو في الواقع يمثل ضلعاً أساسياً من مثلثها النفسي، إلى جانب الأب والأم، فهو، من منظور التأويل النفسي، رمزاً للرعاية والحماية، ويفتح غيابه الباب للغريب كي يتجاوز حدودها النفسية والجسدية، مما يترك فيها جرحاً عميقاً، ويشعرها بالخواء والضياع.
تتعلق العائلة بأمل عودة ابنهما الوحيد “مصطفى” الذي نزح إلى السودان حين كانت جزء من مصر، بحثاً عن العمل وصار يرسل لهما القليل من المال والرسائل.
لكنه لا يعود، ويموت الأب “بخيت” دون أن تتكحل عيناه برؤية ابنه… وتغرق الأم وابنتها في الحزن، ويرثيانه، رفقة النائحات، بأهازيج جنائزية
” كتب الكتاب يا ليتني شفته
كسرت القلم والحبر نشفته
كتب الكتاب يا ليتني رأيته
كسرت القلم والحبر كبيته”
كان يمكن للحكاية أن تنتهي هنا، بمنطق الحزن والانتظار، لكن الحياة، كما يبدو، ليست خاضعة للمنطق. فالشيخ الذي كفّن بخيت بالأمس، جاء اليوم ليطلب يد فهيمة للجبالي الحداد، ترسل حزينة تستشير مصطفى لتأخذ رأيه وتستأذنه. وهنا تبدأ الرواية بكتابة فصل جديد من حياة الكرنك، كأنه لا علاقة له بما سبقه.
تتزوج فهيمة من الجبالي، وتكتشف عجزه الجنسي، فتخبر أمها، التي تحاول البحث عن حل لهذه المشكلة ضمن عادات وتقاليد الكرنك، إذا لا يجوز للفتاة بعد الزواج أن تبقى طويلاً بلا حمل، فالمجتمع لا يعترف بعجز الرجل، ومنعاً لأي كلام تعرض ابنتها أولاً على الشيخ هارون(9)، ولكن بعد فشله، تقرر عرضها على حارس المعبد على أمل أن “تحبل”. فينجح الأمر، ويتحقق الأمل ولكن ليس بفضل الحداد، بل على يد حارس المعبد لتنجب فهيمة ابنة جميلة تسميها فرحانة (في الرواية اسمها نبوية)، لكن الجبالي، مدرك عجزه، يرفض هذه الطفلة \ “الخديعة”، فيطلق فهيمة ويتزوج من امرأة أخرى. تصاب فهيمة بالحمى وتتمدد قرب أمها بانتظار الموت، فتصرخ “حزينة” كأنها تخاطب الموت: لا … لا.. إنها لا ترحب بك، لكنها صغيرة، غير قادرة على مواجهة الألم، إنها لا تريدك لكنها تريد للعذاب أن ينتهي، وللجسد أن يستريح… إنها حمقاء لا تعرف أنك الموت.
تكبر فرحانة وتبدأ العمل في بيت الشيخ فاضل، حيث يعيش معه ابنه، وهو في مثل عمر فرحانة، وكما لا يمكن لأي قوة لأن تعاند الأقدار، تبدأ شرارة المراهقة تشتعل بينهما، وتبدأ الكوابيس تطرق رأس “حزينة” لكنها سرعان ما تطردها سريعاً متمسكة بفكرة أن الشابين تربيا معاً مثل الأخوة.
وحدها عمة فرحانة والدة السعدي كانت تنظر لأبعد مما تراه حزينة. وتفهم ما يخفيه الصمت وما تقوله الأجساد.
في تلك الأيام، يعود مصطفى من اغترابه وحيداً خالي الوفاض، لا زوج ولا أولاد ولا مال، كل ما في جعبته حكايا شاب مغترب يكذب أكثر مما يمكن أن يقوله عجوز ماتت أجياله، فافتتح مقهى صغير في البلدة يؤمن قوته وقوت أمه وابنة أخته التي منعها من العمل في منزل الشيخ فاضل.
صارح السعدي أمه بحبه لابنة خاله ورغبته في الزواج بها فزجرته لعلمها أن فرحانة لا تشبهها ولا تشبه الجبالي، لكن السعدي لا يعلم ولا مصطفى يعلم، فيمضي السعدي إليه يطلبها منه فيرفض هذا الأخير ويسخر منه بقوله إن هذا يمكن أن يحدث في حالة واحدة فقط بعد موته، أي مصطفى، وبعد موت جدتها هذا إن قبلت هي. فيهيم السعدي مثلما هام من قبله مجانين العشق من العرب، ويتبدل حاله ويقسم أن يخطفها لو بقي له يوم واحد من عمره.
ويقع المحظور حين يراق ماء الحياة في أحشاء فرحانة فيتحول إلى جنين يبدأ في التخلق.
وهنا تظهر “حزينة” بوجه جديد.
هذه المرأة التي قضت طوال الأحداث كظل أفقي، محايد، يدور في فلك الآخرين دون أثر، تتحول فجأة إلى بركان مؤقت، ينفجر لأداء وظيفة محددة، ثم يعود إلى خمود. تكشف لابنها الحقيقة، فينهال على الحفيدة ضرباً وركلاً، ويحاصرها بالجوع والعطش، طالباً منها أن تفصح عن اسم الفاعل. وعندما تصمت، يدفنها في التراب، ويُبقي رأسها فقط في الهواء.
يصل السعدي، وقد أصبح “مطعونًا” في شرفه، فيُخرج فرحانة من الحفرة، ويأخذها إلى “الطاحونة”(10) ويقتلها هناك، ثم يحمل رأسها إلى خالها مصطفى.
ينتهي الفيلم بانفجار “مصطفى البشاري”. ثورة داخلية، غاضبة، يزعم أنها ضد أهالي قريته، لكنها ليست إلا ثورة على جرح ذكورته، لا على الجرح الأعمق لإنسانيته. هي ثورة أنانية، لا ترى في فرحانة سوى شرف مهدور، لا حياة مسلوبة. ثورة يزعم فيها أنه يسعى لكسر الأطواق التي تكبله والتخلص من الأوهام التي عانى منها طيلة حياته.
صرخته الأخيرة (11) في الرجال المجتمعين حوله مطالباً بالتغيير تختصر المقولة النهائية لرؤية المخرج للمجتمع المصري من خلال
رؤية سينمائية تترجم العمل الروائي إلى سرد بصري مكثف، يتكئ على البنية الميلودرامية المأساوية، على النمط الإغريقي، ليمنح الحكاية عمقاً إنسانياً يتجاوز حدود القرية أو الإقليم. وتحويل هذه المعاناة إلى “فعل سينمائي” قوامه الموروث الميثولوجي الشعبي والديني للبيئة التي تحتضنها أحداث القصة، حيث يمثل الظلم الاجتماعي أبرز سمات التأويل الذكوري للدين والتقاليد والعادات السائدة. فموت فهيمة وابنتها فرحانة لا يعود إلى “معصيتهما” بل إلى الفهم الخاطئ للتأويل الديني وللجهل والخرافة. وليس موتهما سوى استمرار لهذه العادات عبر الأجيال المتعاقبة. فعقدة العار التي ترافق فهيمة بسبب فعلتها مع حارس المعبد تنتقل إلى ابنتها فرحانة وتتضاعف بفعل الصمت والخوف. والمعاناة التي عاشتها فهيمة وفرحانة هي امتداد لمعاناة حزينة التي كانت شاهدة على مرض زوجها وموته واغتراب ابنها وتجربته الفاشلة. فهؤلاء ثلاث نسوة يمثلن ثلاثة أجيال متعاقبة تعرضن للظلم من مجتمعهن. وبديلاً عن التعاطف معهن تحولت حياتهن إلى مرض وموت وقتل.
في تجربة سردية تمتد عبر ربع قرن، نتابع مصير ثلاث نساء ينتمين إلى ثلاثة أجيال، عشن في ثلاثينيات القرن الماضي داخل قرية مصرية منسية. كل واحدة منهن تجسّد وجه من أوجه القهر والتهميش، وتكشف عن طبيعة العلاقة المركّبة بين المرأة والجسد والسلطة والقدر.
“حزينة” الأم، نموذج تقليدي للمرأة التي تتقبل قدرها وتكرس حياتها لخدمة الذكور. ورغم قوة ما تمتلكه من رمزية الأمومة، إلا أن حضورها يتلاشى تدريجياً في مجتمع يرى في المرأة عنصراً ثانوياً، ويقصيها عن المساهمة الفاعلة في بنائه. موتها البطيء لا يعكس فقط خفوت حضورها، بل يشير إلى احتضار مجتمع بأكمله، لا يعترف بدور المرأة كعنصر فاعل في التغيير
“فهيمة” الابنة، يحمل جسدها صراعاً بين الرغبة والعبودية. زواجها من “الجبالي”، الرجل العاجز عن تلبية احتياجاتها النفسية والجسدية، يتحول إلى صورة من صور الاغتصاب الرمزي للمرأة في مجتمع تحكمه سلطة الذكور (الأبناء والآباء)، ليبقى النظام الأبوي هو المهيمن على خيارات المرأة، فيما يواصل فرض سطوته على أجساد النساء ورغباتهن.
أما “فرحانة”، الحفيدة، فتظهر تمرداً فطرياً، غير واعٍ على معايير المجتمع، وتجسد هذا التمرد من خلال حملها خارج إطار مؤسسة الزواج. وإذ حاولت -من خلال تمردها-التخلص من القيود المفروضة عليها، لكن المجتمع لا يغفر لمن يخرج أن أعرافه، فيقضي عليها، بأن يقتلها في نهاية المطاف ويعيد هيبته وسلكته، حتى لا تتهدد رموز استقرار الهياكل التقليدية التي تحكمه.
تجربة تذكرنا بأجيال ثلاثية نجيب محفوظ الشهيرة التي تناولت تحولات الطبقة الوسطى. وإذا كانت ثلاثية محفوظ تناولت بصورة واقعية التطور الاجتماعي والسياسي لمجتمع المدينة، فقد انتقلت “الطوق والإسورة” \ الرواية والفيلم، بالمشهد -في تصوير شديد الواقعية- إلى قرية تعيش على هامش الزمن، حيث لا يقع التركيز على التحولات السياسية والاجتماعية، بل على القلق الإنساني، والخوف الوجودي، والتردّد، والسلبية، والفرار من المغامرة. فالواقع الإنساني ميدان رحب للتعبير عن المشاعر المختلطة التي يمر فيها الأفراد لا سيما فيما يتعلق بحالات القلق والخوف الذي يدفع للترقب والانتظار والغرق في السلبية والجبن وتحاشي المغامرة و”الثورة”.
في هذا السياق، يصبح الوجود الإنساني ساحة للترقب والانتظار والخوف من المجهول، حيث يخشى الناس -عموماً- الموت باعتبار أن قدومه سوف يهدم كل ما بنوه وعملوا على إنجازه في حياتهم، فهو إذن تهديد دائم لمنجزهم، يكمن في تفاصيل الحياة اليومية. فالأم التي تراقب جسد طفلتها كيف ينمو وتتفتح فيه براعم الشهوة يوماً إثر يوم تخشى على هذا الجسد من “العابثين” المتربصين، خاصة أن الابن الحامي، في ظل مرض الأب وعجزه، غائب في رحلة لا يعلم أحد متى ستنتهي. أما القرية فلا يبدو أنها تكترث لمخاوف الأم، بل كل ما يشغل أفرادها هو النظر في “المصيبة” التي سوف تحيق بهم، إذ جلب أحد البقالين طاحوناً قديمة سوف تكون مصدر رعب لهم وسوف يأتي من يقول لهم (لا أحد بالضبط يعلم من قال ذلك أول مرة) إن هذه الطاحونة لن تعمل إلا بلحم أطفالهم. في تعبير غريزي مروّع عن خوف جماعي من الحداثة، ورفض لكل ما هو جديد. وكأن الجديد لا يأتي إلا بالكوارث، وأن أي مشروع للتجديد لا بد من أن يُغذّى بالتضحيات البريئة.
هنا يأخذ العنوان “الطوق والإسورة” بعداً رمزياً مزدوجاً. فبعيداً عن دلالات الطوق والإسورة الجمالية كأدوات زينة أنثوية، يكشف عن القيد الذي يطوّق الأعناق ويقيّد الأيدي والأجساد وتمنعها من التحرر. يلتف “الطوق” حول رقاب النساء والرجال، في حين تمثّل “الإسورة” عجزاً يجعل المجتمع غير قادر على الحركة والتفكير الحر(12). إنها صورة قاسية لمجتمع يعيش في دائرة مغلقة من التخلف والجمود. يسكنه خوفاً شديداً لأي شكل من أشكال التمدن والحداثة.
والكاتب -بعكس المخرج- وجد الحل للطوق والإسورة باختياره لغة رومنسية من خلال الإهداء الذي وضعه في مقدمة الرواية: “للشجر المورق العالي، وللريح المغنية وللإنسان على الأرض ذات الخير في قوته وفي ضعفه”. كأنما يريد أن يستعيد شيئاً من الأمل، دون أن يقدّم حلاً حقيقياً لمستقبل “الكرنك”. في حين يذهب الفيلم إلى ما هو أبعد من هذه النقطة بذكاء أكثر وبعمق. فهو لا يمنح المشاهد أي حلول جاهزة، ولا يبيع الوهم، بل يقدّم واقع القرية بمرارة، ويدع للمشاهد حرية اكتشاف العطب، وربما البحث عن الخلاص. وهي ميزة -باعتقادي- تحسب له، لا عليه حين يبتعد عن التفاؤل السطحي والصيغ التعليمية والأساليب التلقينية التي نراها في بعض أفلام المدرسة الواقعية. فالفيلم يقدم مجتمع الكرنك من وجهة نظر قاسية دون مواربة ودون خجل أو نفاق أو رياء، ولا يخشى خيري بشارة من سوء فهمه لأنه يراهن على ذكاء المتلقي في استقبال رسائله المتعددة واكتشاف الخلل والبحث عن الحلول- المشاهد وليس المخرج- المناسبة لتفكيك بنية التخلف في النظام الاجتماعي وكل هذا ضمن سياقات فنية ناجزة وجماليات بصرية صارت نادرة الآن في السينما المصرية.
والفيلم بصورة عامة، وضمن هذا السياق، يمتاز بإيقاعه البطيء والهادئ المتناسب مع مكانه وزمانه وحكايته المليئة بلحظات الانتظار الطويلة، وحتى عندما يعود مصطفى من غربته بعد كل هذا الغياب فاشلاً وأميّاً دون أن يحقق أي شيء سيجد أن القرية أيضاً لم تحقق شيئاً يذكر وكأنه لم يمر عليها حينٌ من الزمن فيصرخ بألم “الواحد منا يسافر… يسافر…والغربة تفك قيوده، فيتحرر من الطوق، يكبر ويوعى ويقطع السلاسل… ولما يرجع لداره…لناسه… يكتشف الوهم…الأساور في اليد أقوى من زمان… والطوق على الرقبة أضيق من زمان…والجذور هنا، الجذور قوية ومادّة في الناس”.
صرخته الأخيرة تجسّد خيبة الوعي بعد اليقظة، والصدمة التي ترافق العودة إلى الجذور حين تُكتشف القيود وقد ازدادت غلظة. فالجذور، هنا، لا تعني الانتماء فقط، بل لعلها تعني أيضاً الارتهان، فهي الذاكرة، والخوف، والاستسلام، وهي التي تحول دون أي تحرر حقيقي.
ونظراً لتشابك الرواية الأصلية مع ذات الكاتب حتى تكاد تبدو كأنها جزء منه، كان على المخرج التقاط هذه الزاوية الحساسة في معالجته السينمائية. وإلا كانت ستفقد تلك “الحميمية” التي أراد لها الكاتب أن تظهر. فالمعالجة الدرامية للسرد النصي دون الإحاطة بتلك الذاتية ستنتج فيلماً ربما يكون جيداً من الناحية التقنية، لكنه لن يكون أميناً لروح النص. ولهذا السبب، اختار المخرج ابتكار لغة سينمائية خاصة توازي اللغة السردية في تشابكها، وتنغمس في الحكاية دون أن تبتلعها.
فجاء الفيلم أميناً لما أراده يحيى الطاهر عبد الله، نادى بأن “داخل بلادنا بلاد” وداخل عوالمنا ثمة عوالم أخرى مضمرة، فقدم بشارة لنا لوحة عن “الذي لا نعرفه”، فبتنا ليس نعرفه فقط بل لن ننساه قطعاً.
فالكرنك وأهلها في التحليل الأخير صورة مختصرة ومكثفة عن مصر، فالرواية تتحدث، وإن لم تشر إلى ذلك مباشرة عن زمن الاحتلال البريطاني وسقوط فلسطين وهزيمة مصر هناك. وإذن، القرية كناية عن وطن عاجز، يقيم في الفشل من شدة خوفه منه، عجز شباب القرية عن المواجهة فاضطروا للاغتراب والهروب للأمام وترحيل مشاكلهم للمستقبل وللأجيال القادمة وحين عودتهم استمر عجزهم متجذراً بعدم قدرتهم على التغيير.
الكرنك أيضاً تجسيد لآباء فاشلين يعشش في عقولهم الجهل ويسيطر عليهم خوفهم، فيموتون موتاً رخيصاً ومنسياً، وتجسيداً لشباب فاشل لم يستطيعوا الدفاع عن حبهم، ولم ينجحوا في إقناع محبوباتهم، فتحولوا إلى أدوات طيعة للعادات وللشيطان. فينتفض الواحد منهم لـ “شرفه المطعون” ليرتكب جريمته البشعة بقتل فتاة بريئة باسم الرجولة.
وهي أيضاً كناية عن أم لا ذنب لها في عدم الإنجاب، تموت بين يدي أمها العاجزة بدورها عن إنقاذها، فتترك طفلة تكرر تجربتها ومأساتها وموتها، في دورة لا تنتهي من الألم والموت
هذه السلسلة من الهزائم والعادات البالية والعجز والأخطاء المتكررة عبر الأجيال لا يسوقها بشارة من باب جلد الذات أو الانتقاص من قيمة وكرامة بلده، بل برسمها دقة، ليحدث صدمة واعية على أمل أن تصل رسالته للمتلقي، فيلجأ إلى صياغة حبكة غير تقليدية عبر آلية التكرار والتناسخ كأداة فنية تعكس الركود الفج للمجتمع وثباته عند نقطة الفشل.
لا تسير هذه الصياغة في خط سردي واحد، بل تركز أكثر على التفاصيل، وتمنح كل مشهد بعداً رمزياً خاصاً. مثلما هو حالة “العجز” التي عبر عنها الفيلم بأكثر من لوحة وبأكثر من شخصية: “الجبالي غير القادر على الإخصاب، بخيت المشلول، مصطفى العاجز عن الفهم أو الحل، حزينة العاجزة عن حماية حفيدتها، وفرحانة التي عجزت عن حماية جسدها وحياتها، وفهيمة التي لقيت ذات المصير… إلخ”.
لكن التركيز في هذه التفاصيل وتلك الرمزية أتى على حساب التطور الزمني للشخصيات، فأهملت مراحل مفصلية في حياتها. بما يقلل حتماً من مساحة الخيال وفعاليته لدى المتلقي، ولم يكن لهذا الخيار أن يضعف البناء الدرامي للفيلم، بل لنية مقصودة في إبراز “المعنى” بدلاً من “السرد”، بل إلى تجسيد وعيها، وفهم امتداداتها السيكولوجية، ومواقفها.
وهكذا نجد فرحانة امتداد لفهيمة في المصير والتجربة، وليس من قبيل الصدفة أن يسند المخرج لشيريهان دور فهيمة وفرحانة. وكذلك مصطفى، الذي هو صدىً لأبيه بخيت العاجز، يتقاطع معه في الدور وفي القدر، وهنا أيضاً اختير عزت العلايلي لأداء كلتا الشخصيتين. وهناك السعدي الذي هو امتداد غير مباشر لخاله والد فرحانة، فكلاهما انتهى بفعل عنيف، فالخال حرق نفسه مع زوجته الجديدة كي لا يفتضح أمر عجزه وابن الأخت قتل ابنة خاله بوحشية.
يشكّل الفيلم، كما النص الأدبي الذي استند إليه، وثيقة سردية فريدة عن مصر المهمّشة في النصف الأول من القرن العشرين. فهو لا يقدّم الفقر كخلفية بل كبنية حياتية متكاملة، تعكس أنماط السلطة الأبوية، والحرمان الطبقي، والانغلاق الثقافي. وقد نجح المخرج، من خلال رؤيته المستندة إلى الواقعية الجديدة، في تحويل هذه البنية إلى لغة سينمائية رصينة، امتزجت فيها العناصر التراثية بالتعبير الرمزي، فجعل من الجسد الأنثوي، ومن الطفولة، ومن المرض، مفاتيح تأويل لحالة وطنية أشمل.
وإذا كان يحيى الطاهر عبد الله قد التفت إلى “مصر الأخرى” التي تعيش على هامش الخطاب الرسمي والتاريخ المديني، فإن أهمية هذا المشروع تزداد اليوم، في ظل إعادة تعريف الهوية الثقافية والاجتماعية(13).
إن استعادة الطوق والأسورة لا تندرج في إطار النوستالجيا أو الحنين إلى “الأصالة”، بل تمثّل ضرورة معرفية لفهم جذور التفاوت الاجتماعي والثقافي، وتفكيك البنية الذهنية التي أعادت إنتاج الإقصاء لعقود طويلة.
يقدم “الطوق والإسورة” السينما كفن ملتزم، حيث تلتقي الجماليات البصرية بالرسالة الاجتماعية، مما يسمح بفتح آفاق التحليل لتشمل البعد التاريخي، من خلال توثيق حقبة مفصلية في تاريخ الصعيد. والبعد السياسي، لجهة نقد التهميش المنهجي للريف. إلى جانب البعد الجمالي الذي يبتكر لغة سينمائية تزاوج بين التراث والحداثة. هذه الرؤية الشمولية تجعل من الفيلم، في اعتقادي، نصاً مؤسساً لسينما عربية لا تخشى مواجهة الموروث الاجتماعي بجرأة. فهو قصة مصر المنسية، قصة شريحة واسعة لا تملك صوتاً ولا تمثيلاً، رغم ذلك قادرة على إنتاج الرمز والمعنى.
ورغم كل الإغراءات التي يمكن أن يقدمها النص، لم ينزلق الفيلم نحو الميلودراما، بل استخدم الكادرات الطويلة والوجوه الحقيقية واللغة القروية ببساطتها، ليعيد إنتاج لغة يحيى الطاهر عبد الله السينمائية. اللغة التي تمزج الغنائي بالحسي، والتي تعرف أن “الحكاية” هي سيدة الموقف، وأنها لا تحتاج إلى إثقالها بالتقنية أو الافتعال. في المقابل كانت الشخصيات تتحرك في فضاء شبه مغلق، مثل الأرواح في حكايات القرى المخيفة، أرواح تسير داخل حلم باهت لا نهاية له. الأزقة، البيوت المتهالكة، المعبد البعيد، الأغاني الشعبية، كلها عناصر تخلق مناخاً أسطورياً رغم واقعيتها. وقد يكون هذا المناخ تحديداً هو أكثر ما يميز يحيى الطاهر عبد الله: تلك القدرة على تحويل البسيط والمألوف إلى أسطورة محلية، إلى سردية كبرى تختصر شعباً ومرحلة.
لم يكن يحيى يبحث عن القارئ، بل عن المستمع، ولم يكن يحلم بالكتب على الأرفف، بل بالكلام في الفضاء المفتوح، بالكلمة الحية التي تقال وتنتقل وتعيش. وربما كان هذا ما أضاعه أيضاً. فقد عاش بين زمنين: زمن الرواية المكتوبة، وزمن القول الشفاهي، ولم يجد له مكاناً ثابتاً في أيٍّ منهما.
الزمن المطلق يبدو عاجزاً في الكرنك حين نراه يلبث هناك ثابتاً مقيماً دون حركة وهذا ما ينعكس على سكانها أيضاً. كان الصمت في “الطوق والأسورة” أبلغ من كل صراخ. ليس لأن الكلمات عجزت، بل لأن الكلمات نفسها كانت رفاهية لا يملكها من يعيش في القاع.
لم تكن المرأة في الرواية والفيلم شاهدة على ألم العائلة فحسب، بل كانت مرآة لحال مصر الأخرى، مصر المنسية والمحبوسة في أطراف الذاكرة. وحين التقطها خيري بشارة بعين واقعية لم تكن هذه العين تُجمل الفقر أو تتسوّل التعاطف، بل أعادت للفقراء لغتهم المسلوبة: لغة النظرات والأنين، لغة النساء اللواتي لم يكتبن تاريخهنّ بل عشنهُ داخل أجسادهنّ. وما زالت الحكاية معلّقة.
ولعلنا لا نزال ننتظر من يكمل هذا القول الناقص، من يعيد للحكاية لُغتها الأصلية، من يسمع الصوت الخافت القادم من الجنوب، ويرد عليه بالفعل وليس بالتأمل.
وتتعزز فكرة الزمن الساكن حين عودة مصطفى ويلحظ عدم التغيير فيقول “عشرين سنة… عشرين سنة وأنا متهيأ لي هارجع وأقول سبحان مغير الأحوال، لكن لقيت الحال هو الحال، عايشين ع الرغي والحديت والقيل والقال”، فالكرنك كما هي منذ الفراعنة لم تتغير: يروح بشر ويأتي غيرهم، تموت لغة وتنهض أخرى، يختفي دين ويأتي بديله…كل هذا والزمان جامد مثل حجارة المعبد. ملل وضجر ورتابة وكهنة ودجالين وشيوخ وإقطاعيين واستعمار وتجار، وأطواق وأساور، جميعهم يساهم في بقاء الكرنك دون تغيير، جميعهم يجعل أهل الكرنك يؤمنون فعلاً أن الطاحونة لن تعمل ما لم يلق في جوفها طفل، أليس هذا ما يؤمن به أهل الكرنك في بداية الربع الثاني من القرن العشرين؟..
وربما ما زالوا.
…
- أستعير تشبيه المرآة وفي ذهني ما قاله “أندريه تاركوفسكي” في كتابه “النحت في الزمن”: “عندما أنهيت تصوير فيلمي المرآة، تلاشت فجأة ذكريات الطفولة التي ظلت لسنوات تقلقني وتسلب مني الطمأنينة. لقد ذابت هذه الذكريات ولم أعد أحلم بالبيت الذي عشت فيه قبل سنوات طويلة. فيلم المرآة هو أيضا قصة البيت القديم الذي أمضى فيه الراوي طفولته. وتلك المزرعة التي شهدت ولادته، و فيها عاش أبوه وأمه. الفيلم كان يهدف إلى إعادة بناء حياة الأفراد الذين أحببتهم كثيرا و عرفتهم جيدا. أردت أن أروي قصة الألم الذي عاناه رجل لأنه يشعر بأنه لا يستطيع أن يعوض عائلته مقابل كل ما منحوه و بذلوه له، يشعر بأنه لم يحبهم بدرجة كافية.. وهذه الفكرة تعذبه وتعصر قلبه. ما إن تبدأ في التحدث عن أشياء أثيرة إلى نفسك، فإنك على الفور تشعر بالقلق حيال كيفية تفاعل الآخرين تجاه ما تقوله، و أنت ترغب في حماية هذه الأشياء، أن تدافع عنها ضد حالة اللافهم أو عدم الإدراك. فيلم المرآة لم يكن محاولة للتحدث عن نفسي على الإطلاق. إنه عن مشاعري تجاه الأفراد الذين أحببتهم، عن علاقتي بهم، إشفاقي الدائم عليهم، وكذلك عن إحساسي بالواجب الذي لم استطع تأديته. الأجزاء التي فيها يتذكر الراوي، في لحظة بالغة من الأزمة، تسبب له وجعا حتى اللحظة الأخيرة. . تملؤه بالحزن و القلق.”
يفتح هذا النص العميق لتاركوفسكي باباً لفهم تشبيه “المرآة” ليس كأداة تعكس الواقع، بل كوسيلة تلتقط الزمن الداخلي، بما يحمله من مشاعر، وندم، وحنين، وواجبات مؤجلة. حين يقول إن فيلم “المرآة” لم يكن عن نفسه بل عن مشاعره تجاه من أحب”، يصبح واضحاً أن الفيلم ليست صورة، بل صدى. وحتى عناصر السيرة (البيت القديم، المزرعة، الأم، الأب، الطفولة، الذكرى( ليست مجرد عناصر، بل كيانات روحية تعيش في الزمان الشخصي- ناهيك عن الزمن التاريخي-. وهذا الزمن الشخصي، كما يصوّره تاركوفسكي، لا يُقاس بالسنوات بل بالندم، بالفقد، بالإشفاق، وبالشعور بالتقصير. فما يذيب الذاكرة ليس النسيان، بل التعبير عنها فنياً. وكأن الذكرى تحتاج أن تُروى كي تتحرر من صاحبها. يظهر الحنين عند تاركوفسكي ليس رومنسياً، بل مؤلماً ومثقلاً بالشعور بالواجب الأخلاقي تجاه من أحبّهم، وهو واجب لم يُنجز، أو لا يمكن إنجازه بعد الآن. من هنا يمكن قراءة تشبيه المرأة في “الطوق والأسورة” كمرآة شبيهة، لا تعكس وجه الواقع فحسب، بل وجه الغائب، والمقموع، والمُحبّ، والذي لا صوت له. كما أن الزمن الساكن في الكرنك يشبه زمن “المرآة” الداخلي، حيث لا تغيّر حقيقي بل تعاقب صور الندم والأسى، بينما يظل الجرح مفتوحاً.
- في شارع طلعت حرب، وفي مكان ليس بعيداً عن ميدان التحرير يقع “مقهى ريش” في قلب “القاهرة الخديوية” التي أراد لها الخديوي إسماعيل أن تكون “باريس الشرق”. مقهى عريق بني في بداية القرن العشرين على أنقاض قصر محمد علي باشا ليصبح أكبر وأشهر تجمع للمثقفين والسياسيين ليس في مصر فحسب بل في المنطقة العربية بأسرها وقد أخذ اسمه تيمناً بأشهر مقاهي باريس ” كافيه ريش”. كان المقهى ملتقى الأدباء والمثقفين أمثال: نجيب محفوظ، يوسف إدريس، أمل دنقل، معين بسيسو، يحيى الطاهر عبدالله، محمد الفيتوري، صلاح جاهين، عبدو الوهاب البياتي، نجيب سرور( الذي كتب عن عوالم المقهى في ديوانه الشهير بروتوكولات حكماء ريش)[ في مفارقة ساخرة تحاكي “بروتوكولات حكماء صهيون”، ليفضح التواطؤ والفساد داخل الطبقة المثقفة ذاتها.]، أحمد فؤاد نجم (الذي غنى له الشيخ إمام عدة قصائد عن مقهى ريش) وجمال الغيطاني.. وغيرهم. في هذا المقهى، تشكلت معالم ثقافة الستينيات والسبعينيات، لا بوصفها مشاريع فكرية مجردة، بل كصراعات يومية على الطاولات، بين القصائد الساخنة ونشرات الاعتقال. كان ريش مساحة لوعيٍ مأزوم، مثل القاهرة، حيث تتقاطع السلطة مع الهامش، وتتداخل الثورة مع القمع. تعرض المقهى للإغلاق المؤقت في عهد السادات بعد زيارته للقدس وتوقيع اتفاق السلام مع إسرائيل. لم يكن الإغلاق مجرد إجراء أمني، بل كان علامة على انكسار حقبة كاملة، ضاعت فيها الحوارات، وتبعثرت أوراق الشعراء.
- يحيى الطاهر عبدالله من أبرز أدباء مصر في الستينيات, ولد في الكرنك- تلك القرية التي تحمل اسم معبدٍ خالد- في محافظة الأقصر سنة 1938، لكن يحيى لم يكتب على جدران من حجر، بل على ورق هش، تمزّقه الريح كما مزّقته الحياة. هو ابن الجنوب، ابن الحقول والعرق والقصص الشفوية. قدم إلى القاهرة في العام 1964، لكنه لم يذب فيها مثل غيره، بل ربما أضاف إليها شيئاً لم تعرفه من قبل: حكاية الجنوب بلغة الشمال، وسرد الهامش بصوت المركز. كانت تربطه علاقات صداقة قوية بالشاعرين عبد الرحمن الأبنودي وأمل دنقل، أقام في حي بولاق الدكرور في القاهرة مع عبد الرحمن الأبنودي الذي سبقه في الانتقال إليها. وتلك وحدها قصة: شابان من الصعيد، يحملان لغة لا تنتمي إلى صالونات القاهرة، يحاولان أن يشقّا طريقًا وسط ضجيج السياسة وعنف المدينة.
أنهى في بولاق الدكرور بقية مجموعته القصصية الأولى “ثلاث شجيرات تثمر برتقالاً” (1970).
وكتب العديد من المجموعات القصصية مثل “الدف والصندوق” (1974)، “أنا وهي وزهور العالم” (1977)، “حكايات للأمير حتى ينام” (1978)، وله ثلاث روايات قصيرة: “تصاوير من التراب والماء والشمس” (1981) و “الحقائق القديمة صالحة للدهشة” (1977) و “الطوق والإسورة” (1975) وهي أشهرها، وترجمت إلى الإنكليزية والفرنسية والإيطالية واليابانية والألمانية والبولونية. وله مجموعة “الرقصة المباحة” التي نشرت بعد موته ضمن أعماله الكاملة التي أصدرها أصدقاؤه عن دار المستقبل بالقاهرة سنة 1983 وقد نفدت هذه الطبعة من الأسواق منذ سنوات طويلة، وفي العام 1993 صدرت الطبعة الثانية، ثم طبعة ثالثة سنة 1998.
يذكر أن يوسف إدريس قدمه في مجلة “الكاتب” ونشر له مجموعة “محبوب الشمس” بعد أن قابله واستمع إليه في مقهى ريش. كما قدمه عبد الفتاح الجمل في الملحق الأدبي بجريدة المساء مما أسهم في بروزه كأشهر كتاب القصة القصيرة في مصر. مما يذكر عن سيرته، صدور أمر اعتقال بحقه في العام 1966 رفقة مجموعة من الأدباء والمثقفين رغم أنه لم يعرف له أي نشاط سياسي يثير قلق السلطات، فهرب مدة قبل أن يقبض عليه، ثم أطلق سراحه في نيسان1967. (لعل السلطة شعرت أن من يكتب بهذا الصدق لا بد من أن يكون خطراً، حتى وإن التزم الصمت). توفي يحيى الطاهر عبد الله في العام 1981 إثر تعرضه لحادث سيارة ودفن في قريته الكرنك.
4.القرية هنا ليست مجرد موقع، جغرافيا قاسية تنتج الوعي وكيان حي يعكس هذه القسوة وتأثيرها. فالجغرافيا هنا ليست خلفية ثابتة، بل فاعل رئيس في تشكيل وعي السكان. وفكرة “طريق الكباش” المحفورة في ذاكرة القرية وسكانها، لا تشير إلى فخر “فرعوني” خالص، بل إلى أسطورة عقابية، يتحول فيها البشر إلى حجارة لانتهاكهم المحارم. هذا التحول يرمز إلى تكلّس المجتمع المصري في تقاليده الاجتماعية، أكثر منه استعارة جمالية أو شعرية، فالمجتمع الذي يجمد نفسه في تقاليده خوفاً من “الحرام” سوف ينتهي متحجراً كالكباش.
يوظف يحيى الطاهر عبد الله هذا التصور لفضح تواطؤ الحاضر مع الأسطورة، حيث يستعيد المصري، في وعيه الجمعي، رموز السيطرة والعقوبة بدل التحرر والانعتاق. فرغم العظمة المعمارية، يسكن الداخل خوفاً وتوجساً، حيث تتحول التقاليد إلى أصفاد. بهذا، تخرج الكرنك من موقعها الجغرافي، وتتحول إلى مرآة للانقسام المصري: بين أن يكون ابن حضارة عظيمة أو أسير خرافاتها الاجتماعية.
- يعتقد البعض أن رواية “الطوق والإسورة” التي ظهرت مكتملة سنة 1975، ظهرت ملامحها الأولى، قبل عام من ذلك، في عملين سابقين ضمن المجموعة القصصية “الدف والصندوق”. الأول بعنوان “الشهر السادس من العالم الثالث” والثاني بعنوان “الموت في ثلاث لوحات”. ويعكس كلا النصين موضوعة أساسية سيعود إليها الكاتب مراراً، وهي الاغتراب. وهذا النفي القسري –أو الخروج من الجغرافيا الأصلية– لا ينتج انفصال جسدي فقط، بل يعمّق الجرح النفسي، ويحوّل الغياب إلى لعنة تحل على من بقوا في القرية. الموت المتسلسل داخل الأسرة، كما تصوره القصتان، هو موت رمزي للنسيج الاجتماعي، الذي ينهار حين تُنتزع منه روابطه.
ويبدو أن هذه الفكرة استهوت الكاتب وسيطرت عليه وأغرته بمتابعة تطور شخصية هذا المغترب، بمزيد من التفاصيل، وتطور أسرته أثناء غيابه وبعد عودته، وتعميق التوتر الدرامي بين الحضور والغياب، بين الطوق الذي يقيد، والإسورة التي تزيّن لكنها أيضاً تطوّق، فكان أن خلق “الطوق والإسورة”. لتظهر على هيئة مشروع أنثروبولوجي وسردي في آنٍ معاً، تستنطق الماضي ليس بهدف تأبيده، بل لنقد تمثلاته الحديثة. حتى أن بناء شخصيات الرواية (من قصص أخرى) إنما يشبه بناء المعابد على أنقاض القرابين القديمة.
6.ولد خيري بشارة عام 1947، وتخرج من المعهد العالي للسينما بالقاهرة عام 1967. ثم ذهب في بعثة دراسية إلى بولندا، وهناك تتلمذ على أيدي كبار السينمائيين البولنديين، وعلى الأخص المخرج أندريه مونك الذي كان عميداً لمعهد لودز السينمائي الشهير حيث درس خيري. كما عمل مساعداً للمخرج البولندي الكبير كافاليروفيتش. وعاصر عدداً من أبرز السينمائيين البولنديين مثل أندريه فايدا وسكوليموفسكي وزانوسي وغيرهم. هذه التجربة منحته حساسية خاصة تجاه السينما بوصفها فناً إنسانياً لا تجارياً، وفتحت أمامه أبواب الواقعية الجديدة، والميل إلى التجريب بعيداً عن السينما التلقينية أو البكائية.
كانت بداياته من خلال السينما التسجيلية خاصة مع إنشاء المركز القومي للأفلام التسجيلية في العام 1967، وبعدها أصبحت الفرصة متاحة للإعلان عن جماعة السينما الجديدة والتي كان خيري أحد أعمدتها.
من الأفلام التي قام بإخراجها الأقدار الدامية- 1982، العوامة رقم 70 – 1982، الطوق والإسورة- 1986، يوم مر ويوم حلو- 1988، كابوريا – 1990، رغبة متوحشة- 1991، آيس كريم في جليم – 1992، أمريكا شيكا بيكا – 1993، إشارة مرور – 1995، قشر البندق – 1995، ليلة على القمر، ومن المسلسلات التي قام بإخراجها أيضا مسألة مبدأ، ملح الأرض، الفريسة والصياد، ريش نعام وغيرها من الأعمال.
يقول عن فيلمه “الطوق والإسورة”: “ظننتُ أنّ فيلمي الطوق والأسورة فيلم شعبي «حيكسر الدنيا»، لأني كنتُ وقتها متمرد على السينما السائدة، وأريد أن أقدم شيئاً جديداً، لكن الناس تابعت الفيلم ونظرت إليه على أنه فيلم غريب لا أكثر من ذلك… أذكر أني وقتها صدمت وكدت أموت، ولم أتوازن إلا عندما ذهبتُ إلى فرنسا، واحتفى بي المخرجون العرب هنالك، عندها فقط بدأت استعيد معنوياتي… لا أستطيع أن أحكم على نفسي بأني أجدّد، وأغيّر، وأتمرّد.. وذلك ليس من واجبي”. للمزيد، انظر: الحوار المنشور في مجلة نزوى والذي أجرته معه الكاتبة والصحفية هدى حمد – تشرين أول 2012
ويكشف هذا الاعتراف عن التوتر بين الرغبة في “خلق سينما شعبية بديلة” وبين خيبة الأمل من جمهور لم يكن مستعداً لاستقبال هذا النوع من السينما، في زمن ما زال يقدّس الميلودراما النمطية. بم يكن سهلاُ على الجمهور قبول فيلم من نموذج مغاير غير مألوف وجريء وبطيء الإيقاع، يخلو من الزخرفة وينبني على منطق الانهيار البطيء للأسرة. هذه الخلفية الجمالية والمزاج الفني، ومحاولة الخروج من أسر النموذج السينمائي المصري هي التي دفعت بشارة لإخراج الفيلم، رغم ما قد تنطوي عليه من أخطار عدم التفاعل الجماهيري.
- خيري بشارة، الذي نشأ على التقاليد الواقعية، وجد نفسه لاحقاً يعيد تقويم مفهوم الميلودراما. ويستدرك هذا الأمر حين عبّر عن تأثره بإحدى مقالات د. على الراعي باعتبار الميلودراما ليست مجرد تهريج شعبي أو عاطفة زائفة، بل يمكنها أن تكون ثورية بطريقة ما، إن هي استُخدمت لكشف التناقضات الاجتماعية وتعريتها. وهذا ما جعله يتمنى لو أن فيلم “الطوق والإسورة” خرج على هيئة “ميلودراما شعبية” ليس بالمعنى التجاري الرخيص، بل بصفتها وسيلة تستثير وجدان المتبقي من خلال تكثيف المفارقة والمبالغة العاطفية، دون تزييفها. فالميلودراما- هنا- ليسن نقيض الواقعية، بل أحد أشكالها المباشرة وأشدها وقعاً
وتقوم الميلودراما، كمفهوم، على تضخيم المشاعر والتركيز، بل المبالغة، على المفارقات الاجتماعية لإحداث التأثير على المتلقي وإقحامه في صراع وجداني عنيف، باستخدام الحركات والانفعالات كمفاتيح تفسير للواقع، بدلاً من الهروب منه.
في “الطوق والإسورة”، لم يُنجز بشارة “ميلودراما تقليدية”، لكنه مزج بين بنية واقعية قاسية، وبين ميلودراما داخلية، تتجلى في الأداء، الصمت، والموت البطيء الذي يتسلل عبر الإطار. وما فعله هنا أشبه بمحاولة حفر سردي داخل طبقات الصعيد. حفر عميق في الوعي المتكلس ضمن الفضاء الجغرافي، حيث يمكن للميلودراما –حين تُنقذ من سطحيتها– أن تفجّره من الداخل.
8.تعد الميلودراما أحد التعابير الشعورية الفنية البارزة للمدرسة الرومنسية، وهي تعلي من شأن العاطفة على حساب المنطق، وتراهن على المفارقة والصدفة بعيداً عن التفسيرات العقلانية حيت تكون الصدفة المحرك الفعلي لمعظم الأحداث، فكما يأتي الحدث غامضاً وغير متوقعاً، كذلك يأتي الحل غامضاً وغير متوقعاً أيضاً.
وهذا لا يعني هذا انفصالها عن الواقع أو انفلاتها من البنية الدرامية المحكمة. فحين تتجلى الميلودراما في السينما، فإنها تمزج بين العمق النفسي والحبكة الواقعية، دون التخلي عن البُعد العاطفي المكثف الذي يحرّك الصور والمشاهد. إنها تتسلل إلى وعي المتفرج من خلال الاستثارة الشعورية والانفعال الصادق وليس عبر الوقائع. ولهذا السبب، يرى بعض النقاد أنها ليست شكلاً فجّاً من التأثير، بل وسيلة فعّالة لإثارة أسئلة عميقة عبر ما يبدو أنه شعور جارف أو مفرط. وقد التقط خيري بشارة هذا الخيط حين أبدى لاحقاً تأثره بمقالة للدكتور علي الراعي، التي دافعت عن الميلودراما بوصفها شكلاً “ثورياً” من أشكال التعبير الشعبي، وليس محض تهويم عاطفي. وهو ما جعله يعيد -كما أسلفنا أعلاه- تأمل “الطوق والإسورة”، ويتمنى لو أنه صنعه على هيئة ميلودراما شعبية واعية بذاتها، تنتمي إلى الناس وتعبّر عنهم من الداخل.
- تغيير اسم الشيخ “موسى” إلى “هارون” في الفيلم قد يكون محاولة واعية لتجنب إثارة الجدل الديني (الشيخ موسى شخصية حقيقية تُزار مقبرتها في الكرنك، ولد في العام 1908 في قرية الزينية بحري \ الأقصر وانتقل سنة 1950 إلى الكرنك واستقر فيها بحجرته الموجودة بجوار مقامه المدفون فيه. يعتقد مريدو الشيخ موسى أنها ذات الحجرة المذكورة في الرواية حين كانت حزينة تتجادل فيها مع زوجها حول ما إذا كان يوسف سليم جامع نذور الشيخ موسى رجلاً طيباً أم لا، إذ لام بخيت نفسه قائلاً: “يوسف سليم رجل طيب. كان يعمل بالتجارة، وكانت دكانته حجرة من حجرات بيته، تطل على الشارع… ولما اختار الشيخ تلك الحجرة لتكون خلوته التي يعبد فيها الواحد الأحد كف يوسف سليم عن الجزارة وأصبح نقيب الشيخ في جمع النذور”. ويقول يحيى على لسان بخيت “والشيخ يغلق باب حجرته عليه بالنهار، ويظن الجاهل أنه بداخلها بينما الرجل الصالح يجوس هناك بمكة المكرمة حيث قبر الرسول”.
ويقع ضريح الشيخ موسى في الشارع الذي يحمل اسمه أيضاً وهو عبارة عن بيت صغير له بوابتان؛ الأولى مدخل للمكان، والثانية تنفتح على المقام مباشرة. وللضريح واجهة رخامية كتب عليها اسم صاحب المقام وهو العارف بالله موسى أبو علي وتاريخ وفاته “22 رمضان 1408 ه. 8 مايو سنة 1988”. أي أن الشيخ موسى مات بعد يحيى بست سنوات. ويذكر يحيى في الرواية: “في إحدى ليالي الذكر، تجمع الرجال كعادتهم منتظرين خروج الشيخ لكنه لم يخرج، ومر الليل بطيئاً ثقيلاً، حتى ارتفع القول وتضارب: “نكسر الباب”…”من يجرؤ كشف الستر عقابه شديد”…”سمعته بالأمس ينادي الله حبيبه: خذني، نادى الله ثلاث مرات بصوت مرتفع”…”في الأيام الأخيرة كان دائم الحديث عن الرحيل وعن الموت مفرق الأحبة والجماعات”. ولما تأكد أحبابه من موته، بكوه، ” كما بكته السماء قبل رحيله بيوم”.
وكما يردد يحي في الرواية بعض كرامات الشيخ موسى سواء في حياته (ما تقول عنه فهيمة بأن الشيخ موسى ” كله خير وبركة… وهو في سني خلع ثوبه ورماه في الماء فطفا الثوب، وقعد عليه الشيخ، وعبر النهر من الشرق للغرب، وعاد للشرق، ولبس ثوبه الذي لم يبتل”. أما في الفيلم فيرد بخيت البشاري على كلام ابنته بالقول “طيب ياختي يلا انقليني أصلي اتبليت في قعدتي من غير ما عدي لا بر ولا بحر”.) أو تلك الكرامات التي رافقت موته والتي كان يرددها الناس مثل “الخشبة طارت طيراناً… و التي سبحت في الجو كغمامة مسرعة”.
10.لم يرد في الرواية أي ذكر للطاحونة. فيرى البعض في هذا التغيير أو الإضافة تطويراً لرؤية نقدية بصرية، وليس تعبيراً عن خيانة للنص. تتحول الطاحونة في الفيلم من غياب سردي تام في الرواية إلى محور سردي بصري في الفيلم يدفع بحبكته نحو الذروة ويثقلها بالمعنى السياسي. وقد يكون هذا التحول ناتجاً عن صعوبة ترجمة لغة يحيى الطاهر عبد الله الشعرية إلى صورة مباشرة، فاستعاض الفيلم عن ذلك بالرمز البصري المكثف، كما في مشهد الطيور البيضاء في افتتاحية الفيلم، الذي يمكن قراءته كرمز للبراءة المذبوحة.
وهكذا تتحول الطاحونة في الفيلم إلى جزئية رئيسة تدور حولها العديد من الأحداث، وتصبح استعارة للحداثة المعطلة، بما يعكس رهان بشارة على السينما كأداة سياسية، حيث ينظر إلى التخلف بوصفه نتاجاً لسياسات اقتصادية فاشلة ترسخ الاستلاب (إحلال الآلة محل الإنسان دون بنية تحتية ثقافية)، وليس بوصفه سمة محلية، بل كنتاج، فالطاحونة، كآلة، تتحول إلى قوة مهددة.
هذا التصور يجعل من الطاحونة- التي تقع فعلاً عند مدخل الكرنك، وهي أول ما يصادفه المرء القادم إلى القرية عبر “طريق الكباش”- رمزاً لحداثة غريبة عن السياق الشعبي، وحداثة مشوهة لا تخلق تقدماً، بل قلقاً وجودياً
صحيح أن الرواية الاصلية تخلو من ذكر الطاحونة، لكن يحي الطاهر عبدالله تناولها في مجموعته القصصية “ثلاث شجرات كبيرة تثمر برتقالاً”، والتي تحتوي حكاية بعنوان “طاحونة الشيخ موسى”، على اسم الشيخ الذي يتبارك به أهل الكرنك. فيستمدّ الفيلم عناصره الروائية من هذين العملين لصياغة نص سينمائي متكامل. هذا الدمج خلق حبكة غنية بالتفاصيل الدرامية، فجعل الفيلم أكثر تشابكاً وتنوعاً مما في الرواية الأصلية. ولكن هذه الفجوة بين النص الأدبي والفيلم تفتح باباً لتساؤلات حول “الوفاء” للنص الأصلي. حيث تبرز الطاحونة كأداة تغيير قسري يفرضها تاجر يُدعى “الخواجة يسّي”، كان المحتكر الوحيد لتمويل أهل القرية بالسلع التموينية، والذي ورثه ابنه “نظير”. وهذا الأخير قرر بناء طاحونة لتسهيل طحن الغلال على نساء القرية، اختصاراً لمشقة الذهاب إلى البندر، عملاً بنصيحة أبيه (فكر تكسب وفتح عينك تغرق في بحور الدهب).
ولأن الفلاحين بطبعهم لا يميلون إلى التخلي بسهولة عن الأفكار العزيزة على قلوبهم ولا يرحبون بالتغير فلم يرتاحوا لفكرة الطاحونة، فاهتاجوا وذعروا من فكرة وجودها. ولا يعرف من أدخل في روعهم أنها تحتاج إلى “عيّل” صغير يلقى بداخلها كي تعمل وما صوتها : توت توت” إلا عبارة عن صراخ العيال، وليس أزيز الحديد والسيور.
ولو أصر الفلاحون على موقفهم هذا سيعني للخواجة “نظير” انهيار مشروعه من جذوره، ومهما حاول إقناع الأهالي بعدم صحة ما يتردد عن الطاحونة فقد كان كلماته “تصطدم بالحائط الأخرس ويتردد صداها رجفة بقلوب آباء يعبدون الأبناء وأمهات يفضلن تعب المشوار وشقاء العمر ولا المصيبة في الولد”. فما كان منه إلا اللجوء إلى “مصدر القوة السياسية في البلدة”. فمضى نحو العمدة يطلب منه مساعدته وحمايته، غير أن هذا الأخير كان يشارك الأهالي في معتقداتهم ورفض مساعدة الخواجة، واعتبره نذير شؤم على البلد بأسرها.
فحاول أن يحتال عليهم بقوله إنه يؤيد قولهم إن صوت الطاحونة يحاكي صوت الطفل لكنه في الحقيقة ليس كذلك بل أن سبب الصوت يعود لأن الطاحونة قديمة نسبياً لذلك “ما يلزمهاش عيّل”، فرد عليه أحد الأهالي مستهزئاً “لازم عطلت وعايزة عيّل تاني… ماحناش هبل يا خواجة”. وعلق آخر “الشيخ موسى بيقول احرصوا على أولادكم من طاحون الخواجة”.
وهنا انتبه الخواجة نظير… يا الله كيف لم يخطر بباله الشيخ موسى، وما الداعي للذهاب إلى العمدة إن كان رب القرية الذي يطيعه الجميع موجوداً وجاهزاً للخدمة. فتعالى صوت الخواجة صارخاً “رضينا بالشيخ يا جماعة… أنا وانتوا والعمدة نروح له… يا ناس دا كله بركة… قدمه تدخل الطاحونة ونعمة ربنا تحل فيها وتشتغل… المكنة مايلزمهاش عيّل لو دخلها الشيخ… مدد يا كبير… كراماتك يا شيخ موسى”…
ولما وصلوا عند الشيخ وأخبروه بما اتفقوا، أحس بحجم الورطة التي سيقع فيها، فلو رفض ستنهار أسطورته ومكانته ويخسر ثقة الناس في كراماته، فلم يكن أمامه سوى الرضوخ والذهاب معهم، وطوال الوقت كانت “الصيحات تستعطفه في إرغام… وساقاه مدفوعتان إلى المصير في زحف أسود مقيت كريه، ولا فكاك من النهاية ولا سبيل إلى الخلف: الجبل البشري خلفه، والبحر الأسطوري أمامه”. وما إن دخل الشيخ موسى إلى الطاحونة قام الخواجة بتشغيلها فدارت دون أن يرمى بداخلها “عيّل” فعلت صيحات الرجال بالتكبير والنساء بالزغاريد، وقام الخواجة من فوره بتعليق لافتة كبيرة على مدخل الطاحونة كتب عليها “طاحونة الشيخ موسى، لصاحبها الخواجة نظير وابنه مفيد”.
استفاد خيري بشارة من هذه القصة ليوظفها ببراعة مع بعض التغييرات التي تخدم سردية الفيلم، فاستغنى عن الخواجة “نظير” وجعل من صاحب الطاحونة “منصور الصادق” صاحب محل البقالة في القرية. ومازال سكان الكرنك يعتقدون أن سبب موت يحيى المبكر إنما يعود لأنه تناول سيرة القرية وكشف أسرارها و “فضح” ناسها، خاصة سيرة الشيخ موسى، الذي ظهر في الفيلم باسم الشيخ هارون، إذ “يرون إنه تطاول على ولي، ولأن أولياء الله لا خوف عليهم، فقد عاقب الله يحيى بالحادث الذي أودى بحياته”.
ورغم براعة بشارة في المزج بين الرموز، فإن استخدام الطاحونة كعنصر محوري خلق نوعاً من التشويش في بنية الفيلم. فمن قرأ الرواية سيلحظ أن مركزية “الطوق والإسورة” قد تراجعت، وتداخلت مع عناصر دخيلة، مما أربك الإيقاع السردي وفتح مساراً آخر موازياً، بل منافساً.
11.تأتي صرخة مصطفى البشاري هذه خارج السياق الدرامي للشخصية، بل تكشف عن تناقض واضح بين البناء التمثيلي وبين الخلفية النفسية والاجتماعية المفترضة له. فمصطفى، كما تصفه الفقرة بدقة، ليس “فتوة” بل شخصية مثقلة بالفشل، منهزمة، تفتقر إلى العمق الداخلي الذي يؤهلها لفرض حضور سلطوي على الآخرين. فقد عاد من غربته مهزوماً ومليئاً بالعقد والنكسات “طلاقه لزوجته، وفقره، وعدم إنجابه ولد يحمل اسمه، وقصص بطولاته الفارغة التي هي أقرب لأعمال اللصوصية” منه إلى الشخصية الكاريزمية، وبالتالي، فمجرد تصويره في لحظة انفجار أو سيطرة يتناقض مع منطق الشخصية، ويكشف عن خلل في توجيه الأداء أو حتى في كتابة الدور.
وهذا الخلل يصبح أكثر وضوحاً عندما نضع في الاعتبار أن من يلعب الدور هو عزت العلايلي نفسه الذي يؤدي شخصية الأب أيضاً، مما يربك المتلقي ويزيد من التباس المعنى.
نقطة الأداء المزدوج (شيريهان/العلايلي في دور الأم/الابنة، والأب/الابن) تطرح بذكاء فكرة الاستمرارية والتكرار، أي أن الزمن لم يغير شيئاً، وأن القدر يعيد نفسه بلا انفكاك، وأن الشخصيات الجديدة ليست إلا إعادة إنتاج لنماذج سابقة، بنفس العجز، ونفس المأساة. لكن هذا المعنى، وإن بدا قوياً في بعده الرمزي، يتطلب ضبطًا شديدًا في الأداء ودرجة عالية من الدقة في الإخراج، وهو ما لم يتحقق هنا، بل على العكس، أدّى إلى تشويش لدى المشاهد.
المبالغة في تصوير “البراءة” لدى فرحانة كما وصفت –بطريقة ميلودرامية تصل حد الإعاقة– تشي بتبسيط ساذج للخير، كما لو أن الطهارة لا بد أن تكون ساذجة أو غير واعية، وهو ما يُضعف من حضور الشخصية ويجعلها أقرب إلى الرمز المسطح منه إلى الكائن الحي. وهذا الانزلاق نحو الميلودراما يبدو وكأنه تنازل جمالي من بشارة، يخضع فيه لمنطق النجومية والشباك والتقاليد الراسخة في السينما التجارية، بدل المضي في بناء عالم سينمائي مستقل قادر على مساءلة هذه التقاليد.
التناقض هنا لا يكمن في شخصية مصطفى أو فرحانة فحسب، بل في قرار إخراجي جوهري؛ إذ يتضح أن الرغبة في تكثيف الرموز (الوراثة، التكرار، الجبرية الاجتماعية) جاءت على حساب التماسك السردي وصدق الأداء. فالفيلم حين اختار أن يُسند الأدوار المزدوجة لنفس الممثلين، لم يضع في الاعتبار أن الجمهور – حتى وإن التقط الدلالة الرمزية – سيشعر بانفصام في الانفعالات، خاصة إذا جاء الأداء مفارقاً تماماً لملامح الشخصية النفسية والاجتماعيةـ ويمس جوهر التوتر بين الشكل والمحتوى، بين الأداء التمثيلي بوصفه أداة تعبير، وبين المعنى الذي يُراد تمريره في الفيلم، سواء عبر سرديته أو رموزه البصرية.
- يشكل مفهوم “العجز” جوهر الرؤية التأويلية للفيلم، حيث يتداخل في معناه مع نقيضه “الإخصاب”. فينقل هذا التأويل فكرة الخصوبة من معناها البيولوجي المباشر إلى معناها الرمزي والفلسفي، بوصفها القدرة على الفعل، وعلى التغيير، وعلى إعادة إنتاج الحياة، وليس الإنجاب وحده. ويتخذ من “العجز” نقيضاً جوهرياً للخصوبة، لا بمعناه الجسدي فقط، بل كعلامة على التوقف، على السكون، على الاستسلام للتكرار والجمود.
إن تأطير الفيلم في هذا السياق يجعل من كل شخصية فيه تجسيداً لوضع من أوضاع الخصوبة/العجز، لذلك تكثر الدلالات التي تعبر عن حالة العجز وعدم القدرة على الإخصاب، فبخيت البشاري هو البداية، وهو أصل العجز، الأب الذي تنقض عليه السلطة، فينكسر، ويُسحق، ويصبح حضوره مجرد ذكرى. والجبالي زوج فهيمة، الذي يبدو أكثر حيوية من بخيت، لكنه عاجز بدوره، يحتمي بالحكايات والكلام، لا بالفعل. وفهيمة تحاول، تقاوم، تُنجب، لكنها في النهاية تمارس الدور نفسه، تعيد التكرار: تتزوج، وتنتظر، وتعيد إنتاج المعاناة نفسها. ومصطفى، الذي هو التجسيد الفاقع لفكرة الخصوبة الزائفة؛ يطلق زوجته الشامية لأنها لم تنجب له ولداً، بينما هو، في العمق، عاجز عن الحب، عن الفهم، عن المبادرة. وحزينة العاجزة عن جعل ابنتها تحمل (إخصابها على يد حارس الكرنك كان حل ميكانيكي خارجي بعد فشل الحل الداخلي أي الجبالي في إخصابها) وعجزها أيضاً عن إنقاذ حفيدتها، وعجز المدرس عن التغيير.
وها هي فهيمة رغم إدراكها لعجز زوجها إلا أنها تحاول الاحتفاظ به قدر ما تستطيع فتظهر كأنها شهرزاد الحكايات القديمة تردد على مسامع “أميرها” الجبالي حكاية بائع الكلام الذي ينجو من الموت عند استخدامه بعض الكلمات، فالكلمة الأولى كانت “حبيبك اللي تحبه ولو كان عبد نوبي” والثانية “ساعة الحظ متتعوضش، و الثالثة “من آمنك لم تخونه ولو كنت خاين” وهي كما نرى ثلاث كلمات تلخص فعلاً علاقتها بزوجها وسلوكه معها ونهاية كل منهما.
والخيط الذي يربط هذه الشخصيات جميعها هو شعور الخسارة والعجز، والبحث عن بديل، الذي يأتي، أحيانًا، في صورة انتظار (رسائل مصطفى، أمل فهيمة في زوجها، تطلع حزينة إلى إنجاب ابنتها، إلخ). فالانتظار هنا ليس مجرد فعل سلبي، بل هو شكل من أشكال المراهنة على احتمال العودة إلى الخصوبة.
غير أن الفيلم، كما يبدو من هذه الزاوية، لا يمنح أياً من هذه الشخصيات الخلاص أو “الخصوبة الحقيقية” من داخل الواقع. فكل مشروع داخلي يبوء بالفشل: الجبالي يفشل في إنجاب طفل من حزينة، والسعدي يفشل في كسب حب فرحانة، ومصطفى يعجز عن تكوين أسرة.
وحتى حين يتحقق “الإخصاب”، كما في حالة حزينة، فإنه لا يتم إلا عبر تدخل خارجي (حارس المعبد)، ما يجعل “الحل” ميكانيكياً، هشاً، خالياً من البُعد العاطفي أو التحول الداخلي.
يقول خيري بشارة عن معنى الخصوبة في الفيلم: (…الخصوبة هي قلب الموضوع… نحن غير قادرين على الإخصاب… لست معنياً أساساً بالعادات والتقاليد بقدر ما أنا معني بالتركيبة العقلية أو الذهنية… أنا معني بالخصوبة وعلاقة ذلك بالفاعلية والقدرة على التغيير. فالفيلم يتحدث عن فقدان الخصوبة الإنسانية…).
فيمثل عجز الأب دافعا قوياً ومبرراً منطقياً للأم وابنتها في النظر إلى الغائب كمنقذ فتتطلعان إلى رسائله بفارغ الصبر ويتم استدعاؤه ذهنياً في كل لحظة وعند كل أزمة تعيشانها. فهؤلاء الثلاثة تغلف حياتهم ثلاثة مسارات تتأرجح بين الثبات والعجز والخصوبة، و يكون الانتظار إحدى دلائل الثبات، والفقر والمرض يشيران إلى العجز وزواج فهيمة هو التعيير المباشر عن مشروع الخصوبة ” قلب الموضوع في الفيلم” لإعادة إنتاج الحياة نفسها.
للمزيد عن الفيلم؛ فيما يلي رابط مقال صفاء الليثي بعنوان “بين خليفي و بشارة نقد المجتمعات العربية والمزج بين الوثائقي والروائي”
- تحفل الرواية ببنية رمزية عميقة، حيث يتم تجاوز الحكاية الواقعية المباشرة إلى مستويات من التأويل الثقافي والاجتماعي والسياسي. ويصيف إليها الفيلم أحد أهم رموزه أي الطاحونة. مما يعيد تشكيل الواقع بطريقة تجعل من الممكن فهم البنية اللاواعية للمجتمع الذي يدور حولها، مجتمع مُقيد، مأزوم، يُنتج الأساطير ليُبرر عجزه.
فـ “الطوق” رمز إلى القيود الاجتماعيّة الخانقة التي تُحاصر الفرد، خاصّة المرأة، كتقييد حريّتها بالعادات المتوارثة (مثل زواج الأطفال، ثقافة “الشرف”)، ويجسد في الفيلم قيود “مصطفى” نفسه، الذي يعود إلى القرية ليكتشف أنه ما زال أسير التقاليد رغم اغترابه، فمازالت القرية تعيش في حلقة مفرغة من الفقر والجهل تغلف المجتمع كسلسلة لا تنتهي من المعاناة.
أما “الإسورة” فهي أيضاً حلقة وهمية يُبرر بها المجتمع تخلفه (خرافة الطاحونة التي لا تعمل إلا بدماء الأطفال).وكيف تُحوّل المجتمعات المهمّشة معاناتها إلى رموز أسطورية لتبرير واقعها بمزيج من الخوف والصمت (التواطىء؟) مما ينعكس عجزاً مستداماً في تقديم تفسير صحي لرعب المجتمع. وكما أشرنا تركز “الطاحونة” إلى الحداثة المعطلة والمهددة. وهي أكثر الرموز التباساً وتعقيداً، حيث يتم تصويرها كقوة غريبة تستنزف الأطفال وتُقدّم كحلقة مغلقة من الخوف والرعب، تمنع المجتمع من نجاوزها والتقدم للأمام.
وفي حين تركز الرواية على الثنائيات التقليدية مثل الذكر/ الأنثى، الحياة/ الموت، القرية/ المدينة، فإن الفيلم يخلق صراعاً جديداً بين القديم والجديد، فالحداثة المزيفة لا تُنتج سوى الخوف والقلق. فتنتصب الطاحونة في الفيلم كشخصية رئيسة تحرك المصائر -مثل إله حداثي لا يشبع من القرابين، الطاحونة في الحقيقة، ليس مجرد عنصر تقني (آلة) بل جزءً من البناء الدرامي الرمزي.
ولكن المشكلة ليست في الحداثة بوصفها مفهوماً، بل في حداثة بلا مشروع إنساني، بلا تحرّر حقيقي من البنى التقليدية، بلا وعي جمعي، حداثة تضع التكنولوجيا في قلب القرية دون أن تمس البنية العقلية التي ما زالت تضحّي بالأطفال.
 Aljarmaq center Aljarmaq center
Aljarmaq center Aljarmaq center